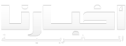رهينة الماضي و الحاضر

عبد القادر رجاء قد يتذكر المغاربة جميعا، كما نتذكر ثدي الأم الذي كنا ننسج عليه حروف سمفونية جميلة بدمعات صامتة، ﺫلك المسلسل المكسيكي الذي كان يقام له و يقعد و كانت المنازل المغربية تعرف حالة من الاستنفار ونوعا من حظر التجول عندما تبدأ موسيقى جينيريكه معلنة بداية حلقة من حلقاته. سمي المسلسل “ رهينة الماضي” و لكن كانت الغالبية تفضل تسميته “ڭوادالوبي” لكون الاسم يعود لبطلته التي جعلت مشاهديها رهائن لديها كل يوم ابتداء من الساعة السابعة و النصف إلى الثامنة و النصف من الليل، و كان مشاهدو هذا الإنتاج المكسيكي الأصل يودون البقاء رهائن لدى ڭوادالوبي طويلا؛ فقد كانت و جوهم تعبس و تتغير ملامحها عند مغادرة السيدة “ڭوادالوبي” شاشتهم كل ليلة. يبقى مسلسل ڭوادالوبي ظاهرة تلفزية لكون تأثيره كان كبيرا٬ و داع صيته بين الجميع و أصبح حديث الفتيات الطامعات في أمير لن يأتي٬ و النساء المشتكيات من شح كلمات زوج لا يعبر عن حبه على الطريقة المكسيكية؛ و بالعودة لتجليات الظاهرة يمكن إجمالها فيما يلي: - أصبح مسلسل ڭوادالوبي على رأس قائمة مواضيع اليومي خصوصا في البادية التي كانت تعرف طقوسا مميزة في انتظار حلقة الليلة كتعبئة البطارية و ربطها بالجهاز الموضوع على صندوق الخضر الفارغ و تحضير العشاء قبل حلول ڭوادالوبي ضيفة على أهل الدار٬ و كذا إنهاء جميع الواجبات المنزلية للتفرغ لاستضافة السيدة المنتظرة. - استغل الحب الساذج للمسلسل من أجل الاستثمار في مجالات كالغناء و بيع الملابس؛ حيت عرف زمان المسلسل تأليف أغاني شعبية و بيعها في شكل شرائط٬ كما كان ارتداء قميص يحمل صورة لبطلي المنتوج التلفزي أو لأحدهما دليل عنفوان و تعلق فاق الشديد به. و بهذا استطاع المسلسل أن يحقق للبعض استثمارا إيجابيا٬ وسميت شاحنات باسم بطلي المسلسل٬ و رهن الجميع في نهاية المطاف. - بعد الحب الذي منحه المغاربة لڭوادالوبي في سخاء أسطوري و كأنها رضعت من نفس الثدي الذي رضعوا منه٬ جاءت إلى المغرب و قدمت جوائز في احتفالات أسبوع الفرس بالرباط و هبت رهائن ڭوادالوبي للقياها و التمعن في قسمات وجهها، و كأن الذين دعوا الممثلة المكسيكية عرفوا جيدا من أي “بزولة يدوخ ” مشاهدو تلفزاتنا. غادرت ڭوادالوبي شاشات المغاربة فتحسر البعض على رحيلها٬ و بحث عنها آخرون في قائمة القنوات الفضائية بعد انتشار الدش على نطاق واسع. و ما زلت أحفظ في ذاكرتي صورة نساء بلدتي الصغيرة وهن خارجات يزغردن عند نهاية المسلسل و كأنهن يودعنها لآخر مرة، و بقي “رهينة الماضي”٬ الذي كنا نتمنى أن تقام لأجله دراسات لمزيد من الكشف عن علاقة المغاربة بڭوادالوبي٬ ظاهرة تلفزية بامتياز. حلت أسماء جديدة ضيفة على الشاشة المغربية كسمنطا و يحيى و مهند٬ لكنها لم تتمكن من أن تصل“ بريستيج” ڭوادالوبي٬ أما اليوم فمعضلة الأفلام المدبلجة بالدارجة تفرض ذاتها بحدة و تعد موضوع نقاش واسع نظرا لحساسيته. بعد أن كان الراحل إبراهيم السايح يترجم أفلاما هندية ك “دوستي” بالدارجة المغربية٬ أصبحت اليوم الانتاجات المدبلجة بالدارجة حاضرة بقوة إن على مستوى العرض التلفزي أو على مستوى نسب المشاهدة٬ و في الوقت الذي يزعم البعض من داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة أن الانتاجات المدبلجة تسعى إلى تقريب المتلقي٬ ترى أسماء من عالم الفن أن المسلسلات المدبلجة بالدارجة لا تعدو أن تكون مجرد “ تخربيق” و فوضى تهدف إلى تعميق أزمة الهوية لدى المغاربة. إن المعضلة لا تكمن في دبلجة إنتاج ما٬ لكن السؤال الذي يطرح ذاته هو أي إنتاج أدبلج؟ فهذه الانتاجات في أصلها عبارة عن أعمال أنتجت في واقع له ثقافته و قيمه و رؤيته الخاصة للأشياء و الكون٬ و بدبلجتها فإننا نعرض لمتلق انتاجات غريبة عن ثقافته بلغة يتكلمها و يفهمها الجميع و تشكل جانبا مهما من هويته٬ و لعل هذا كان السبب و راء دبلجتها لأنها إن عرضت بلغتها الأصلية و حتى إن دبلجت باللغة العربية لن تلقى نفس الوقع على المشاهدين٬ علاوة على أن المفاهيم التي تروج لها الانتاجات تسعى إلى خلق نوع من الاختلال القيمي داخل الأسرة المغربية. لن نكون حضاريين إن حكمنا بفكرة الانعزال الثقافي عن انتاجات مختلفة عن ثقافتنا٬ لكن هذه العملية يجب أن تكون في إطار من احترام المتلقي و بعيدا عن كل اعتبارات نفعية. وختاما فالإعلام الجاد هو الذي يدفع متتبعيه إلى التأمل و التساؤل٬ لا الذي يختزله في تلك الرهينة أو ﺫلك المتلقي الساذج.