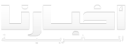كيف وصل الإسلاميون إلى الحكومة في المغرب
علي أنوزلا
لفهم ما جرى في المغرب يجب في نظري الانطلاق من ثلاث ملاحظات أساسية:
الملاحظة الأولى، هي أن المغرب لم يشهد ثورة، وإنما عرف حراكا سياسيا غير مسبوق في تاريخه الحديث، نجحت السلطة في ان تحتويه بأقل الأضرار وبتكلفة اقل من تلك التي دفعتها أنظمة وشعوب عربية قامت بثورات من أجل تغيير أنظمتها.
الملاحظة الثانية، هي أن الإسلاميين لم يصلوا إلى الحكم في المغرب وإنما وصلوا إلى الحكومة، وهنا يكمن الفرق الكبير بين الحكم أي صناعة القرار الذي كان ومازال بيد الملك، وبين تدبير الشأن العام الذي كان ومازال موكولا للحكومة.
الملاحظة الثالثة، وهي أن المخاض في المغرب ما زال لم ينتهي، وأن ما تم حتى الآن هو الشوط الأول من عملية التدخل السريع لإخماد الحريق قبل أن يشتعل لتبدأ عمليات إعادة ترتيب الوضع واختبار أساليب وقاية ناجعة. والبحث عن وسائل إنذار مبكر تفاديا لترددات موجات التسونامي العربي الذي ما زال ناشطا حتى اليوم.
وكمدخل لشرح ما حصل في المغرب سأنطلق من مسألتين أساسيتين، في تصوري، لتحليل ما جرى.
المسألة الأولى، وهي أن النظام في المغرب الذي كان سلوكه غير ديمقراطي حتى لا أقول معاديا للديمقراطية في الكثير من الأحيان والمواقف، ليس هو من اختار أن يتحول فجأة ليكون ديمقراطيا أو ما يشبه ذلك، لذلك تبقى الكثير من الشكوك تحوم حول وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
المسألة الثانية، وهي أن فوز الإسلاميين ممثلا في حزب "العدالة والتنمية"، وقبول الحكم أي القصر فتح الباب لهم للمشاركة في الحكومة، يطرح مسألة الثقة التي كانت شبه مفقودة بين الطرفين، وهنا أفتح قوسين لأتحدث عن قصاصة سبق لموقع ويكيليكس أن نسب فيها للملك محمد السادس أثناء استقباله لسيناتور أمريكي عام 2005 تحذيره له من الإفراط في الثقة في الإسلاميين. فمسألة الثقة التي كانت مفقودة بين الطرفين، هي اليوم محك اختبار شديد الحساسية في مرحلة "التعايش" الحالية بين القصر والحكومة نصف الملتحية، أي بين الملك والاسلاميين.
وهنا أستسمحكم لأشرح لماذا لم كانت الثقة شبه مفقودة بين الطرفين، وكيف تطورت مسألة بناء الثقة.
فمسألة الثقة كانت دائما مطروحة بين القصر ومن يسمح لهم بمشاركته جزء من الحكم. وبالنسبة للإسلاميين فالمغرب لم يكن يشكل استثناء، على اعتبار أنهم كانوا يشكلون أكبر قوة بمقدروها أن تنافس النظام في مجال شرعيتيه الأساسيتين، الدينية والشعبية. وعندما قرر النظام أن يفتح لهم الباب للمشاركة في اللعبة السياسية، لم يحدث ذلك في عهد الملك الحالي، وإنما حدث في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني، عندما قرر عام 1997 ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر السماح للإسلاميين بالمشاركة في حزب سياسي لخوض الانتخابات التي شهدها ذلك العام. حدث ذلك في سياق تاريخي دقيق، فالملك الراحل كان يعد لانتقال الملك إلى وريثه، وكان يعمل على ترتيب ظروف انتقال سلس ومرن للسلطة بعد وفاته، ففتح الباب للإسلاميين للمشاركة في اللعبة السياسية ، وأشرك المعارضة اليسارية السابقة في الحكومة، وأطلق إشارات أخرى من قبيل اصدار عفو عام وتعويض ضحايا سنوات الرصاص، وتعديل دستوري طفيف، وفسح المجال لظهور بوادر صحافة مستقلة حقيقية...حدث كل ذلك في سياق الإعداد لما سمي بـ "العهد الجديد" أي عهد محمد السادس.
فماذا حدث بعد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم؟
طبعا، عاش المغرب مرحلة انفتاح، وهناك من يصفها بأنها كانت مرحلة استراحة ضرورية، سمح فيها للشعب بالتعبير عن انتظاراته بحرية لم تكن معهودة في السابق، وأطلق الملك نفسه "إشارات قوية" في سياق وضع أسس لشرعية حكمه وتوطيد مشروعيته.
استمرت هذه المرحلة قرابة سنتين لتبدأ مرحلة إعادة الضبط والتحكم من جديد في الحياة السياسية من قبل القصر. وكان الإسلاميون في هذه المرحلة في عين العاصفة بوصفهم الخطر المحذق القادم. وهناك من المحللين من يذهب إلى القول بأنه لو لم يسبق للملك الراحل أن فتح الباب لإسلاميي "العدالة والتنمية" للمشاركة في الحياة السياسية نهاية التسعينات لما فتح لهم الباب أصلا. ويستدلون في ذلك بالتضييق الذي عاشه هذا الحزب حديث النشأة طيلة فترة وجوده على الساحة السياسية، وأيضا بالحصار الذي تمت ممارسته على حزبين إسلاميين هما "البديل الحضاري" و"حزب الأمة"، فقد تم الزج بزعيميهما في السجن عام 2007 في قضية ارهاب مفبركة، ومنعا من النشاط القانوني حتى يومنا هذا. أما الصراع مع جماعة "العدل والاحسان" فلم يتوقف حتى يوم الناس هذا...
ولفهم ما جرى حتى غيرت السلطة في المغرب رأيها وسمحت للإسلاميين لأول مرة بمشاركتها الحكم تجب العودة إلى الوراء قليلا عندما كان جناح داخل السلطة يعتبر أن المد الإسلامي المتنامي يشكل أكبر خطر في المستقبل على النظام، وجاءت أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية لتزكي نظرية هذا الجناح المتشدد. ففي أول انتخابات شهدها المغرب عام 2002 في العهد الذي سمي "عهدا جديدا"، طلب من حزب "العدالة والتنمية" بتقليص مشاركته فيها. ومع ذلك فقد أعطت نتائج تلك الانتخابات مؤشرات واقعية على شعبية الحزب مما زكى نظرية التخويف منه، وجاءت أحداث 16 ماي الارهابية عام 2003 في الدار البيضاء، والتي اتهم إسلاميون بالتورط فيها، لتطلق الدولة العنان للجناح الاستئصالي داخلها لمهاجمة الإسلاميين مستعملا الأجهزة وذراعه القوية داخل الإعلام الرسمي وبعض وسائل الإعلام الخاصة...
وامام ضعف الأحزاب السياسية التي أنهكتها مشاركتها الباهتة في الحكومة، حيث كان وزرائها مجرد موظفين سامين، بدأ الجناح الاستئصالي يفكر في انشاء حزب سياسي لملإ الفراغ وللتصدي للمد الإسلامي القادم. وليس غريبا أن يوكل تأسيس هذا الحزب إلى وزير الداخلية، الذي يوصف بأنه مقرب من الملك، وهو من كان يقود الجناح الاستئصالي داخل الدولة. حدث ذلك بعد انتخابات 2007، وهي الانتخابات التي شهدت أدنى مستوى مشاركة شعبية في انتخابات يشهدها المغرب، ومنيت فيها الأحزاب اليسارية والمعارضة التقليدية بنكسة كبيرة، وتم تزوير بعض نتائج حزب "العدالة والتنمية" لتحجيم وجوده داخل المؤسسات السياسية.
بعد تلك الانتخابات بدأت معالم خارطة الطريق التي وضعها النظام تتضح : وهي بكل بساطة السير بالمغرب نحو "التونسة" على عهد الرئيس الهارب زين العابدين بنعلي، من خلال خلق حزب السلطة الحاكم، وإعادة ضبط الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية بغرض التحكم فيها وتسخيرها لخدمة أجندة النظام، واستئصال كل من يقف في وجه هذا المخطط الجهنمي...
كل شيء كان مخططا له بعناية كبيرة. فقد تم إخراج قضية قديمة من دهاليز المخابرات هي "قضية بليرج"، وتم الزج برموز إسلامية في السجن ومن بينهما عضو بـ "العدالة والتنمية"، بتهمة التورط في مخطط ارهابي. كانت تلك الإشارة الأولى للحزب الإسلامي الوحيد الذي يشتغل من داخل مؤسسات الدولة. وبعد ثلاث سنوات من إثارة هذه القضية، تم عام 2010 الزج بعضو قيادي آخر من نفس الحزب في السجن، وهذه المرة بتهمة الفساد. وكل ذلك في سياق الحرب على هذا الحزب التي كانت تعرف تصعيدا مع اقتراب استحقاقات 2012، لتشويه صورته أمام الرأي العام ولتخويف الناس من الانضمام إليه أو التصويت لمرشحيه.
لكن ما لم يكن في الحسبان هو اندلاع الثورة الشعبية في تونس التي حطمت النموذج الذي كان الاستئصاليين يبنون عليه، فأربكت الأوراق وافسدت الخطة إلى حين...
ومثل أغلب الدول العربية، ضربت موجات التسونامي التونسي المغرب، وشهدت البلاد التي كان البعض يتحدث عن "خصوصيتها" وعلى انها تشكل حالة "استثناء" داخل محيط عربي غير مستقر، حراكا شعبيا غير مسبوق لم تشهده البلاد من قبل. وتميز هذا الحراك بسلميته وأيضا بكونه شمل أكثر من مدينة وقرية مغربية، عندما كانت المسيرات والمظاهرات تخرج في أكثر من 50 نقطة كما حدث يوم 20 فبراير 2011، وفي لحظات أخرى تجاوز عدد النقط التي خرجت فيها المظاهرات الشعبية أكثر من 70 نقطة ممتدة على طول الخريطة المغربية. كان الشعار الأساسي الذي رفعه المتظاهرون مركزا في جملة واحدة "إسقاط الفساد والاستبداد". ولأول مرة في تاريخ الصراح السياسي في المغرب المعاصر، انقلبت موازين القوى عندما فرض الشارع نفسه كقوة تفاوضية أساسية قادرة على فرض شروطها. فكان على باقي القوى السياسية الأخرى والممثلة أساسا في الأحزاب، أن تختار صفها، وانقسمت الساحة السياسية إلى مؤيد ومعارض للحراك الشعبي وإلى اصحاب مواقف غير واضحة. وكانت عين السلطة مركز مرة أخرى على الإسلاميين على اعتبار أنهم القوة التي يمكن أن ترجح الكفة. وداخل صفوف الإسلاميين انقسموا إلى مؤيد بقوة للحراك الشعبي، ومثل هذا الموقف جماعة "العدل والاحسان"، وحزبا "البديل الحضاري" و"حزب الأمة". ودخل حزب "العدالة والتنمية" وقف زعيمه عبد الإله بنكيران معارضا لحراك الشارع، بينما اختار اعضاء آخرين من نفس الحزب وضع رجل في الشارع والحفاظ على رجل أخرى داخل مربع الحزب الذي اختار رسميا الإصطفاف ضد الحراك الشعبي. وبدأ التجييش من الجانبين، فقد لجأت السلطة إلى تحريك الزوايا الصوفية وأفرجت من رموز السلفية المعتقلين، وسمحت لأحد شيوخهم بالعودة من منفاه الاختياري، هو محمد عبد الرحمن المغراوي الذي أصدر بيانا عقب عودته إلى المغرب تحت عنوان يعبر عن اصطفافه إلى جانب السلطة يقول: "تنبيه الأخيار لما تحمله 20 فبراير من مخالفات واخطار".
لكن التركيز كله ظل منصبا على "العدالة والتنمية" الذي اتخذ أمينه العام موقفا معاديا للحراك الشعبي، ومع ذلك لم يشفع له وقوفه ضد هذا الحراك واصطفافه إلى جانب من كان يخطط بالأمس لاستئصال حزبه، في نيل رضى السلطة التي ظلت تعامله بحذر وتتعامل معه ببراغماتية.
وفي هذا السياق جاء خطاب الملك يوم 9 مارس والذي أعلن فيه عن إصلاحات دستورية، كانتصار لمطالب الحراك الشعبي، وفي نفس الوقت كعنوان للاختلال الذي وقع في موازين القوى في المغرب. ورغم أن حزب "العدالة والتنمية" لم يكن يطالب بإصلاحات دستورية، فقد سارع إلى تأييد المقترح الملكي، وذلك في طريق سعيه لكسب الثقة المفقودة بينه وبين السلطة. وهناك من يعتبر أن اختيار "العدالة والتنمية" الاصطفاف ضد الحراك الشعبي، خلال مرحلة الإعداد للدستور الجديد، ساهم إلى حدما في إفراغ إعلان خطاب 9 مارس من الكثير من مضامينه الديمقراطية. ونتج عن ذلك دستور مازال يحتفظ داخل متنه ببنية الاستبداد الذي خرج الناس للمطالبة بإسقاطه.
ومرة أخرى عادت السلطة إلى اساليبها القديمة في التضييف على الحزب الذي ظل يشكل الخطر القائم بالنسبة لها. فقد تم اقصاء المكون الإسلامي من المشاركة في اللجنة الملكية التي تم تكليفها بإعداد الدستور، وأقصي الحزب من التمثيل في عدة مجالس وهيئات رسمية مثل "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، و"الهيئة العليا للسمعي البصري". وتم خلق تحالف حزبي من ثمانية احزاب موالية للسلطة لمنافسته في الانتخابات التي كانت مرتقبة...
ومرة أخرى سيأتي الفرج من تونس. فقد غير الفوز البين لحزب "النهضة" الإسلامي في الانتخابات التونسية الكثير من المعطيات في المنطقة، وفرض وجود الإسلاميين ولأول مرة في السلطة كمعطى أساسي لايمكن تجاوزه. التقطت السلطة في المغرب الإشارة الآتية من تونس وبدأ الحديث داخل اجهزة الدولة عن وجود توجه بإشراك الإسلاميين في الحكومة المقبلة حتى لو لم يتصدروا نتائج الانتخابات لتفادي "السكتة القلبية" التي كانت وشيكة.
ثمة اكثر من قراءة لهذا التوجه المفاجئ في موقف السلطة من الإسلاميين الذين تحولوا بين ليلة وضحاها من فاعل لايمكن الثقة فيه إلى حليف ضروري للمشاركة في السلطة من أجل الحفاظ على السلطة نفسها.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة التي قد تشكك في مصداقية الفوز البين الذي منحته صناديق الاقتراع للإسلاميين، تطرح عدة تساؤلات حول التوقيت الحالي للسماح لمثل هذا الفوز للتعبير عن نفسه وبهذه القوة؟ فلو أديرت قواعد اللعبة الانتخابية بمثل الحياد الذي شهدته انتخابات 25 نوفمبر الأخيرة، لكان هذا الفوز قد تحقق في انتخابات 2002 أو في انتخابات عامي 2007 و2009. فمما لا شك فيه أن أحداث الربيع العربي التي تعيشها المنطقة، وتأثيرها في المناخ الدولي أسقطت نظرية الشك والريبة التي كانت تروج لها الأنظمة الاستبدادية عن إسلامييها لتخويف الغرب منهم. وتستعملها كفزاعة لتبرير سلطويتها واستبدادها وفسادها.
الآن وبعد سقوط فزاعة الاسلاميين، يجد الإسلاميون انفسهم في السلطة أمام اختبار جديد لاكتساب ثقة الشارع الذي تعاطف معهم كمعارضة مظلومة وعليهم أن يثبتوا له أنهم يستحقون ثقته كسلطة حاكمة عادلة. أما الاختبار في الحالة المغربية، فهو مزدوج وصعب في نفس الآن. إذ على إسلاميي "العدالة والتنمية" أن يبرهنوا للسلطة على أنهم شركاء نزيهين ومستقلين، وفي نفس الآن أن يرسلوا إلى الشارع رسائل تطمئنه على أنهم لن يستبدلوا ثقة ناخبيهم برضى السلطة وإغرائها.
---