أحلام موؤودة

هشام الدركاوي
أتذكر – وأغلب من تعلم في المدرسة العمومية قد عاش التجربة نفسها- ونحن في سنوات تعليمنا الأولى أن معلمينا كانوا يسألوننا عن طموحاتنا المستقبلية؛ في صيغة سؤال مكرور بسيط، لكنه أساسي لقياس حجم طموحات أبناء المقهورين وقياس درجات نباهتهم؛ خاصة في صيغة بلاغته العامية ذات القوة الإنجازية والتوجيه الخطابي "آشنو تبغي تولي من تكبر؟".
وكان كل متعلم ينتظر بشغف وترقب دوره في الإجابة عن السؤال، بل يتمنى لو يبادر بها كي لا يسرق أحد طموحه ويصادر أحلامه ومهنته المفضلة. وأتذكر أن إجاباتنا كانت تختزل
طموحاتنا الصغيرة صغر حجم عقولنا وعقول آبائنا الذين امتصتهم الهوامش، وبسيطة بساطة عيشنا الذي كنا نكتفي فيه بالنزر اليسير، ومحدودة نظرا لمحدودية رؤيتنا التي كانت محكومة بجغرافيا ضيقة اختزلنا من خلالها العالم في حينا وبعض الأحياء المجاورة لنا التي كنا ننوس فيها بأجسادنا الهزيلة لحظة اللعب أو التربص ببعض الدور قصد رشقها بالحجارة أو قرع أجراسها، وكذا بمحدودية النماذج والقدوات التي كنا نتطلع إليها في حبور؛ فالكل كان يتمنى أن يصير معلما أو شرطيا أو دركيا أو ممرضا...، وأحيانا كان منا من يتطلع ليصير مروجا للمخدرات ذا لقب مشهور يفرض سطوته على الحي ويكون مهاب الجانب؛ حتى تنسج عنه المخيلة الجمعية الشعبية القائمة على التواتر الجيلي صورة البطل الأسطوري الخارق الذي لا يقهر.
وطبيعي أن يكون أفقنا ضيقا؛ لأنا كنا نتطلع إلى معلمينا وهم يحتسون أكواب الشاي ويتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم بدهشة طفولية، فيخطفنا حلم اليقظة على حين غرة منا ونتخيل أنفسنا مكانهم؛ كي تتسنى لنا فرصة الاقتراب من تلك المعلمة الشابة المثيرة التي كانت محط أنظار الجميع، ولكي أفسد على زملائي في الفصل فرحة اللعب عندما أمر بالقرب منهم يوم عطلة أسبوعية وأتوعدهم بسبب إيثارهم اللعب على المطالعة.
وكنا كلما رأينا شرطيا ينظم عملية المرور إلا وانبهرنا بزيه النظامي؛ إلى درجة الاقتراب منه وإلقاء التحية عليه والتلويح له؛ بله اعتباره صديقا مفترضا نهدد زملاءنا وأقراننا الأقواء باللجوء إليه في حال استعراض عضلاتهم علينا أثناء اللعب. وأتذكر أننا كنا نلح على آبائنا المعوزين الذين أنهكهم اليومي، بأن يشتروا لنا في عيد الفطر بدلات نظامية سواء للدرك أو الشرطة كي نتباهى بها على أقراننا، وتخول لنا خوض تمثيلية تنظيم حركة المرور بحينا التي لا تنتهي إلا بتعبنا من الصفير المدوي أو بتلقي صفعة مفاجئة من صاحب دراجة كاد يدهسنا.
لكن عجيب أمر هذا الطموح؛ ذلك أنه كلما كبرنا وتقدم بنا العمر إلا وبدأنا في التخلي عن طموحاتنا وأحلامنا الطفولية البسيطة والضيقة، حيث أتذكر أننا في مرحلة تعليمنا الثانوي وبفعل انفتاحنا على تجارب إنسانية متنوعة وتحررنا من ضيق الانحياز الجغرافي المحدود بفعل نسج صداقات في أحياء أخرى بعيدة أو خوض تجربة السفر وحيدا لمدن كنا نسمع عنها في الإعلام فقط ؛ ليس بغاية المتعة بل بغاية البحث عن عمل في العطل الصيفية قصد توفير مصاريف الدراسة والكسوة التي لم تعد أسرنا قادرة على تحملها، هذا فضلا عن انعتاق رؤيانا وحلمنا من ضيق الواقع؛ بفعل العوالم اللامتناهية والمساحات التخييلية والحلمية الرحبة التي كنا نعانقها ونحن في انصهار تام مع روائع الأدب العالمي وكتب الفلسفة والأدب والشعر العربي القديم. في هذه اللحظة كذلك تخلى أساتذتنا عن طرح تلك الأسئلة الاستباقية والاستشرافية الرومانسية، واكتفوا بتقديم نصائح أكثر واقعية كنا نشف من خلالها سخطهم على واقعهم وحسرتهم على ما فات من الأيام والفرص. وأتذكر أن أستاذ مادة الفلسفة المثقف كان يردد على مسامعنا في كل حصة مقولة صارت كوجيطوه الخاص؛ نلمس عبره يأسه وحنقه؛ حيث كان يقول: "ما تفكروش حدا رجليكم وإلى طلبتوها طلبوها كبيرة"، مع تعزيز كلامه بقول المتنبي:
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
وكان جل أساتذتنا، أثناء حواراتنا الجانبية معهم التي تتخلل الدرس بغية تكسير رتابته، يرددون مقولة: صر ما شئت إلا أن تصير أستاذا؛ معددين على مسامعنا مثالب المهنة وإكراهاتها وحالة النكوص التي تعيشها ماديا واجتماعيا واعتباريا. والأمر ذاته يحصل مع ذلك الشرطي الذي نلتقيه في إحدى المقاهي أو في جلسات عائلية والذي ما يفتأ يسرد على مسامعنا مساوئ مهنته ليختم حديثه بعبارة "صر ما شئت إلا شرطيا"، وكذلك الدركي والمخزني والممرض وموظف البلدية والجماعة....
غير أنه سرعان ما أتاحت لنا هذه التجارب الحية المتذمرة من واقعها، والتجارب المتخيلة التي عشناها من خلال قراءاتنا الغزيرة والمتنوعة، وكذا تفوقنا الدراسي؛ فرصة التخلص من طموحاتنا الصغيرة التي رسمناها في طفولتنا، كما تقوضت تلك الصور والتمثيلات التي رسمناها لقدواتنا السابقة التي لم تعد كذلك، ولتلك المهن والوظائف البسيطة التي لا تكرس إلا للحاجة والمعاناة. ومن ثم سنبدأ في تشييد طموحات كبيرة وثقنا في تحققها وثابرنا على الظفر بها واجتهدنا وسهرنا الليالي الطوال وخضنا غمار التنافس فيما بيننا لنيل المراتب الأولى، حيث كلما أنهينا شوطا دراسيا بنجاح أو حصلنا شهادة إلا وخضنا غمار تحصيل شهادة أعلى منها، ضنا منا أن علو الشهادة في بلدنا يخول لنا علو المرتبة؛ الشيء الذي أفضى بنا إلى رسم صور عن مستقبل وردي رحب ينتظرنا مقارنة بما كنا نبذله من جهد في التحصيل؛ مستقبل قوامه المنصب السامي والمكتب والكرسي الوثير والمسكن الواسع والسيارة الفخمة والزوجة الجميلة والأبناء النجباء والوضعية الاعتبارية وكثرة الاسفار والبر بالوالدين.
لكن هيهات هيهات، فقد كان الواقع صادما وأقوى من إرادتنا، واكتشفنا أن طموحاتنا وأحلامنا كانت أهون من بيت العنكبوت، وأن تفانينا في المثابرة والتحصيل ليس سوى ملاحقة سراب في يباب، وأن تحصيل الشواهد مجرد وهم سوقوه لنا وعشنا عليه. في هذه اللحظة التي اكتفينا فيها من الغنيمة بالإياب سنعود أدراجنا إلى طموحاتنا الطفولية قسرا واضطرارا؛ لكن هذه المرة في غياب الصور المثالية والتمثيلات الحلمية الزائفة، وإنما في ارتباط بالواقع وبحياة المعاناة والاستسلام، بل منا من تقهقر ليكرس للمثل الشعبي "اتبع حرفة بوك لا يغلبوك"، ويتخلى عن حلمه الطفولي كذلك. وصار شعارنا في الحياة مخالفا لشعار أستاذ مادة الفلسفة؛ حيث صارت مقولات: "لا تبني حلما كبيرا في واقع قزم صغير" و"كن ما شئت في هذا البلد إلا مثقفا" و "إياك والاجتهاد كي لا تصدم" بمثابة كوجيتو خاص بنا، إلى جانب أمثلة شعبية كثيرة لا تكرس إلا للتبعية والجهل والتخلف ولا تشجع على الابتكار والخلق والتميز.
وربما سيأتي زمان يُجرم فيه الحلم وتصادر فيه الطموحات.
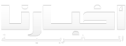















سفيان وضاف
ذكرتني بايام الطفولة
الاشكال هو الفرق الكبير بين ما كنا نفكر فيه وما وجدناه. فمنذ الصغر علمونا مبادئ لم نجد لها أثرا في واقعنا فالشرطي الذي رايته وهددت به اصدقاءك هو نفسه من اوقفك عنوة وتعنتا. لكي يسترشيك بطريقته.