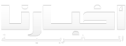في الفرق بين الولاء للمؤسسات والولاء للأشخاص أو للمصالح الشخصية

محمد إنفي
الولاء، مثل الوعي (حتى لا نقول مثل الإيمان)، يزيد وينقص؛ يستمر وينقطع؛ يتقلَّب ويستقر؛ يذبل وينتعش...؛ فيه الخالص والمزيف؛ فيه الكلي والجزئي؛ فيه العميق والسطحي؛ فيه الظاهر والخفي...وفيه الاختياري (أو الإرادي) والتابع أو المقلِّد (كما يحدث عند المتشبعين بعقلية القطيع).
ولكلمة الولاء معاني ومدلولات كثيرة؛ فالولاء في اللغة يعني، من بين ما يعنيه، القرب والنصرة والمحبة والالتزام والعهد والطاعة والإخلاص...
ويعتبر مفهوم الولاء من المفاهيم القديمة التي اهتم بها بعض علماء المسلمين، حيث ربطوه بالبراء وجعلوا منه شرطا من شروط الإيمان (الولاء والبراء عند ابن تيمية، مثلا)؛ أما علماء الاجتماع والسلوك، فقد تناولوا مفهوم الولاء من جوانب متعددة وبغير قليل من التفصيل والتدقيق والعمق. ومن بين أهم المفاهيم التي انصب عليها اهتمام هؤلاء، تحديدا وتعريفا وتدقيقا، مفهوم الولاء التنظيمي.
وحسب الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية، فإن مفهوم الولاء التنظيمي، هو امتداد للولاء الاجتماعي المتمثل في ولاء الفرد للمجتمع الذي ينتمي إليه ويعيش فيه. وقد لجأ الدارسون إلى هذا المفهوم عند تناولهم لأنماط السلوك في مواقع العمل ودراستهم لنوع العلاقات القائمة بين مكونات المؤسسة، سواء كانت هذه المؤسسة إنتاجية أو خدماتية أو إدارية...
وباختصار شديد، يمكن النظر إلى الولاء التنظيمي على أنه مجموعة من المشاعر الإيجابية التي يطورها الفرد تجاه زملائه وتجاه المؤسسة التي يعمل بها؛ وهو ما يُترجَم في أنماط سلوكية من قبيل التعاون والتضحية والتفاعل...وحين تسود هذه الأنماط السلوكية داخل المؤسسة، فهذا يعني تحقق الاندماج والتكامل بين مكوناتها؛ وهو ما يضمن لها ولاء هذه المكونات؛ مما يحسُّن الإنتاجية ويرفع من جودة الأداء(ولمن أراد أن يتوسع في مفهوم الولاء التنظيمي، أحيله على مقال بنفس العنوان لمحمد أحمد إسماعيل، المنشور في "المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية").
بالمقابل، حين لا يتحقق الاندماج والتكامل، ينخفض الولاء وتسود المشاعر السلبية التي تترجمها أنماط سلوكية من قبيل الجفاء والتباعد والفرقة... وهو ما يؤثر سلبا على المردودية، بحيث يقل الأداء وتنعدم فيه الجودة.
ويمكن أن نستعير مفهوم الولاء التنظيمي من مجاله الأصلي وإسقاطه على التجمعات البشرية التي تقوم على التنظيم مثل الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني من أجل مقاربة الأنماط السلوكية والعلائقية السائدة داخل هذه التنظيمات.
وحتى تكون المقاربة مفيدة، أقترح حصر الموضوع في المجال الحزبي. ومن أجل ضمان أكبر قدر من الموضوعية والصدقية لهذه المقاربة، يتعين الاعتماد على معطيات حقيقية ودقيقة والارتكاز على أمثلة مستمدة من التجربة ومن الواقع المعاش.
وفي اعتقادنا المتواضع، فإن كل حزب جدير بهذا الاسم، سواء كان يساريا أو يمينيا، يمكن أن يكون موضوعا لهذا التمرين قصد إبراز أنماط السلوك السائدة في صفوفه. لكن، ولاعتبارات ذاتية وموضوعية، سوف نقصر اهتمامنا على أنماط سلوكية عرفها ويعرفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع بعض الإشارات العابرة لغيره والتي قد يفرضها السياق.
يمكن، من خلال أنماط السلوك التي نلحظها داخل الحزب، أن نصنف الولاءات داخله إلى ثلاثة أنواع: الولاء للحزب، أي لمؤسساته ومبادئه؛ والولاء للقيادة في شخص فلان أو علان؛ والولاء للمصلحة الشخصية.
ولكل صنف من هذه الأصناف نمط سلوكي معين يترجم القناعة الحقيقية للشخص المعني. فالذي ولاؤه للحزب، لا يهمه، مثلا، من يكون في القيادة، وطنية كانت أو محلية. فبالرغم مما قد يكون له من مؤاخذات على هذا الشخص أو ذاك؛ وبالرغم مما قد يشعر به من ميول لهذا القيادي أو ذاك أو ما قد يكون له هو من طموح شخصي لاحتلال هذا الموقع أو ذاك، فإن ولاءه للحزب كمؤسسة يجعله يتعالى على ما هو ذاتي (سواء تعلق الأمر بالميول أو بالطموح) وينضبط للقرارات المؤسساتية، أرضته أم لم ترضه أنصفته أم لم تنصفه؛ وذلك لقناعته وإيمانه بأن مصلحة الحزب فوق كل اعتبار.
ولذلك، تجده، خلال الاستحقاقات التنظيمية أو الانتخابية، مثلا، يحترم ما تقرره الأغلبية أو المؤسسات المخوَّلة تنظيميا لاتخاذ القرار، بغض النظر عن رأيه الشخصي في طبيعة القرار أو في الجهة المستفيدة من هذا القرار. فمثلا، قد لا يرضيه، في الانتخابات، ترشيح فلان أو علان لتمثيل الحزب في هذه المؤسسة أو تلك (برلمان، جماعة، جهة). لكن ولاءه للحزب يجعله ينضبط ويلتزم بدعم ومساندة مرشح أو مرشحي الحزب، بغض النظر عن الشخص أو الأشخاص المرشحين.
لكن الأمر يختلف حين يكون الولاء لشخص (أو لأشخاص) أو للأطماع الشخصية؛ وهما متقاربان من حيث الدوافع والأهداف. فمن كان ولاؤه للشخص، فإن ولاءه للحزب يكاد أن يكون منعدما؛ فعلاقته بالحزب هي علاقة غير مباشرة وإن كان عضوا كامل العضوية ويتمتع بكل الحقوق التي تخولها هذه العضوية؛ بما في ذلك الترشح للمسؤوليات التنظيمية أو التمثيلية. وبمعنى آخر، فمن كان ولاءه لشخص معين، فإن مواقفه لا يستمدها من قناعته أو من مبادئ الحزب وأعرافه؛ بل، يستمدها من توجيه صاحبه.
ونعتقد أن هذا الصنف من الولاء يستحق أن يكون موضوع دراسة من قبل المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع، لما له من أهمية في فهم طبيعة العلاقات الإنسانية داخل التنظيمات السياسية وغيرها؛ خاصة وأن هذه العلاقات تكتسي نوعا من التعقيد والهشاشة في نفس الآن. فبقدر ما أن الولاء قد يصل عند البعض حد الطاعة العمياء والتبعية التامة، بقد ما أنه قد ينقلب عند البعض الآخر إلى عداوة مستحكمة، عندما تتعارض المصالح أو تختلف الآراء أو تتغير المواقع.
والأمثلة على انقلاب الأتباع والمريدين أو الأصدقاء المقربين كثيرة. وقد سبق لي أن تطرقت لبعض الحالات في حزبنا، إما تفصيلا وإما تلميحا.
وتجدر الإشارة إلى أن الولاء للأشخاص لا يثبت على حال. ويكفي المرء أن يلاحظ تغير العلاقات وتبدُّلها، بحيث قد يصبح من ألد الأعداء من كان بالأمس صديقا والعكس صحيح. فكم من شخص كان مثل ظل هذا القيادي أو ذاك، يأتمر بأوامره ويلهج بمدحه ثم أصبح بين عشية وضحاها من ألد أعدائه. ولنا في الاتحاد الاشتراكي أمثلة متعددة(كما هو الحال في التنظيمات الأخرى: انظر، مثلا، ما كتبه رشيد نيني في حلقتين، يومي 4 و5 شتنبر 2017، حول "البيجيدي" والاستقلال و"البام" في عموده اليومي بجريدة "الأخبار" بعنوان "الله ينصر من صبح").
لكني أعتقد أن المثال الأسطع، في تاريخ الاتحاد الاشتراكي، هو الانقلاب الذي تم على الأستاذ محمد اليازغي من قبل بعض ممن كانوا يُعتبرون قوته الضاربة في مواجهة معارضيه داخل الحزب، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى التنظيمات المحلية أو التنظيمات الموازية.
أما فيما يخص نموذج التبعية التامة (أو الخنوع التام)، فسوف لن نجد أحسن من سلوك أتباع سعيد اشباعتو. لقد نجح، يوم كان عضوا بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وكاتبا جهويا للحزب ورئيسا لجهة مكناس- تافلالت، أن يخلق لنفسه، على مستوى هذه الجهة، أتباعا "أوفياء" وأعداء "ألداء"؛ ذلك أنه كان، من جهة، يعتمد على الإغراء لضمان ولاء الأتباع؛ ومن جهة أخرى، كان يناصب العداء لمن لا يضمن ولاءهم تنظيميا وسياسيا.
ولذلك، لم يستغرب المناضلون أن يرافقه الأتباع الأوفياء (دون خجل ولا وجل ودون أية عقدة أو وخز الضمير) في ترحاله السياسي الجديد؛ ولم يجدوا في مغادرته سفينة الاتحاد الاشتراكي والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار، ما يدعو إلى الأسف أو الحسرة، لأنه لم يكن اتحاديا لا في تفكيره ولا في سلوكه.
و يحيلنا هذا النموذج على النوع الثالث من الولاء: الولاء للمصالح (والأصح للأطماع) الشخصية. وقد كان اشباعتو يشكل نموذجا صارخا لاستغلال الحزب لمصلحته الشخصية (والأمثلة على هذا الأمر موثقة في تقارير، كان يبعث بها بعض المناضلين والمسؤولين الإقليميين أو المحليين إلى المكتب السياسي الأسبق). فلم يكن يهمه من الحزب سوى احتلال المواقع التنظيمية والتمثيلية والاستفادة المادية والمعنوية من هذه المواقع؛ إذ لم يكن التحاقه بالحزب يشكل أية قيمة مضافة فيما يخص ترسيخ القيم الاتحادية وتجذير التنظيمات الحزبية؛ بل، بالعكس، كان يشكل عائقا حقيقيا أمام ترسيخ الثقافة التنظيمية والمؤسساتية، بسبب تشجيعه للزبونية وترويجه لثقافة "الهمزة".
ويا ما تعالت أصوات المناضلين ببعض مدن الأقاليم التابعة للجهة التي كان يرأسها تنظيميا وتمثيليا، وفي مقدمتها مدينة مكناس، لفضح ممارسات اشباعتو البعيدة كل البعد عن القيم النضالية الأصيلة والثقافة التنظيمية والمؤسساتية للاتحاد الاشتراكي (انظر مقالنا بعنوان " الفاعل السياسي بين القيم النضالية الأصيلة وقيم الانتهازية الهجينة: 'سعيد اشباعتو' نموذجا"، نشر بالحوار المتمدن بتاريخ 17 يوليوز 2015).
وقد زكى تطور الأحداث موقف المناضلين الرافضين لسلوك اشباعتو وأثبت صواب حكمهم عليه بالانتهازية والأنانية التي جعلته يعمل على تكريس عقلية القطيع وعقلية الشيخ والمريد داخل بعض التنظيمات الحزبية التي تمكن من تدجينها؛ ذلك أن ولاء اشباعتو لم يكن لا للحزب ولا للديمقراطية ولا للمؤسسات؛ بل كان فقط لمصالحه الشخصية. أما الحزب فلم يكن، بالنسبة إليه، سوى مطية لتحقيق تلك المصالح. ولما بدأت تتقلص استفادته من الريع الحزبي مع القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب وأيقن بقرب نهاية هذه الاستفادة، شد الرحال إلى وجهة أخرى.
وما اشباعتو إلا نموذجا من نماذج تفشي قيم الانتهازية والوصولية في الجسم الحزبي المغربي. وأخطر ما في الأمر، هو أن هذا السلوك قد أصبح متفشيا حتى داخل الأحزاب التقدمية؛ خاصة بعد أن أصبح العمل السياسي يتيح فرصا للترقي الاجتماعي، بعدما كان، بالنسبة لهذه الأحزاب، مصدرا للمتاعب، أقلها المضايقات من كل الأصناف وأعنفها التنكيل الذي قد يصل حد التصفية الجسدية.
وقد ساهم هذا التحول في ظهور نموذج جديد من "المناضلين" الذين لا ولاء لهم إلا لمصالحهم الشخصية. ويتصف أصحاب هذا النوع من الولاء بالاستعجال: إنهم يريدون الوصول بسرعة؛ ولذلك، تجدهم متلهفين ومتهافتين على المواقع من أجل تحقيق أطماعهم.
ويمكن تقسيم هؤلاء إلى صنفين: صنف "الكوادر" وصنف "المناضلين". فالكوادر، غالبا ما يغادرون في صمت إلى أحزاب أخرى بعد تيقنهم من صعوبة الوصول إلى مبتغاهم، متذرعين بحجة "طول الصف" داخل الاتحاد الاشتراكي. لا شك أن كلا منا يتذكر شخصا (أو أكثر) انتمى إلى هذا القطاع أو ذاك، كعضو عادي، أصبح، بعد رحيله إلى تنظيم آخر، قياديا وطنيا في هذا التنظيم؛ وربما ممثلا له في الحكومة أو البرلمان.
أما أصحاب الصنف الآخر، فيتدثرون في ثوب النضال ويأتون باسمه أفعلا لا علاقة لها بالقيم النضالية وبالأخلاق السياسية. فكل شيء عندهم مباح، من ركوب موجة المزايدات وتحويل الاختلاف إلى خلاف وترويج الإشاعات واختلاق الصراعات وتغذية الخصومات إلى التمرد على المؤسسات وإهمال القوانين والأنظمة وعدم الالتزام بالقرارات...الخ؛ ناهيك عن اعتبار أنفسهم أفضلَ من الآخرين وأحقَّ منهم في احتلال المواقع.
باختصار، إنهم يجعلون من التسيب أسلوبهم المفضل في التعامل مع المؤسسات؛ كما يجعلون من التحامل سلوكهم العادي مع جزء من القيادة؛ وذلك بهدف الضغط والابتزاز كأقرب طريق وأيسره، في اعتقادهم، لتحقيق أهدافهم الشخصية.
وهنا، تبرز خطورة هذا الصنف من الولاء (الولاء للمصالح الشخصية). فأصحابه لا يتورعون عن التحول إلى معاول للهدم، حين يفشلون في تحقيق أطماعهم. والأمثلة على ذلك، لا يعدمها المتتبع (وقد سبق لي أن تناولت بعضها). والسمة الغالبة عند هؤلاء، هي استعدادهم لهدم البناء على من فيه وطحن كل من يعتبرونه عرقلة في طريقهم. لكنهم، يزعمون، وبكل وقاحة، بأن ما يحركهم هي الغيرة على الحزب.
خلاصة القول، لقد عرفت أنماط السلوك داخل التنظيمات السياسية المغربية، بتأثير من التحولات المجتمعية، تغيرا كبيرا، قد يختلف عمقه وتأثيره من تنظيم لآخر؛ لكنه يتراءى للعيان في نمط العلاقة التي أصبحت سائدة داخل التنظيمات الحزبية، سواء فيما يخص علاقة الأعضاء فيما بينهم أو العلاقة بين هؤلاء وبين المؤسسات أو الأجهزة التنظيمية.
ويبدو أن قدر الاتحاد الاشتراكي أن يقدم النماذج والأمثلة، سواء الجيدة منها أو السيئة. فبعد أن تحدثنا عن دوره التاريخي في الدفاع عن الاختيار الديمقراطي ببلادنا وتسجيل تخاذل بعض أبنائه وخيانتهم لانتمائهم خلال الانتخابات الأخيرة (انظر " الاتحاد ليس دكانا انتخابيا !!!، نشر بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ 11 أكتوبر 2016)؛ وبعد أن تحدثنا عنه كمدرسة للإبداع السياسي والفكري (انظر "المدرسة المغربية للإبداع السياسي والفكري:
الاتحاد الاشتراكي نموذجا"، نشر في "تطوان بلوس" بتاريخ 13 يناير 2017)، دون أن ننسى ما كتبناه من قبل حول ردود فعل بعض المستفيدين من الريع الحزبي بعد أن تم فِطامهم، ارتأينا، في هذه السطور، أن نبرز التحول الذي حدث في علاقة الاتحاديين بحزبهم وببعضهم البعض. وهي علاقة أصبحت - بفعل طغيان الذاتية والأنانية لدى البعض والطموح الزائد عن الحد لدى البعض الآخر، زيادة عن عدم احترام المؤسسات من قبل الكثير- تتميز ببعض الجفاء والتباعد والفرقة...
فكيف، والحالة هذه، أن لا يفقد الاتحاد سنده الشعبي وأن لا تتأثر نتائجه الانتخابية وأن لا يتراجع موقعه في الترتيب التمثيلي وأن لا يتدهور وضعه في المشهد السياسي العام؟...