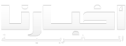في مثل هذا اليوم...أنا وصديقي المسيحي على طبق البيصارة

يوسف الإدريسي
في مثل هذا اليوم، قبل سنوات وبالضبط سنة 2003، وقتها كنت أعزب أمتهن التجارة التي كانت تتيح لي وقتا مناسبا للقراءة ومطالعة الكتب. أتذكر جيدا في يوم شديد البرد ولم يكن وقتها طعام يغري سوى طبق "البيصارة" بزيت الزيتون ومقدار قليل من الكامون، وقبل أن أشرع في احتساء أول شربة من الطبق، إذ بزميل لي أيام الدراسة بمراكش وقد تم تعيينه بإدارة الفوسفاط باليوسفية، يطرق باب المنزل الذي كنت به وحيدا، لم يتردد بعد مصافحتي في تقديم شاب ذي الثلاثين أو ما يزيد، طالبا مني استضافته ليوم واحد بعدما انقطع به السبيل ليلا وهو في طريقه إلى جمعة سحيم قادما إليها من مراكش، سألته عن قصته، فأجابني بأنه التقى به في المحطة وهو لا يعرف أحدا باليوسفية، ما جعله يقترح منزلي لهذا الموقف الإنساني. قبلت طلبه مضطرا على مضض، ليس بخلا مني أو تكبرا، بل هي ظرفية المدينة بعد أحداث تفجيرات 16 ماي 2003 التي لم تكن تساعد في هكذا عمل إنساني خاصة مع أجنبي قد تحوم حوله الشكوك، وأي شكوك هي، في مرحلة ما بعد 16 ماي، غير أني حاولت قدر الإمكان أن أنسجم ولو بمجازفة قاتلة مع مبادئ وتعاليم مرجعيتي الدينية التي تشدد على إيواء عابري السبيل، قلت مع نفسي وأنا أنظر في وجه زميلي الذي أتى به، إن الله يعلم نيتي وأكيد لن يخيّب سعيي. كان سبب توجسي هو أنه في ذاك الزمن انتشرت بكثرة في أوساط الشباب وأنا واحد منهم، مفاهيم تمتح من قاموس الفكر التكفيري المهيمن وقتذاك على المشهد الحركي باليوسفية من قبيل؛ الكفار، أهل الذمة، القتلة الأمريكيون...
لهذا أنا استغرب الآن كيف استضفت مسيحيا جاء في مهمة تنصيرية صرفة، ربما كنت غير مقتنع بما كان يقول به أصدقاء ضحايا الفكر التكفيري وهجرة المجتمع، أو ربما كانت لي وقتها مناعة متنحية تقف بيني وبين فكر أصدقائي التكفيريين...
المهم هو أني رحبت بالزائر، قال لي وهو يبتسم في وجهي إن إسمه جوزيف أمريكي الجنسية، أجبته بلغة إنجليزية ركيكة، وأنا إسمي يوسف الإدريسي، وبإمكانك اعتبار هذا المكان بيتا لك وأن تقبل على بساطته، فشكر لي حسن ضيافتي وبكونه متأكدا بأنه سيكون سعيدا هذه الليلة ما دام أنه استأنس قبل شهور من ذاك الوقت بوجوده بجمعة سحيم وسكانها الطيبين على حد قوله...قبل أن ينهي كلامه فاجأته بسؤالي عن سر تواجده ببلدة جمعة سحيم النائية، أجابني بحنحنة تخفي تحفظا بداخله، بأنه يدرس اللغة الانجليزية في إطار جمعية دولية، قلت معقبا؛ تقصد "تنصيرية"، رد علي؛ ليس بالضرورة، أدركت حينها أنه ينتمي إلى بعثة تنصيرية كانت تنشط بالمناطق القروية، في إطار اتفاقية دولية أو ما شابه ذلك...ذهبت لإعادة تسخين طبق "البيصارة" ولما عدت وجدته يتصفح، بفضول عفوي أو مقصود لأ أعرف بالضبط، المهم أني وجدته يقلب صفحات القرآن وبعضا من كتب المرحومين عبد السلام ياسين وفريد الأنصاري، الجميل أنه في محادثته كان يتعتع بالعربية وأنا أتعتع مثله بالإنجليزية وأحيانا نستعمل الإشارات حين يخوننا القاموس المفاهيمي...
أتذكر جيدا قوله لي بأنه توجس مني خيفة عقب أول لحظة للتعارف بسبب أني أحمل بعضا من مظاهر التدين، لكن بعد الأخذ والرد في الكلام تبين له أنه لا داعي للخوف، وفجأة، يسترسل هو في كلامه؛ وجدتني أقول في نفسي "أنا مع شاب منفتح ومتفهم.. لمَ علي التكتم على نصرانيتي...". أجبته بأني تعرفت منذ البداية على ديانته بل على مهمته التنصيرية الخفية، وهذا لا يعنيني في شيء مادام ديني يدعوني إلى إيواء عابر السبيل دون تحديد ديانته أو هويته، عانقني بقوة وهو يقول نحن إخوة قبل كل شيء، قلت له أكيد، والمؤكد أن المغاربة ليست مشكلتهم الأساسية مع الدين أو العقيدة بل مع أشياء أخرى.
نمنا على أفضل العزائم وكانت أيام بيض أو العشر الأوائل من ذي الحجة، لا أذكر جيدا، وكنت وقتها مواضبا على صيامها وقيامها، فأشرت إليه بأن لا يفزع من استيقاظي في ساعة مبكرة، فأومأ موافقا ومتفهما، بعد أن ناولته سروال نوم صوفي أسود لم يكن على مقاسه لطول قامته الفارعة.
في الثامنة صباحا من اليوم الموالي، استيقظ جوزيف وتناول الفطور لوحده قبل أن يودعني، طالبا مني إن كان في الإمكان تقديم خدمة لي على سبيل رد الجميل، فأجبته أني أريده فقط أن يكون قد أمضى ليلة سعيدة.
بعد هذا الحدث، وبّخني البعض على تهوري، وأشاد بموقفي البعض الآخر، أما أنا فحمدت الله على أن لا أحدا من السكان شاهد جوزيف وهو يخرج من منزلي.