ذاكرة مجتمعية

رشيدة الركيك
عندما تنكشف الذات عن نفسها مستفسرة سر نكوصها، قارئة لأوضاعها بكل أبعادها بشكل جديد، منسجمة مع مكوناتها من عقل وفكر وعلم، ثم روح وكيان نفسي له حمولته العاطفية، وعمق وجودي غير منفصل عن كيانه الاجتماعي في شكل ذاكرة جماعية لها حمولتها وشحناتها من طابع خاص.
حينما تنكشف الذات عن نفسها باحثة عن عمقها التاريخي، تجد ماض تنفعل به. ماض وإن انتهى العمل فيه لم ينته التأثر به. ماض يحكي الإنسان عنه وعن أفعال ما كان لها أن تكون، ليظهر فصاحته الحاضرة في زمن مضى ولن يتكرر إلا على مستوى الذاكرة في نوستالجيا كمورد نفسي، اعتبرها المختصون آلية دفاع يستخدمها العقل لرفع المزاج وتحسين الحالة النفسية دليل على الاستمرارية والتطابق مع الذات.
لا يمكننا أن ننكر أننا مخلوقات زمنية، تعيش الماضي في حنين على شكل تفكير مصحوب بإحساس لن ينقطع، تتحرك قدرة الإنسان على التخيل فيرى الصور من جديد في شكل تصوير سينمائي داخلي لحياة مضت ولن تعود بل نسافر إليها ،سفر له خصوصيته باعتباره سفر عبر الزمن بدون قيود أو تذكرة.
ونعود للحاضر باعتبارنا فاعلين فيه، نغير الأحداث. لنا فيه القدرة على القبول و الرفض أمام كل ما يعرض علينا، لكن دون أن ننسلخ عن ماض صوته مسموع بداخلنا، وننصت له بكل جوارحنا بين الحين والآخر،وكأنه أنا آخر يسكننا و يتعقبنا ويفرض نفسه علينا باعتبارنا عبيدا له ، فيتجسد في كل قراراتنا في حالة من الاستسلام دون أي قدرة على الخلاص.
نعم يمتلكنا الماضي قهرا وغصبا وعنوة، حين نتخذ مواقف بناء على تجاربنا الماضية، هكذا يعيش الإنسان اتصالا مع نفسه في شكل تاريخ فردي كان أو جماعي، ولن يتسنى له ذلك دون حضور تصور لحياة مستقبلية، لتحركه هذه الرؤية المستقبلية أو تلك اليوم بناء على أحداث ماضية في شكل استحسان أو استهجان.
و الأمر سيان بالنسبة للفرد أو المجتمع، تتشكل الرؤية المجتمعية الحالية لديه في ارتباطها بماضيه إن كان بعيدا فالذاكرة الجماعية تقربه، أما إن كان قريبا فإنها تعمل على إحيائه من جديد.
هكذا تجتر المجتمعات تاريخها من منظورها المجتمعي، بالكيفية التي عاشته في ارتباطه بكل جوارحها وأحاسيسها، فيعيش الإنسان الأحداث لا من منظورها العلمي أي في إطار ما ينبغي أن يكون، بل من دلالاتها المجتمعية المعاشة والكيفية التي يتفاعل معها أفرادها.
لا يمكن للإنسان أن يصمد أمام الأحداث الحياتية المتجسدة في الذاكرة الجماعية، لتحرك الكيان المجتمعي دون أية قدرة على المقاومة الفردية.
هكذا إذن، يبدو جليا كيف أن الذاكرة الجماعية للماضي حاضرة في كل يوم وفي أية لحظة وفي مختلف الأزمنة متجسدا في سلوكياتنا ومواقفنا: فالماضي حاضر اليوم، واليوم هو من سيحرك المستقبل، وهو أيضا من سيتحول لماضي، فيعبر عن نفسه فيما بعد على شكل مواقف كمرآة تعكس صورة واضحة أو مقلوبة لتجارب حياتية ماضية.
ولعل هذا ما يجعل من الحياة الإنسانية أكثر عمقا ودسامة. فقد يتصرف الشخص دون أن يفسر فعله بمنطق السببية، لكن يفتح الباب لمحاولات الفهم والتأويل في ارتباطات متشابكة للأحداث. لهذا ربما كان على الإنسان أن يحاور حاضره باسم ماضيه ليتفهم ذاته.
فالزمن أكيد في ارتباط مع نفسه بشكل لا يقبل أي انفصال أو تجزيء في خط واحد ليشكل هوية واحدة سواء كانت للفرد أو المجتمع، بينما القفز على الأحداث في شكل وثبات يجعل منه لغزا يحتاج لفك شفراته، ومن تم العودة إلى الماضي لفهم الفرد والمجتمع وتفهمه في مساره التاريخي، ضرورة لها ما يبررها.
كل ما يحدث للمجتمعات له ارتباط بما عاشته من أحداث وظروف، لن تكون إلا وسيلة لفهم حاضرها، إما في شكل قبول له، أو رفض بشدة يفسر في شكل مواقف متمردة يٌستعصى تغييرها.
إنها الذاكرة الجماعية -ما تحمله من مآسي صادمة- يفسر توجهات المجتمعات في شكل تجارب جماعية تتشكل في خبرة ذات مصداقية، مرجعها الوحيد الشحنات العاطفية المتمركزة في الماضي.
للذاكرة الجماعية قوة لن تقهر مع مر الزمن، بل ربما تتقوى ويكبر حجمها مع تراكمات أخرى في مراحل زمنية تليها.
وكأن المجتمعات تعيش مرحلة تعاني فيها من مرض الزهايمر في كثير من مواقفها، رافضة الحاضر متمسكة بالماضي تأبى تناسيه وإن كان مرا، مٌعاندة القدر في سنته بالمضي نحو الأمام، لتصبح الذاكرة الجماعية واقعا معيشيا تستحضر فيه شخصيات مضت وتخلد تاريخها في قطيعة مع حاضرها.
هكذا تتعجل المجتمعات موتها بالعيش في عالم الأموات الخالي من أي فعل أو حياة.
فأي رسالة يحمل الماضي لنا كمخلوقات زمنية؟ متى يتحول كزمن للاستفادة وأخذ العبر، دون تثبيت- كحالة مرضية -على مرحلة معينة تٌعد في خبر كان؟
هكذا يبدو وكأن المجتمع يٌحاكم الماضي بمنطق الحاضر ويٌقاضيه، يأبى أن ينفذ الحكم عليه باعتباره جزء لن يتجزأ عنه، هو مجتمع إذن في ملامح جسد موشوم بالتعب والقهر لن يقوى على النهوض من جديد، ليبقى الألم دائما قدر أية هوية وسر من أسرارها فردية كانت أم مجتمعية.
من تم يعيش الإنسان مثلما تعيش المجتمعات الزمن، وتتعلق به في شكل حنين وجودي كدليل على الاستمرار، ويتشكل هذا الترابط في الذاكرة وعن طريقها، من دونها تضيع كل هوية حقيقية.
لكن السؤال الصارخ في وجوهنا باعتبارنا ذواتا تدعو نفسها للتنمية من خلال القدرة على التغيير والتطور: كيف نجعل من الذاكرة المجتمعية مجالا واسعا وخصبا لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا؟
ثم هل يمكن أن تصبح الذاكرة نافذة لرؤية مستقبلية وردية تكون مرتعا لبسمة أمل، يرسم معالمها الماضي بعيدا كان أم قريبا؟ أليس تغيير كيفية نظرتنا للأحداث وتحليلها بكل إيجابية من شأنه أن يحوّل اتجاه سفينة التاريخ حيث بر الأمان؟
لا شك أن قراءة الأحداث في رؤية مستقبلية جميلة ما يجعل ماضينا كمجتمع حاضر بشكل إيجابي، مما يجعلها حياة اجتماعية إيجابية، تتكون فيها ملامح إسعاد الغير ليتحول فيما بعد إلى مجال لإسعاد الأشخاص، وتظهر ملامح الحياة المبهجة والمغرية للعيش، تفتح فيها أبواب الأماني والأمنيات وتظهر ألوان الأزهار المزركشة تجذبنا بلهفة و إقبال لا يقاوم على كل جمال.
تبدو ملامح السعادة المجتمعية في لغة الناس وأسلوب عيشهم و سلوكياتهم وانتظاراتهم و رؤيتهم المستقبلية، دون سخط أو خوف وترقب أو هرب كمنطق يتخذ مشروعيته من هول ما قد يقع في المستقبل.
حين يلتقي الماضي المرير للأشخاص بالحاضر الأمر، يؤجج الوضع في اتجاه صور سوداوية تزيد من ظلمة الواقع، فتطفو خطابات لا تحرك ساكنا إلا في اتجاه تغذية الوضع وتأجج الغضب الجماهيري بخطابات تعزف على الوتر الحساس. خطابات شفوية لا تأخذ الإقناع والتعقل طريقا لها بقدر ما تهدف إلى التأثير في المستمع مستهدفة هيجان الماضي في شكل مشاعر عارمة يصعب التحكم فيها لشيء الذي يسبب انفعالات تتأجج وسط الجماهير، فتجد الأفراد نفسها منساقة تهتف مثلما تتوالى التصفيقات الجماهيرية دون أي فهم جماعي، فنردد كل صدى يصلنا.
هكذا ترتفع وتزداد وتتوالى الصرخات، وإن كانت مبررة بمنطق ما، فإن بعض وسائل الاتصال والتواصل تصطاد في الماء العكر باحثة عن نسب مشاهدة عالية، تقدم صور قاتمة تغذي الإحساس باليأس الجماعي. و إلا لماذا لا تأخذ على عاتقها تقديم الرأي والرأي المضاد وتفتح عقول الناس وتترك لهم القدرة على التحليل والنقاش من أجل اتخاذ مواقف والدفاع عنها في كل مداخلاتها.
ما حصل في الحقيقة لم يعد في طي النسيان كما يقال، إنما الأحداث المجتمعية تٌستثار من جديد كلما مست شخصا آخرا يحكيها بحرقة، تٌخرج كل الذوات ما تحمله من شحنات لتجد منفذا لها.
ما يقع فيه المجتمع والأفراد شراك الزمن ليترك خطوطه في شكل تجاعيد على الملامح، تعكس ما مضى عبر السنين بشكل حقيقي أبدي خالد.
بعد ما كنا نتباهى بكوننا مخلوقات زمنية، تنظم الزمن وتخضع أفعالها له، أصبحنا نهجو ما فعله الزمن فينا من تغيرات، حين يصرخ في وجهنا أن دوام الحال من المحال، وأنه علينا أن نتمتع ببعض اللحظات الجميلة لن تتكرر، باعتبار أنه علينا أن نعيش دائما مقذوفون في اتجاه المستقبل.
عموما يتنقل الإنسان والمجتمع عبر التاريخ في محطات حياتية بفضل نعمة الذاكرة، هذا ما يمنحه البعد الزماني لكينونته في ارتباطه بالمكان والأشخاص، يمنحه غناه الوجودي المتفرد، لكنه يأخذ طابعه الجميل في توازنه، بينما قد يعيش مرض الأعذار في البكاء على الأطلال وضياعا للجهد والزمن ليعيش حالة من التشرد الوجودي.
تلك هي المفارقة التي تجعل من الذاكرة الجماعية محط بناء أو هدم، تحتاج منا الكثير من الحيطة والحذر، لذلك علينا أن نحسن النظر للأحداث بشكل يجعل حياتنا أجمل، وإلا ضعنا في السخط على الحاضر، وبرمجنا سلبيا لحياة مستقبلية تدعونا للاستعداد أكثر لمعاناة بخوف وحذر بسبب ما تحمله الذاكرة من شحنات عاطفية تقودنا لا محالة للحقد والكراهية دون التمتع بحياة اجتماعية إيجابية .
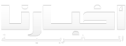








_1731058810.png)





