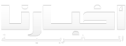الجور الواقع على نساء ورجال التربية الوطنية

ابراهيم تيروز
تعتبر حافزية المورد البشري في أي قطاع من القطاعات المهنية رافعة أساسية للنهوض به، فكلما كانت فرص الترقي أمام العاملين بالقطاع متاحة وفق مبدأي التكافؤ والاستحقاق وبطريقة شفافة ومعقولة، كلما شكل ذلك حافزا لنهوض المورد البشري بمؤهلاته العلمية والمهنية بما يزيد من كفاءته وجودة أدائه.
وأمام أهمية وحيوية هذا المعطى البديهي الذي ينص على ضرورة فتح مسارات تحفيزية تسمح لموارد القطاع التربوي البشرية بالترقي وبالاعتماد حقيقة على التأهيل العلمي والمهني، يحق لنا أن نتساءل الى اي حد تعمل به منظومتنا التربوية؟
وللأسف يعاني العاملون في قطاع التربية والتعليم ببلدنا من حصار إداري تعسفي يجعل وضعياتهم شبيهة بالأدراج المغلقة، التي ما أن توضع في واحد منها حتى يصبح من الصعب ان تغادره الى درج أفضل. وهذا الأمر هو ما يجعلنا لانستغرب لجوء الكثير من أطر القطاع الى مهن وأعمال موازية يحسنون بها وضعهم الاجتماعي، أما من لم يفلح في ذلك وبقي مخلصا لقطاعه الأساسي فيجد نفسه محكوما بمعاناة سيزيفية وشبه أبدية لأن أبواب الترقي السالكة موصدة في وجهه. وقد كان سيهون الأمر لو أن لذلك كله انعكاسا سلبيا فقط على وضع العاملين بالقطاع، لكن واقع الحال يؤكد أننا أمام فوضى ولاعقلانية في تدبير وترشيد توظيف طاقات وكفاءات أطر القطاع وصهرهم في بوثقة النهوض به.
لهذا لا بد أن نشير إلى أن غياب تدوير مواقع عمل ومؤهلات أطر القطاع بصورة تسمح لهم بالتدرج مما هو أدنى الى ما هو أعلى، وبصورة أعمق وأوسع مما هو كائن، يرغم هيئات موظفي القطاع المختلفة على التفكير خارج صندوق القطاع بشأن الترقي الاجتماعي.
فبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية المغربية قد أحدثت مؤخرا مسالك جامعية تربوية تفتح على الماستر وما بعده، ورغم وجود كلية مختصة في علوم التربية بالعاصمة ومنذ عقود، فإن وزارتنا توثر على أطرها وتكافئ الأغراب؛ ففي الوقت الذي نجد فيه الوزارة تعادل شواهد تخص أطرا من قطاعات أخرى كالهندسة والبيطرة والتقنيات والإدارة، نجدها تغبن الشواهد والدبلومات التي تجيز بها لأطرها العمل بأسلاكها المختلفة.
فكيف ذلك؟ وما أثره على المنظومة؟ وكيف يمكن تصحيح الوضع؟
إذا نحن راجعنا الجريدة الرسمية المغربية، سنجد أطر قطاعات عديدة منحت لدبلوماتها المعادلة بما يتناسب مع مستواها ومع عدد سنوات الدراسة او التكوين المطلوبة لتحصيلها؛ وبالفعل نجد دبلومات في البيطرة والهندسة والتقنيات والإدارة تمنح المعادلة بما يكافئها ويناظرها أكاديميا رغم أنها بالأساس دبلومات مهنية لا شواهد علمية خالصة؛ وهذا في اعتقادي أمر طبيعي من جهة، إذ لا غنى للمهني عن الأكاديمي ولا قيمة لماهو أكاديمي دون أثر مهني، لكن ما هو غير طبيعي و لا معقول بتاتا هو أن تحرم الوزارة دبلومات وشواهد أطرها التربوية من ذات التعامل.
وهنا نسائل الوزارة وبنوع ما من الترتيب عن الشواهد الآتية:
دبلوم مركز تكوين المعلمين والمعلمات سابقا
دبلوم المدرسة العليا للأساتذة سابقا
شهادة التأهيل التربوي الممنوحة من المراكز الجهوية
دبلوم الإدارة التربوية
الشهادة الممنوحة للمستبرزين
شهادة التبريز
دبلوم التوجيه أو التخطيط التربوي
دبلوم مركز التفتيش التربوي
وقد أكون نسيت شواهد أخرى...
فهذه كلها شواهد ودبلومات يتم الحصول عليها بعد تكوين مضن وانتقاء مشدد، تشرف عليه الوزارة المعنية، وأغلبها لمدة سنتين، ويشترط لها مستوى جامعي معين، لكن الوزارة لا تمنحها أي معادلة جامعية، رغم ان الجامعة تحت إشرافها في حين نجدها سخية في معادلة شواهد مهنية كما سبقت الإشارة تهم قطاعات أخرى كالتسيير والتجارة وكالبيطرة والتقنيات والهندسة وهلم جرا...
فإلى متى سيبقى نساء ورجال التعليم يبدؤون من الصفر كلما أرادوا تطوير مستواهم الأكاديمي؟
وفي هذا الإطار معلوم أن مركز تكوين المعلمين والمعلمات سابقا كان يستقطب نسبة هامة من الحاصلين على الباكالوريا بمعدلات لا بأس بها الى حسنة وجيدة، ويخضعون خلاله لتكوين تسوده الجدية والانضباط بين ماهو تربوي أكاديمي وماهو تربوي مهني، فلم لا تمنح الوزارة معادلة لهذا الدبلوم تشجع بها كتلة هامة من أطرها على تطوير كفاءتهم العلمية وفي الآن نفسه المهنية؟ ألا يستحق أن يعادل بشهادة "الدوغ" في تخصص التربية على الأقل؟
والأمر نفسه يقال عن دبلوم المدرسة العليا للأساتذة، ألا يستحق أن يعادل بمستوى السنة الثانية من الماستر في التربية على الأقل؟ بحيث يحفزهم ذلك على السعي لتحصيل الماستر خصوصا وأن السنة الثانية يتضاءل فيها عدد المواد المقررة وينشغل الطلبة أكثر بكتابة البحوث وهو الأمر الذي سيتوافق مع ظروف عمل الأساتذة. والأمر عينه سينطبق على الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي الممنوحة حاليا من المراكز الجهوية وعلى دبلوم الإدارة التربوية وعلى الشهادة الممنوحة للمستبرزين.
وبالمثل لماذا لا تعادل الوزارة شهادة التبريز ودبلومات مراكز التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوية؟ هل تعتبر الوزارة هذه الشواهد دون مستوى الماستر لتطالبهم بضرورة تحصيله للالتحاق بسلك الدكتوراه المناظر لتخصصاتهم او في التربية بصفة عامة؟
لنلاحظ فقط أن شهادة التبريز يشترط للحصول عليها الخضوع لتكوين مكثف لمدة سنتين أو الإدلاء بشهادة الماستر، مما يدل على أن الماستر معادل ضمنيا لسنتي التكوين تلك دون اجتياز مباراة التخرج، ولنلاحظ أيضا أن هذه الأخيرة عادة مايشرف عليها أستاتذة جامعيون يركزون بالأساس على الجانب الأكاديمي لتخصص الشهادة، وعلى مدى تمكن المتبارين منه مهملين الجوانب البيداغوجية والتربوية نظرا لخلفيتهم المهنية الجامعية أولا، وثانيا لألفتهم بحاجيات التعليم العالي لا الثانوي التأهيلي أو الأقسام التحضيرية.
فمادامت الوزارة تعتبر هيآتها المختلفة بمثابة أدراج مغلقة تحاصر داخلها الملتحقين، وتعرقل تقدمهم الأكاديمي بهذه الصورة خصوصا مع تزايد عراقيل متابعتهم الدراسة، وتوقف بذلك تدوير مواردها البشرية والسماح لهم بالتدرج في العمل بين أسلاكها التعليمية بحسب الأهلية والاستحقاق، ابتداءا بالابتدائي وانتهاءا بالعالي، فكيف لا يبحث هؤلاء في اتجاهات أخرى للترقي الاجتماعي؟ كيف لا يتحول بعضهم إلى البحث عن شغل إضافي في البناء أو الكهرباء أو التجارة أو السمسرة؟
أليست الوزارة مدعوة أمام هذا النزيف وهذا الهدر في طاقة أطرها وتطلعاتهم المشروعة إلى تشجيعهم لتطوير كفاءتهم العلمية والمهنية، وفتح باب التدرج المهني والعلمي أمامهم؟
ومادام قطاع التعليم من أكثر القطاعات أهمية وحيوية ومن أكثرها توفيرا لفرص التوظيف، فلم لا يعتمد مبدأ التدرج المهني. ولم تفضل الوزارة مثلا طالبا حاصلا على شهادة عليا دون خبرة ودون تمرس على إطار تمرس بأسلاكها وحصل او يمكنه الحصول على ذات الشهادة إن أفسحت أمامه مجال تحصيلها؟ أليس المتدرج في المهنة والمحصل في ذات الوقت على الشهادة الأكاديمية أفضل نسبيا من الحاصل على هذه الأخيرة فقط؟ أليس أولى اعتماد التدرج المهني المبكر في وجه الطلبة وفي جميع القطاعات؟ وبتساؤل أوضح لماذا يستحيل ان يصبح التقني مهندسا او الممرض طبيبا او أستاذ الابتدائي أستاذا جامعيا في هذه البلاد؟ ألا يمكن تجسير الفجوة بين هذه الفئات بالتكوين المستمر والذاتي وعن بعد؟
كيف لا يتردى حال الجامعة مثلا وهي تعاني من هذا الواقع بالذات؟ لنتذكر فقط كيف تدرج مفكر المغرب الأشهر الجابري مثلا في أسلاك التعليم لعلنا نشعر بحجم الفرق. وأخيرا وأمام كل ما أوردناه أعلاه لنا أن نتساءل عن المعنى الذي تفهم به وزارتنا الفذة الاحتفاء بمدرسيها؟
وقبل أن ننهي هذا المقال دعونا نتأمل بصورة أوسع في هذا الوضع، وكيف بالضبط تعاني آلية الانتقاء والترقي بمجمل القطاعات عندنا من اختلال جسيم. فبعد الباكالوريا مباشرة يلتحق المتفوقون من الدرجة الأولى - وبالأخص الميسورون منهم - مباشرة بالمعاهد والمدارس العليا وبكليات الطب، حيث غالبا ما يكون الحصول على منصب شغل ممتاز مضمونا بنسبة كبيرة. أما الذين يتبعونهم مباشرة في التفوق وأحيانا لسوء الحظ أو لسوء الوضع الاجتماعي، فتستقطبهم مباشرة وربما قبل ذلك أو بعده بسنتين أو ثلاث قطاعات كالتعليم أو الجيش أو القضاء أو الدرك أو التمريض وغيرها من قطاعات الوظيفة العمومية التي تفتح على أفق تشغيل مضمون بدرجة مهمة نسبيا، وذلك بعد حصولهم على تكوين بمعاهد مخصوصة أو بالجامعة، غير أن التحاقهم المبكر هذا بالوظيفة العمومية سيكون وبالا على ترقيهم في القطاع الذي التحقوا به. وفي هذا الوقت تستمر البقية الباقية حسب المستطاع في الجامعة، غير أن من يجدون أكثر الطريق سالكة لاستكمال دراساتهم العليا هم من ستسمح لهم أوضاعهم المادية ورصيد علاقاتهم الأسرية بذلك، هذا إلى جانب نزر قليل من المتفوقين الذين ابتسم لهم الحظ بعد أن تنكبوه في فرص سابقة أو مبكرة، أو الذين منهم تمكنوا من نيل بعض من تعاطف محيطهم وأساتذتهم.
ولمزيد من التوضيح لنا أن نلاحظ أن مجال التوظيف يستقبل أكثر وعلى نحو مبكر المتفوقين وفي وظائف أدنى، في حين يستقطب في وظائف أعلى أحيانا كثيرة من كانوا أقل تفوقا منهم، وبدل أن يكون العمل والتكوينين الذاتي والمستمر المرافقين لهذا الأخير مكافئين للاستمرار في الدراسة، يجد من وظفوا مبكرا أنفسهم
وكأنهم وقعوا في مصيدة، حيث بعد سنوات من العمل يعين بعض ممن كانوا أقل منهم مستوى في الدراسة في مناصب أعلى وأفسح مجالا للترقي. ولنا أن نلاحظ بالمناسبة أيضا أن فرص الترقي تضيق نزولا في سلم الوظيفة ولا شيء أدل على ذلك من حرمان أساتذة التعليم الابتدائي من الترقي خارج السلم. وهذا يؤكد فعلا أن قطاع الوظيفة العمومية عامة بمثابة أدراج محكمة الاغلاق كلما نزلنا في سلم الوظيفة العمومية.
وإذا نحن أضفنا لهذا المعطى معطى آخر يتعلق بما يعشش في بنية التوظيف ببلادنا من فساد ومحسوبية ستظهر كوارث أخرى أفظع وأشنع، فكثير من محدودي المستوى بل وعديميه أحيانا، ونظرا لمستواهم الاجتماعي الميسور تمكنوا من استكمال دراساتهم العليا وتحصلوا كذلك على مناصب عليا، ليفاجأ زملاؤهم القدامى المتفوقون عليهم بأشواط، بكونهم عينوا كرؤساء عليهم. وغير خاف ما لذلك من تبعات على سير المرافق العامة ولعل أبرزها ما يتمثل في إعادة انتاج نفس المنطق الذي أوصل هؤلاء إلى ماوصلوا إليه.
وفي المقلب الآخر من الصورة تواجه أعداد كبيرة ممن تابعوا دراستهم ولم يكونوا من الميسورين أبواب البطالة المشرعة على مصراعيها، وكأنهم أدخلوا متاهة ضاعوا فيها وأضاعوا زهرة شبابهم. فلم لا يتم التفكير تفاديا لهذا المصير السوداوي وانعكاساته السلبية المختلفة في التركيز على التوظيف المبكر، وجعل الوصول الى المناصب العليا رهينا بالأساس بالتدرج المهني وبالتكوين المستمر والتكوين الذاتي وبالدراسة عن بعد. إذ كيف أولا لمن عجز عن تحصيل وظيفة أدنى أن تتاح له أخرى أعلى؟ وثانيا أليس أجدى أن تواجه البطالة مبكرا لدى الشباب من أن يلاحق سرابا قد يأتي وقد لا يأتي، ويكون حينها وبعد سنوات الدراسة الطويلة عاجزا عن التكيف والبحث عن مسارات أخرى بديلة؟ ألا يبدو أمام هذه التساؤلات من الأنسب تركيز فرص التشغيل في الوظائف الدنيا وحصر الالتحاق بالعليا منها على من أبرزوا كفاءتهم وقابليتهم الميدانية والنظرية في تسلق سلم الوظيفة ضمانا لحافزية الجميع، وحفاظا على تنافسيتهم الدائمة بما ينعكس على نحو أفضل على المرفق العام داخليا وخارجيا؟ أليس هذ مخرجا مناسبا لمشكلة هجرة الأطر العليا التي تنفق عليها الدولة سنوات طويلة من التكوين؟ أليس أنسب أن يستقيل موظف أعطى مثل الذي سيأخذ معه من هجرة إطار خام بالكاد اشتغل أو لم يشتغل بعد؟