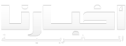الديمقراطية المستمرة من الوثيقة الدستورية إلى الدستور المتفق عليه تأويليا

صالح أزحاف
ارتبط مفهوم الديمقراطية في المجتمعات وأنظمتها السياسية، بسؤال تقييمي لمرحلة نشأة الفعل الديمقراطي، بمعنى أنها تسائل عبر الخط الزمني؛ لحظة الانبثاق أو الولادة القيصرية لأي مشروع سواء كان قانوني أو سياسي أو حقوقي. هذا التوجه يمكن قبوله وتداوله نسبيا ارتباطا منه بفلسفة العقد الاجتماعي، لأن الفرد آنذاك تنازل عن جزء من البناء الديمقراطي إلى فاعلين محددين (التوجه الأوليغارشي في رصد وتتبع التحولات الديمقراطية).
عند إعداد الوثيقة الدستورية وصياغة الخريطة السياسية للبلاد، تظهر فجأة حركة نخبوية ضيقة تتحكم في النقاش العام وبلورة مساره، فالإدراك الجماعي بالديمقراطية المستمرة مغيب لدى مختلف الفاعلين المختصين داخل المجتمع، حيث لا يتجاوز هذا الإدراك سؤال، "هل الدستور ديمقراطي من حيث الإعداد أم لا"، مستحضرين مفاهيم من قبل ( دستور ممنوح، دستور ديمقراطي، دستور وضعه الشعب، دستور ناقص...). مكرسين ثقافة دستورية ضيقة ومحدودة، في المقابل يغيب سؤال ماذا بعد الدستور.
في ظل الانتقال إلى فلسفة جديدة تشرك الكل في الإعداد والتتبع والتقييم والمساءلة، لا يمكن قبول التوجه الذي يجعل من الفرد وسيلة تساهم في التعبير فقط عبر صناديق الاختيار، فالديمقراطية اليوم أصبحت مستمرة تستلزم المواكبة والتتبع، من مختلف القوى داخل المجتمع بما فيهم الأفراد، لأن الخلل الذي يشوب التحول الديمقراطي، ليس نتاج فعل سياسي محدد أو بسبب رؤية مشخصنة يمتلكها مسؤولا ما، بل هي نتاج الكل، فالفرد أصبح يؤثر (سلبي/ايجابي) في البناء الديمقراطي.
يدل هذا كله، على أن سياق الانتقال من الوثيقة الدستورية إلى الدستور المتفق عليه تأويليا، يستلزم الانتقال من الفلسفة الأرسطية في تحديد وصياغة الدساتير، التي تقوم على طلب محاوريه بوضع دستور ديمقراطي فأجابهم؛ "صفوا لي أولا الشعب الذي تطلبون له دستورا مع تحديد زمانه ومكانه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية
فأضعه لكم". إلى التركيز على فلسفة نابليون في تحديد وصياغة الدساتير ، حيث اعتبر أن الدستور الجيد يجب أن يكون مقتضبا وغامضا. مما يعني أن الوضوح والاكتمال الديمقراطي يستلزم مراحل أخر بعد الوثيقة الدستورية. ومن الأوائل الذين تأثروا بهذه الفلسفة هو الجنرال ديغول عندما صاغ دستورا للجمهورية الخامسة عام 1958.
إن التحولات الديمقراطية تتم عبر هذا المعطى الفلسفي، مدركة أنه ليس المهم صياغة الدستور بل العمل به وتطبيقه. لهذا ينبغي أن نميز بين النظرية والتطبيق، فالنص الدستوري قد يكتب بصياغة ما، لكن التطبيق العملي قد ينحرف. هناك فرق كبير بين الدستور والقانون التنظيمي، فعادة ما تصاغ الدساتير بشكل عام وتأكد على مبادئ أساسية تحيط بالديمقراطية وثيقيا أو نصيا، ثم تأتي التفاصيل في القوانين التنظيمية، التي لا تعطي الاستمرارية للديمقراطية بذلك المعنى الذي حدد في الوثيقة الدستورية، أي أن عملية التأويل للوثيقة الدستورية لم تكن سليمة.
إن المرحلة الفاصلة بين صياغة الوثيقة الدستورية وتفعيله تستلزم إخضاع عملية تأويل الوثيقة الدستورية لتأثيرات الفضاء العام، فالديمقراطية تستمر وتزدهر عندما يكون للأفراد دورا في النقاش العام. أي أنه يجب تركيز الإعادة في قراءة الوثيقة الدستورية إلى منطق القيم الانسانية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية. فهناك دساتير تسعى إلى الاحتفاظ بالثقافة الديمقراطية المحدودة عموما من دون أي تعديل، ومنها ما يهدف إلى تعديل هذه الثقافة، ومنها ما يسعى لخلق ثقافة جديدة تنفتح على الكل في سياق تفعيل الدستور من خلال إخضاع عملية التأويل للمتغيرات والتأثيرات المجتمعية، كآلية للتمكين الديمقراطي.
تسعى العديد من الدول إلى التحول الديمقراطي بداع الانتساب الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تعد في نظرهم معيارا تقييميا لدمقرطة الأنظمة السياسية، وينحصر طموحها هذا من خلال إعداد وصياغة دستور لا يمكن أن تناقشه إلا من زاوية الشرعية والتحفظ على مشروعيته. في حين أصبح الدستور الديمقراطي الذي يجب الانفتاح به على المنتظم الدولي، في سياق انتقاله من الشرعية إلى المشروعية، سيواجه سؤال الامتيازات التي يمكن تكريسها ولمن؟ لتحديد مدى ديمقراطيته، فإذا جاء تأويل الدستور لتحقيق امتيازات الأفراد حقوقيا، نكون هنا بصدد عملية تأويلية ديمقراطية، أما إذا استمر في تكريس امتيازات السلطة، فنكون بصدد بناء أجوف. كما يقال؛ إن انبلاج فجر الدستور، في جو التحولات الديمقراطية يرافقه دوما انبلاج فجر الحرية، فدونها يصبح الدستور وعاء فارغا يعلوه الصدأ.
إن أغلب الدساتير الأخيرة التي صيغت في المغرب الكبير، ترجع كاستجابة لما سمي بالربيع الديمقراطي أو الحراك الاجتماعي، حيث أعاد للرأي العام حضوره ومكانته وأعاد للشارع والساحات والميادين فاعليتها، مسترجعا
بذلك إنتاج المجال العام المغاربي، ساحات التلاقي (المساهمة في إعداد وتأويل الدستور). فاستطاع بذلك الفاعلون الجدد، أن يفرضوا شعاراتهم ومطالبهم من خلال هذا الفعل السياسي المؤطر. ولكن ما يجب لفت الانتباه إليه هو كيف يمكن لهذا الفعل السياسي الانتقال من الشارع (الفضاء الغير مهيكل) إلى المؤسسات (الفضاء المهيكل)، للعمل على مواكبة المتغيرات الدستورية والمساهمة في تطوير المجال الحقوقي، وكذا المراقبة الجماعية لمدى دستورية القوانين. يقول رئيس البرلمان الأوروبي '' جيرزي بوزيك'' في هذا الصدد أنه "لم ينته الربيع الديمقراطي، بل بدأ للتو " وذلك من خلال وجود؛ صحافة حرة ومستقلة - الموازنة بين الفرد والسلطة - التهييئ قانونيا ومؤسساتيا لمجتمع متعدد ومتعايش.
هذا ما دفع عالم الاجتماع الفرنسي ''آلان تورين'' من خلال مقالة في صحيفة ''لوموند'' الفرنسية في بداية الربيع الديمقراطي إلى انتقاده لبعض المثقفين الفرنسيين الذين وقفوا ضد هذا الحراك الذي عرفته المنطقة، ، معتقدا بأن هناك مرحلة جديدة للديمقراطية ستؤسس وتترسخ بفعل هذا الحراك. وفي هذا الصدد يشير مفهوم ترسيخ الديمقراطية في أوسع معانيه إلى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتى يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر، يكون قادرا على الاستمرار، ويجسد بشكل حقيقي وفعال لقيم الديمقراطية وآلياتها.
بالفعل، عرف المغرب ما بعد دستور 2011 قفزة نوعية مهمة ، ليس فقط على مستوى الوثيقة الدستورية أو المؤسسات، بل أيضا على مستوى الرأي العام، فقد أصبح منسوب الوعي السياسي والقانوني للمواطنين المغاربة مرتفع، فالكل ساهم في الانخراط في عملية إعداد الوثيقة الدستورية على مستوى النقاش العام الذي رافق مرحلة الإعداد، فاقتراحات المجتمع المدني كانت حاضرة ، والمذكرات وصلت بأعداد مهمة لنقل ذلك النقاش إلى المتن الدستوري. لكن لا يجب التوقف عند هذا الحد والاكتفاء بهذه المرحلة، خصوصا وأن نوعية الدساتير التي أصبحت تطرح، تأخذ من العامية أساسا لها ومن الإحالات على القوانين التنظيمية مبدأ كذلك، مما يعني على أن مرحلة النقاش العام الذي رافق مرحلة صياغة الدساتير يجب أن يستمر إلى مرحلة تفعيل الدستور عبر الانخراط الفعلي في عملية التأويل الدستوري، لأن المؤسسات الدستورية، التي تعمل على إخراج القوانين الموازية للدستور لابد لها من الخضوع لمعادلة التأثير والتأثر مع النقاش العام. لهذا تعد مسألة تخصيب الثقافة الديمقراطية تربويا في مختلف البنيات التحتية ضرورية لأن البناء الديمقراطي يتطلب ثقافة ديمقراطية اندماجية تشرك الكل على مستوى أفقي- أفقي.
فإذا كانت الدستورانية التقليدانية تهتم أكثر بالمادة الدستورية المكتوبة، فالانتقالات النوعية التي شهدتها حركة تدويل الدستور، اهتمت أكثر بالعمل التأويلي، معتبرة أن الوثيقة الدستورية عقد غير مكتمل، يستلزم قراءات متجددة وفق المتغيرات المجتمعية. ويجب هنا على مختلف الفاعلين تأكيد هذا التحول خصوصا القوى السياسية من خلال التدخل عبر آلية التأويل لتجاوز جمود المادة الدستورية، وجعل الدستور يساير الديمقراطية عبر تفعيل اتفاقات دستورية، تأسيسا بذلك لمرحلة دستورية جديدة تقوم على دستور متفق عليه تأويليا، من خلال المراهنة على قراءات متجددة ومنفتحة على الكل .
فالقانون الدستوري بمعناه الحديث؛ يتجاوز فكرة مجرد أنه وثيقة أو نص مكتوب، إلى اعتبار القاضي الدستوري محور لعملية التأويل الدستوري وليس قاضيا عاديا، بمعنى يجب عليه أن يتعامل ويستحضر مختلف قراءات الفاعلين للوثيقة الدستورية، من منطلق المنطق الديمقراطي، وفتح باب التفاوض والنقاش في فضاء مفتوح، فالمسألة الدستورية لم تبق في حدود إرادة وطريقة تفكير الدولة الوطنية. لهذا يجب على القضاء الدستوري تجاوز النص الدستوري الجامد لصالح الديمقراطية المستمرة، وفهم المناهج الاجتماعية ضرورة لفهم النظم الدستورية. فالقضاء الدستوري له دور مهم في الكشف عن مدى التزام المخرجات الدستورية بالمبادئ العامة الحاكمة للدستور وكذا بالإجماع الكافي في عملية التفسير ولتفعيل دستور متفق عليه تأويليا.
يعتقد الكثير من الباحثين، بأن ممارسة اختصاص القضاء الدستوري في مراقبة القوانين، يعد مسا بجوهر الديمقراطية ويحد من مبدأ سيادة الشعب، والذي كان سائدا في فترة تقديس القانون بفعل عوامل سوسيولوجية، كان لفلسفة عهد الأنوار دور أساسي فيها، فكتابات ''مونتسكيو '' و ''روسو'' ذهبت باتجاه إعطاء القانون صفة مطلقة. هذا الاتجاه كان يفتقد لمؤسسة مستقلة ضامنة لاستمرارية المكتسبات الديمقراطية في الوثيقة الدستورية، من هنا بدأ القضاء الدستوري يستمد شرعيته التي إن كانت من حيث الشكل المؤسساتي تكشف نوع من التشنج بينه وبين المؤسسة التشريعية بعلة مصادرة سلطة الشعب باعتباره صاحب السيادة ، إلا أنه من حيث الاختصاص، تبين أن العلاقة بين القضاء الدستوري والسلطة التشريعية تنطوي على الحوار وتبادل الأفكار والآراء، وهو حوار ينبغي أن يكون ايجابيا من أجل إخضاع الوثيقة الدستورية إلى التطور ومواكبة المتغيرات المجتمعية.
يشكل القضاء الدستوري، على حد تعبير ''دومنيك روسو ''، هيئة أساسية في عملية التشريع وفي الانتظام السياسي. ما يعني أن الرقابة على دستورية القوانين جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، من هنا ينصرف الحديث عن الديمقراطية الدستورية والتي تستمد منها الرقابة على دستورية القوانين شرعيتها،كما ارتبط القضاء الدستوري
بشكل وثيق بنمو وتطور حركة الدسترة الجديدة ، والتي تهدف أساسا إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من الضوابط القائمة داخل النص الدستوري. كما أنه برز كنتيجة متزامنة ومتوافقة مع الطفرة النوعية التي عرفتها الديمقراطية.