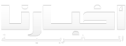مؤسسات المجتمع المدني، بين مثالية الرؤى وعشوائية الانجاز

طارق بوستا
مما يؤسف حقا أن تكون حركة المجتمع المدني المتمثلة في مؤسساته الوسيطة من جمعيات وتعاونيات ومنظمات مستقلة، منساقة في خضم السياقات المتشكلة آنفا، المرسومة بعناية، والموشومة بطابعها الحداثي المقلَد، التي لا تنتج إلا تخاذلا ولا تحرض فينا إلا تكرارا للأفكار المستوردة واجترارا للميتة منها، التي لا تغني شيئا، وإن جد لها الرجال الحوامل، وانبرى لها الطليعة من الثوار. ويا عجبي، كيف نقضي عمرا عزيزا، في عملنا الجمعوي وسعينا الاجتماعي وفعلنا الميداني، ثم نفضي بعد ذلك إلى سراب غزير، يطفئ شعلة الأمل في نفوسنا ويبث في المجتمع إيحاءات تولد اليأس والقنوط من كل ما هو منتظر، من تغيير، أو تحرر، أو تمكين، بل من موعود الله تعالى، حينما لا يرى تغييرا واضحا تثمره برامجنا الاجتماعية، أو زحفا بيّنا تحققه أهدافنا المجتمعية ، لنطرح بعد ذلك تساؤلات خجولة بيننا، " ألسنا ضائعين، عملنا عبث لا يجد وفقر لا يستغني وضلال لا يهتدي؟"1 فأين الخلل؟ سؤال لن يجيب عنه إلا كل مثقف متحرر من قيد الحاكم، وكل عالم مزايل لمجالس السلطان وكل مفكر بصمته بارزة في الميدان وكل شخص حوى الصدق بين جنبيه متأبطا وضوحا في كل الخطوات... وما أحوجنا لمثل هؤلاء الأكابر، حين يصيخون سمع قلوبهم وعقولهم لمن دونهم من الناس.
جئنا طارئين في ساحة متخمة بالأفكار ومقيدة بعوالق من وسائل وآليات تبهر الناظر منا إليها، وتغري فينا حب الاكتشاف الذي يولد تعلقا يكاد يكون أعمى، تعلقا بالشكل والحرف، دون إجبار العقل والفكر على معاودة طرح الأسئلة المبدئية التي تحوم حول الجوهر والمعنى، حول الغايات والمقاصد.
فبحماسة إيمانية وطأنا فضاءً يسمى مجتمعا مدنيا، بجمعياته وتعاونياته ووسائطه الاجتماعية، وتفاعلاته اللامتناهية، وقد استأنسنا ردها من الزمن لسيرورته وحركيته التي تغري فينا حب العمل وحب الخير والثواب، فأبدعنا في محاكات قوالب جاهزة من الجمعيات والمنظمات المستقلة، وأقنعنا أنفسنا أننا مناضلون مبدعون، نساهم من موقع عزيز، نخالط فيه الناس، تربية وتأطيرا وتواصلا وخدمة اجتماعية، وقلنا، هو واجب مرحلي قبل كل شئي، "ضنًا منا". دليلنا في ذلك، ثقافة مشاعة وقوانين مؤطرة وعرف مجتمعي تضبطه ثقافة المجتمع المدني "المتحضر". مجال مضبوط بعناية وضابط برعاية رسمية. حتى غدت جمعياتنا وفعلنا المجتمعي متماهيا بشكل غير مشروط مع مشاريع الاستكبار الانتكاسية، ضنا منا أننا نزحف إلى الأمام، في حين أن الزحف انطوى في ركن النسيان، حتى استقر في الأدهان أن الممارسة
الميدانية في الجمعيات والتعاونيات والعمل الاجتماعي هو المنتهى، هو غاية في حد ذاته، لا يلزمنا بعد ذلك السؤال عن الثمار والمآلات، عن القصد الصارم.
لذلك نجد أن الغالبية العظمى من المثقفين والسياسيين والأكاديميين، الذين يتطرقون لموضوعات المجتمع المدني، يتناولونه من منطلق الواقع المتخاذل، المنتكس بين يدي جلاده، وبمنطق لا يختلف كثيرا عما دأبت الأحزاب السياسية الخانعة تحدثنا به، من سعي نحو بناء ديمقراطي وتنمية حقيقية وإصلاح مجتمعي وشعارات مخادعة لا تنتهي... مجتمع مدني أريد له أن يكون خادما مطيعا لسياسات الدولة وبرامجها، مقيدا بمنهجية جبرية في التفكير والتنفيذ، تصطف خلفها كوكبة الجمعيات التائهة، بدون روح ولا وجهة ولا إرادة. ومنها للأسف جمعيات ومؤسسات مستقلة، صادقة في سعيها مجدة في برامجها، مطمحها متسام وذوا شأو عظيم ...، لكنها مسجونة ومسيجة في إطار معرفي وقانوني وعرفي ممخزن، نتائجها حتما ستكون خادمة لسياسات الاستبداد، وان بدت في ظاهرها خير، بل وإن جدت في بناء المساجد وطبع المصاحف كمن يرسم لوحات الأمل المزيفة في واقع مظلم ردي. فلا يكفي أن تكون صادقا في سعيك حتى تصيب الهدف.
إن كان الفاعل الجمعوي والتنموي والممارس الاجتماعي، يسعى في المجتمع دون أية قضية يحملها بين جنبيه، يعيش تفاصيلها في كيانه، ويجتر آلامها وآمالها، فلا معنى لسعيه. وإن كانت قضية الساعي والفاعل المجتمعي تختزل في طياتها الوهن ولا ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية في عمقها وقاصديتها وأفقها الاستشرافي، فلا أقل من معاودة التتلمذ بين يدي مدرسة المنهاج النبوي، التي تعلمنا أن "العمل الميداني إن لم يدخل في خطة محكمة لها وجهة مدروسة، وغاية معروفة، وأهداف مرحلية، وقسمة للمهام بين فئات جند الله، لن يؤدي لتأليف قوة التغيير المرجوة وإن انتهى إلى تكوين تكتل ذي حجم"2
فالحركات الاجتماعية التي تروم التغيير والمتطلعة لنهضة شاملة تقلب موازين القيم كما القوى، يلزمها خط ناظم يجمع شمل شتات الوسائل التنفيذية والاجرائية التي تضطلع في الغالب مؤسسات المجتمع المدني إلى تنزيلها. فغالبا ما تكون الرؤى التصورية ناضجة مكتملة في عمومها، واضحة قاصدة جلية، لا لبس فيها، غير أن الانتقال من مثالية التصورات إلى واقع التنفيذ في مجتمع متماهي ومتغير يجعل منطق تنزيل البرامج مدخولا بآليات تفكيرية تكاد تكون جبرية، تلزمنا بها عمق الاكراهات المجتمعية وجسارة التحديات وشساعة رقعة التنفيذ واختلال موازين المجتمع بحد ذاته، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... مما يجعل مستوى التنفيذ والأجرأة موشوما بنوع من العشوائية في تنزيل البرامج وشبه انعدام للفاعلية والأثر، إن قورن العمل الميداني المنجز بالجهد المبذول، مع المتطلبات والانتظارات التي لا تنقضي. مما يدفعنا إلى ضرورة إعادة صياغة خط ناظم منهاجي يربط الرؤى الكبرى والتصورات العامة حول
المجتمع المنشود، بآلية الوسائل التنفيدية التي تمثلها في الغالب جمعيات ومؤسسات مستقلة لم تكتسب بعد عمقا حضوريا وبعدا إحيائيا نهضويا في علاقتها الوسيطة بين الرؤية الكبرى والمجتمع.
إن لم تقدف في كيانات الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الوسيطة الاجتماعية روح من تلك الروح المنهاجية التغييرية التي تروم إحياء الأمة واستنهاض الهمم للمشاركة الفاعلة في مسار التغيير، وإن لم تزايل في سعيها مسار الخنوع السائد المتمثل في تجربة جمعوية مخترقة وموزعة في كل ربوع الوطن، فسمها ما شئت من كيانات استعراضية أو تنشيطية رخوية، فهي قطعا لم تنضج لداك المطمح الإحيائي والتغييري الغالي، وإن كثرت بهرجتها.