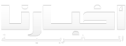متعلمون في أحضان "السليسيون"

عزيز لعويسي
قبل أيام، تم تداول شريط فيديو قصير، عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، يظهر فيه بعض التلاميذ القاصرين من ضمنهم تلميذات يلبسن وزرة مدرسية، منزوين بأحد الأمكنة، وهم بصدد تناول مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق (لصاق السليسيون)، وهذه الواقعة، التي كانت مدينة بني ملال مسرحا لها، بالقدر ما تثير مشاعر الصدمة والاستغراب وتحرك فضول السؤال، بالقدر ما يذوب جليد الصدمة والذهول، من منطلق أن ما وقع، ما هو إلا مرآة عاكسة لما يجري في عدد من الفضاءات المدرسية وفي محيطها، من تصرفات لاتربوية، يشكل بعضها أفعالا مخالفة للقانون ومعاقبا عليها بمقتضاه، في ظل غياب الضابط الأسري والوازع القيمي والأخلاقي، مرتبطة في مجملها باستهلاك مادة "الكيف" ، مرورا بمخدر "الشيرة" و"الكالة"، وانتهاء بالمعجون و"الشيشة" والخمر والسجائر..
تصرفات لاتربوية تتم في مجملها في محيط المؤسسات التعليمية أو في أمكنة أخرى، تمتد آثارها إلى الفضاءات المدرسية وداخل الحجرات الدراسية، وتفرز أشكالا أخرى من التصرفات، من قبيل عدم الانتباه وإثارة الشغب والفوضى وممارسة العنف والإقبال على الغش المدرسي وكثرة التغيبات عن الحصص الدراسية والحلاقات المثيرة للانتباه والسراويل الممزقة والتحوز بالهواتف النقالة ... وكلها تصرفات، لاتنعكس فقط على إيقاع وجودة التعلمات، بل وتضع المدرسين أمام حالات شاذة، تفرض عليهم حسن تدبيرها والتعامل معها، في ظل فراغ الساحة، من فاعلين مؤهلين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسبين.
- قراءة في الحالة :
مقطع فيديو قصير، يظهر تلاميذ قاصرين لايتجاوز سنهم 14 سنة على الأكثر، من ضمنهم تلميذات يرتدين وزرة مدرسية، منزوين بأحد الأمكنة، وهم بصدد استهلاك مخدر عبر الاستنشاق (السليسيون)، وهي واقعة وصفها الباحث "عبدالعزيز معناني" (باحث في قانون الأعمال والمقاولة) بالصدمة والمنزلق الخطير، من منطلق أن "التخدير" بلغ أدنى مستوياته، ويتعلق الأمر ب"التشمكير"، بشكل جعل التلاميذ – حسب تصوره - على قدم المساواة، مع المتشردين وأطفال الشوارع ومتسكعي المحطات الطرقية وبعض مرشحي الهجرة السرية بالموانئ، مستغربا في ذات الآن، من لجوء "الجنس اللطيف" إلى "السليسيون" كوسيلة منحطة، مقارنة مع أشكال أخرى من المخدرات "الناعمة" (قياسا للسليسيون) التي قد لا تثير الجدل أو الاشمئزاز، كما هو الحال بالنسبة للمعجون أو الشيشة أو السجائر، وإن كانت كل المخدرات ممنوعة ولا يمكن التطبيع معها بأي حال من الأحوال حسب قوله، وقد أوضح ذات الباحث، أن لجوء التلاميذ/الأطفال إلى "السليسيون" قد يفسر من منطلقين إثنين، أولهما: أنهم لم يرتموا في حضن "السليسيون"، ربما، بعد تجاوز مخدرات أخرى، ويبحثون على أعلى درجات النشوة، وثانيهما: أنهم قصدوا طريق "السليسبون" عن جهل للطريقة ولموقف المجتمع منه، كطريقة "منحطة" لايقبل بها المجتمع، بل لا يمكن أن يقبل بها، حتى من هو مدمن على مخدرات أخرى كالحشيش أو الشيرة أو الكالة أو الشيشة أو غيرها، أو تم التغرير بهم واقتناصهم من قبل مروجي المادة المذكورة.
لكن، وفي ظل غياب معطيات واقعية حول ظروف وملابسات الواقعة، يصعب الربط بين المخدرات ومنها "السليسيون" والفقر أو الهشاشة، من منطلق أن "المخدرات" تحضر حتى في الطبقات الميسورة، وفي هذا الإطار أكد المدير التربوي "عزيز بيض" أن "الأمر لا يقتصر على استهلاك "السليسيون" و"الكولا" باعتبارهما
مادتين رخيصتين، وفي متناول حشود كبيرة من المستهلكين، بل تسربت المخدرات القوية في صفوف التلاميذ الميسورين، وأضحت المدرسة هي المستهدفة الأولى من حيث عدد الزبائن".
أما "سعيد غازي" (أستاذ السلك الثانوي التأهيلي، باحث في التدبير الإداري)، فقد أفاد أن الواقعة تعد مظهرا من مظاهر تفسخ وانحلال الأسرة المغربية، ونوعا من "الانتحار البطئ"، موجها البوصلة، نحو بعض المنحرفين أو منعدمي الضمير، الذين لا يجدون حرجا ولا حياء في استهداف التلاميذ المراهقين بالممنوعات في محيط المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن ما يحدث بهذا المحيط، من ظواهر مشينة، من شأنه أن يساهم في تفشي ظاهرة العنف المدرسي داخل الفضاءات المدرسية، بشكل يحمل المزيد من المعاناة للمدرسين والإداريين.
مقابل ذلك، وفي تعليق له على الواقعة، أكد "أحمد بالمعروف" (أستاذ السلك التأهيلي بالتعليم الخصوصي) أن ما وقع يبقى "مجرد نماذج لمراهقينا، أكانوا تلاميذ أو غيرهم"، مضيفا أن "استفحال ظاهرة الإدمان، راجع إلى غياب دور الأسرة، ومعها حتى المنظومة التعليمية، في التربية على القيم، في ظل سيادة موجة تدعي أنها حقوقية، وتشجــع على أن تترك مساحة شاسعة لهذا المراهق للتعامل مع محيطه وحاجياته بكل حرية، واعتبار ما يقوم به شيء عادي بالمقارنة مع سنه".
الأستاذ "محمد المليح" (عضو المجلس الوطني للتضامن الجامعي المغربي والكاتب الإقليمي لفرع الحي الحسني)" أوضح أن"الحالة ليست مرتبطة بالتلاميذ، أكثر ما هي مرتبطة بالحالات الاجتماعية والأخلاقية"، مسترسلا أن "الكل سيتحدث عن المدرسة ومحيطها الذي مورست فيه هذه الوضعية، التي ترتبط – حسب تصوره- بالاستغلال البشع للمنظومة التربوية، وما تعانيه من هجمات شرسة، بينما هي (المدرسة) براء منها، مشددا على تحمل الجميع لمسؤوليته"، مضيفا أن" محيط الكثير من المؤسسات التعليمية، أصبح يعد سوقا رائجة للمنحرفين، الذين يستغلون الأطفال لترويج بضائعهم الممنوعة على اختلاف أنواعها".
أما الباحث "محمد وعيد" (باحث في قضايا الإعلام والهجرة بإيطاليا)، وفي أول تعليق له على شريط "الفيديو"، أكد أنه لا يمكن الحكم على الأطفال/التلاميذ في لحظة استهلاكهم للمخدر، دون الرجوع إلى حياتهم الأسرية، موضحا في هذا الصدد، أنه وفي أوربا عموما وإيطاليا على وجه التحديد، يتعاملون مع الطفل الذي يبلغ سنتين من العمر، وكأنه رجل، مفيدا أن الأطفال يتلقون الرعاية والاهتمام التربوي في مرحلة ما قبل التمدرس، بطرق وأساليب راقية وعالية الجودة.
- أية تداعيات :
القضية خلفت تداعيات متعددة الزوايا وأسالت لعاب الجدل والنقاش حول واقع حال التربية والتعليم، وأتاحت مساحات رحبة لمساءلة "مؤسسات التنشئة الاجتماعية" ومدى تحملها لأدوارها التربوية والتأطيرية وعلى رأسها "الأسرة" بدرجة أولى و"المدرسة" بدرجة ثانية، وقد وصل الصـــدى إلى قبة البرلمان عبر سؤال شفوي حول "ظاهرة تعاطي مخدر السليسيون من قبل التلاميذ" موجه إلى السيد وزير الداخلية من قبل أعضاء من الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة" بخصوص الإجراءات المتخذة، بهدف اجتثاث هذه الظاهرة من المؤسسات التعليمية ومحيطها، لما لها من تأثيرات مدمرة على صحة الإنسان، لأنها – كما ورد في السؤال – "تفقد الإنسان وعيه وتجعله عرضة لسلك طريق الضياع والانحراف"، وبما أن ما وقع له أثر أمني وقضائي، فقد تفاعلت ولاية أمن بني ملال مع الشريط، وأفادت في بلاغ سابق لها، أن دائرة الشرطة صاحبة الاختصاص الترابي،
قد فتحت بحثا معمقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الواقعة الموثقة بمقطع الفيديو، والتوصل إلى هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين فيها (المزود أو المزودون)،
- أية مسؤوليات ؟
دون الانغماس في الشق الأمني أو القانوني أو القضائي، ودون الانخراط في تفاصيل الصدى البرلماني أو السياسي، فما وقع في شريط تلاميذ "السليسيون" يفرض تحديد المسؤوليات، قبل الانخراط في تفاصيل الحلول وتدابير الوقاية، من منطلق أن الحل أو الحلول الناجعة، تتأسس على تشخيص أمثل وأنجع للأسباب المتحكمة في ظاهرة لا زالت في المهد، وهي مسؤوليات متعددة المستويات، تسائل بدرجة أولى ثلاث جهات، أولها "الأسرة"، ثانيها "المدرسة" وثالثها "الأمن".
-الأسرة : مجموعة من الأسر تراجعت أدوارها التربوية، إذ أصبح مفهوم التربية لذى الكثير من الآباء والأمهات، منحصرا في حدود توفير كل ما يحتاجه الطفل(ة)/ التلميذ(ة) من ملابس ومأكل ومصاريف ومستلزمات دراسية، وفي هذا الصدد، يظهر واقع الممارسة، أن الجسور التواصليه شبه مقطوعة بين الأسر والمؤسسات التعليمية، فلا الأسر تتبع وتواكب المسار الدراسي على مستوى الجدية والانضباط والتحصيل، ولا الإدارات التعليمية، قادرة على بناء علاقات تواصلية على الأقل بشكل دوري مع الأسر خاصة التي يعاني أبناؤها من مظاهر التعثر أو التهور أو العنف أو الانحراف، لأسباب موضوعية، مرتبطة بضعف الحصيص، وانعدام أطر الدعم النفسي والاجتماعي، وبالتالي، وفي ظل هذا الفراغ التواصلي، فالأسر أو مجملها، تجهل ما يفعله أبناؤها داخل المدرسة أو خارجها، وارتباطا بواقعة بني ملال، يمكن التساؤل: كيف لأطفال/ تلاميذ يتغيبون عن الحصص الدراسية ويتعاطون مخدر "السليسيون"، وآباؤهم وأمهاتهم لم ينتبهوا إلى تصرفاتهم ولا للرائحة المزعجة التي تفوح منهم، وهذا معناه، أن الكثير من الأسر تعيش على وقع التفكك والهشاشة وانعدام المسؤولية، مما يؤسس لبيئة آمنة لتهور الأبناء، وابتعادهم عن التعلمات وجنوحهم نحو منزلقات الإنحراف.
الأستاذة "م. ليلى" (أستاذة التعليم التأهيلي، ومؤسسة لنادي البيئة والتربية على القيم) أكدت أن "المدرسة ليست المتهم الوحيد، لأن التنشئة الأولى تبدأ من الأم ثم الأسرة والمجتمع" مفيدة أن "الكل قدم استقالته، لتبقى المدرسة المتهم الأوحد في الموضوع، لأنها تكشــف عن الاختلالات، والآباء انحصر دورهم ، في تسجيل أبنائهم، وتوفير اللوازم المدرسية، أي الالتزامات المادية فقط، وتم إغفال جانب أهم واخطر، وهو التربية والمتابعة" مضيفة أن " الأساتذة يعانون في صمت، وعدسة مصور الشريط، فضحت المستور، ورب ضارة نافعة" على حد قولها، وهو نفس التصور الذي حمله الأستاذ "عبدالرحيم آيت علي" (أستاذ السلك التأهيلي، طالب باحث بسلك الدكتوراه) الذي حمل المسؤولية للأسرة بنسبة 90 بالمائة، وما تبقى تتحمله باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وبالخصوص التعليم الذي فشل في تأدية دوره على حد قوله.
-المدرسة : كما تمت الإشارة إلى ذلك، فقنوات التواصل بين الإدارة التربوية، تبقى شبه غائبة لظروف موضوعية، مرتبطة أساسا بالخصاص المهول الذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية على مستوى الأطر الإدارية، خاصة على مستوى "الحراس العامون"، وفي ظل هذا الخصاص، يصعب رصد حالات التلاميذ الذين تظهر عليهم علامات العنف والانحراف والقيام بما تقتصيه من تدابير وإجراءات تربوية، وحتى في حالة رصد حالة من الحالات بشكل عرضي، يصعب التعامل معها أو مقاربتها تربويا، في ظل غياب تام للأطر الخاصة بالدعم النفسي والاجتماعي، يضـــاف إلى ذلك، افتقاد الكثير من المؤسسات التعليمية لبنيات الاستقبال الجذابة من قاعات أنشطة لائقة (إن وجدت، فغالبا ما تكون غير مفعلة)، وقاعات مطالعة وقاعات رياضية وغيرها، وفي هذا الصدد، في حالات
كثيرة قد يتغيب الأستاذ(ة) لسبب أو لآخر، ويتم إخراج التلاميذ من المؤسسة، بدل الاحتفاظ بهم في قاعات المطالعة مثلا أو إدماجهم في نشاط موازي، ويتم الزج بهم إلى الشارع، وهذا من شأنه تعريضهم للخطر، في حالات انعدام الأمن بالمحيط المدرسي.
-الأمن : بين "الأسرة" و"المدرسة" يحضر "الشارع العام" بكل ما يعتريه من مخاطر وتناقضات وانحرافات، وفي هذا المستوى، تثار مسؤولية مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي في تغطية هذا الشارع العام ومحاربة مختلف مظاهر الظواهر المشينة، في بعديها الوقائي(الشرطة الإدارية) والزجري(الشرطة القضائية)، وفي هذا الصدد، لامناص من التأكيد أنه وكلما كان الأمن حاضرا بالشارع العام (بما فيه المحيط المدرسي) كلما تراجع منسوب الجريمة، وكلما كان المحيط المدرسي مؤمنا والتلاميذ محصنين، ولما تحضر الفراغات الأمنية، يتم ملؤها من قبل بعض المتهورين والمنحرفين، الذين يجدون ضالتهم في محيط المؤسسات التعليمية، لتصريف تصرفاتهم الانحرافية والجرمية، وفي هذا افطار، أفاد الأستاذ "محمد العروسي" (أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة) أن "المجهود الأمني جيد، لكن يحتاج إلى مقاربات أخرى أكثر نجاعة" مضيفا أن "المسؤولية يتقاسمها الجميع، من مؤسسات الدولة والأسرة المغربية والأسرة" مؤكدا أن "معرفة الأسباب، تعد جزءا من الحل".
"نورالدين حوماري" (عضو المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي، ورئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي) أكد أن "الحل يقتضي مقاربة شمولية يتحمل فيها السياسيون والتربيون أدوارهم'' موضحا أن " المسألة نجمت عن قتل المدرسة العمومية والأسرة في تحمل مسؤوليتهما، فلم يعد للمدرسة دور في الترقي الاجتماعي، مما جعلها تفقد مكانتها الاعتبارية، كما أن "الأستاذ" - حسب تصوره- لم يعد يقوم بدور المربي كما كان في السابق، إذ أصبح يكتفي بتلقين المادة العلمية، دون التوجيه والتأطير التربوي"، مسترسلا في القول أن "أنشطة الجمعيات التربوية، أضحت موسمية، مما يترك فراغا لدى الناشئة، وهذا الفراغ يجعل التلاميذ عرضة لكل الأخطــار، مشير إلى أن "الأسرة تكاد تستقيل عن دورها الأساسي، وأن الوسائل السمعية البصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تنازع الكل في تربية الناشئة، لتغرس فيها قيما، لاعهدة لنا بها على حد قوله، ومن جهته، فقد الأستاذ "محمد المليح" أن "منظمة التضامن الجامعي المغربي" (الحضن التضامني والقانوني لأسرة التعليم) كانت ولازالت تهتم بالمدرسة العمومية وحمايتها، وجعلها موضوعا مجتمعيا، لأنها تهم الكل وتضم الجميع، ولايمكن –حسب تصوره- رميها أو لومها على التقصير، محملا المسؤولية للجميع".
- أية حلول وتدابير وقائية ؟
بخصوص تدابير الوقاية، فلابد أن تمر قطعا عبر "الأسرة" التي لابد أن تتحمل مسؤولياتها التربوية، وما تقتضيه من مواكبة وتتبع، وربط لجسور التواصل مع المؤسسات التعليمية، لتتبع المسار المدرسي لأبنائها ومستوى تحصيلهم ودرجة انضباطهم، مع استثمار المعطيات التي تتيحها "منظومة التدبير المدرسي "(مسار)، في تتبع المسار الدراسي لأبنائها، خاصة على مستوى التعرف على النقط والمعدلات المحصل عليها والمواظبة والسلوك وغيرها، بشكل يتيح الإمكانية للتتبع عن بعد، واتخاذ ما يقتضيه أي إخلال أو تعثر من تدخلات مستعجلة، ونذكر أن التربية ليست فقط تغطية مصاريف التمدرس والدعم وتلبية حاجيات المأكل والملبس، بل هي مواكبة مستدامة للطفل تربويا وتعليميا، في ظل أسر مستقرة، بعيدة عن كل أشكال التفكك واللامبالاة.
بخصوص "الأسرة"، فقد أوضحت الأستاذة "م. ليلى" أنه يجب" إعادة الاعتبــار لمؤسسة الزواج، والحرص على أن يكون المشتل، صالحا لإنجاب وتربية الأبناء، وخلق جيل غير معطوب" موضحة في هذا الصدد، أن "الأجهزة الأمنية لابد لها أن تقوم بدورها في محيط المؤسسات التعليمية، والحرص على خلق أيام تواصلية مع الآباء، ورصد
الحالات الشاذة ومناقشة الموضـوع مع أولياء الأمور، وإبلاغ الأمن، إن اقتضى الأمر ذلك"، أما "سعاد محبوبي" (حاملة لشهادة الإجازة الأساسية، تخصص علم الاجتماع)، فقد وجهت بدورها البوصلة، نحو "الأسرة" بدرجة أولى، مؤكدة أن "التنشئة الاجتماعية" إذا لم تكن متوازنة وسليمة، فهي تنعكــــس سلبا على تربية وتصرفات الأطفال".
أما "المدرسة" فهي البيت الثاني للطفل، ولامناص اليوم، من إعادة النظر في العديد من المؤسسات التعليمية على مستوى بنيات الاستقبال، لتكون فضاءات مفعمة بالجاذبية والحياة، ولم لا، التفكير في بناء جيل جديد من المؤسسات التعليمية بمواصفات معمارية عصرية، تراعي الأبعاد الجمالية والفنية والتجهيزية، والرهان على البنيات، ما هو إلا إنتاج بيئة سليمة، لإعادة الحياة إلى "الحياة المدرسية" عبر الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية، بشكل يتيح الإمكانية أمام التلاميذ للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الرياضية والإبداعية والمهارية، والرهان على "الحياة المدرسية" لا يمكنه أن يحقق الأهداف المأمولة، في غياب شروط الدعم والتحفيز للأساتذة، ودون إعادة النظر في المناهج والبرامج الدراسية الغارقة في أوحال الكم، المكرس للضعف والهوان والرتابة، وفي هذا الصدد، أحيانا يدرس التلاميذ ثمان ساعات في اليوم (صباحا ومساء)، وفي هذا الواقع، كيف يمكن الحديث عن حياة مدرسية أو أنشطة موازية، وفي حالات كثيرة، يتم حرمان التلاميذ من حصة دراسية، من أجل إشراكهم في أنشطة تربوية موازية، وهو وضع غير صحي، يقتضي التعجيل بتخفيف الضغط عن التلاميذ والأساتذة على حد سواء، وتوفير حيز زمني، يسمح بإرساء منظومة واضحة المعالم للأنشطة الموازية، بعيدا عن مفردات "الارتباك"، بل أكثر من ذلك، يظهر واقع الممارسة، أن التلاميذ يرهقون بكثرة المواد وكثرة الذهاب والإياب، وتزاد مشاقهم في مواعيد المراقبة المستمرة، مما يجعل التخفيف من كم البرامج، أمرا مستعجلا، وإلا سنظل نصنع الضعف ونكرس الهوان عن قصد أو بدونه.
بخصوص "الأندية التربوية"، فقد أوضحت الأستاذة " م. ليلى" أن "عمل الأندية التربوية يبقى ناجعا، رغم ضعف وغياب الإمكانيات، لكن إذا كان المحرك هو "مواطن" صادق ويؤلمه وضع هؤلاء التلاميذ/ الضحايا، فإن النتيجة ستكون إيجابية"، مسترسلة أنه "في كثير من المؤسسات التعليمية، تبقى الأندية حبرا على ورق"، مقابل ذلك، فقد شددت "سعاد محبوبي" المتخصصة في علم الاجتماع، على "ضرورة وضع أطر اجتماعية بجميع المؤسسات التعليمية، لرصد وتتبع ومواكبة سلوكات وتصرفات التلاميذ، الذين تبدو عليهم مظاهر التهور أو العنف أو التعثر أو العزلة، من أجل التدخل والقيام بما تفرضه كل حالة من إجراءات وتدابير"، مقابل ذلك، أوضحت الطالبة "سعيدة محبوبي" (طالبة بسلك الإجازة، تخصص علم النفس) أن تصرفات وسلوكات التلاميذ/ الأطفال، يمكن أن يفسر بطريقة تربية الوالدان لأبنائهم (قمع، عنف ...) موضحة، أن انعدام أو ضعف التواصل مع الأبناء، قد يؤدي إلى القمع مرورا بالكبث وانتهاء بالعنف، وقد وجهت البوصلة، نحو البيئة (المحيط الأسري والعائلي) وتأثيرها السلبي أو الإيجابي على تصرفات الطفل، شأنها في ذلك، شأن "رفاق السوء" ، محملة المسؤولية إلى الدولة وإلى المؤسسات المعنية بالطفولة والشباب، في ظل ضعف ومحدودية الفضاءات الرياضية والثقافية، التي تسمح للأطفال والشباب، بتفريغ ما يختزنونه من مواهب وطاقات وقدرات.
أما "الأمن" فمسؤوليته قائمة فيما يتعلق بتأمين محيط المؤسسات المدرسية، وهذا يقتضي تفعيل أدوار "الشرطة المدرسية" وتمكينها من من الموارد البشرية ووسائل العمل، بشكل يسمح بتأمين وتغطية محيط المؤسسات التعليمية ومحاربة كل الظواهر المشينة التي من شأنها تهديد الناشئة، مع تفعيل القنوات التواصلية بين الإدارة التربوية والشرطة، علما أن الدور الأمني (شرطة أو درك)، لابد أن يرتقي إلى المستوى التأطيري، عبر تقديم عروض ومحاضرات داخل المؤسسات التعليمية لتأطير التلاميذ، وتنمية ثقافتهم الأمنية والقانونية، وتوعيتهم بما قد يصدر عنهم من تصرفات مخالفة للقانون ومعاقب عليها بمقتضاه.
ارتباطا بالشق الأمني، ألح الأستاذ "محمد المليح" على فكرة إحداث "شرطة مدرسية" لتنقية المحيط المدرسي من مروجي المخدرات والتحرش الجنسي وكل الظواهر السلبية" مؤكدا في ذات السياق أن "التضامن الجامعي المغربي" كان له على الدوام، اهتمام بالمدرسة العمومية وحمايتها، وجعلها موضوعا مجتمعيا، لأنها تهم الكل وتضم الجميع"، مفيدا أنه "لا يمكن رمي هذه المدرسة العمومية أو توجيه اللوم لها، من منطلق أن المسؤولية يتحملها الجميع كل من موقعه"، ومن جهته، فقد أكد "عزيز بيض" (مدير تربوي) أنه "لابد من وضع استراتيجية وطنية للأمن المدرسي، وتشديد العقوبات على كل تجار المخدرات، الذين يستهدفون المدرسة وروادها، باعتبار هذه الأفعال الجرمية، جنايات تدخل في إطار الاتجار في البشر".
الأستاذ "أحمد بالمعروف" أكد أن "تقويم الانحرافات، يجب أن يغيب فيه الزجر، وألا تخرج عن دائرة تقديم النصح والمصاحبة النفسية"، وهو نفس التصور الذي أثاره الإطار والباحث "عبدالعزيز معناني"، إذ أكد على ضرورة إخضاع "تلاميذ السليسيون" القاصري السن،إلى جلسات استماع يشرف عليها أخصائيون في الدعم النفسي والاجتماعي من أجل تشخيص أمثل لظاهرة شاذة حالها اليوم كحال الصبي في المهد، من أجل فهم واستيعاب الظروف الحقيقية التي دفعت تلاميذ/أطفال، يتركون القلم والكتاب والتحصيل، ويرتمون بسلاسة في حضن "السليسيون" بما يعكسه من انحطاط وبشاعة واشمئزاز، وقبل هذا وذاك، من أجل استعجال إنقاذ التلاميذ من منزلقات الانحراف والجريمة والهدر المدرسي، في وقت تبدل فيه مجهودات رسمية، لدعم التمدرس ومحو الأمية وتعميم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
في إطار التجارب التعليمية المقارنة، وفي محاولة للتوصل إلى معطيات أخرى من شأنها تنوير الرؤية، فقد تم الاتصال بالإطار المغربي بالديار الألمانية "حميد دمشقي" (أستاذ اللغة الألمانية والتربية الإسلامية بعدد من المؤسسات التعليمية بألمانيا)، وأوضح بعد اطلاعه على "الشريط"، أن كل مدرسة ألمانية تتوفر على إطار دعم اجتماعي من خريجي الجامعات، يشتغل تحت مسؤوليته (من ثلاثة إلى أربعة عناصر من خريجي التكوين المهني متخصصين بدورهم في الحقل الاجتماعي) في علاقة بين الأستاذ والإدارة، مضيفا أنه وفي حالة ما إذا عاين الأستاذ على تلميذ ما، بعض مظاهر العزلة أو الشغب أو العنف، يستعين بالمؤطر الاجتماعي الذي يتولى مراقبة وتتبع ومواكبة التلميذ المعني داخل القسم أو في الساحة، ومن خلال الإستشارة مع الأستاذ الخاص والإدارة، إذا لاحظ المؤطر أن التلميذ يعاني من مشكل نفسي، يعمل على إحالته على طبيب نفساني يتواجد رهن إشارة عدد من المدارس".
مضيفا أنه، إذا ثبت أن التلميذ قد وصل إلى درجة من الانحراف، تتم إحالته على مدارس أخرى متخصصة في حالات العنف، وبالنسبة للمتهورين، كل الأساتذة بشكل جماعي يساهمون في الحل بمن فيهم الأستاذ الخاص، مؤكدا، أن المؤسسات التعليمية التي يشتغل بها، تنظم أنشطة تربوية متعددة طيلة السنة (رياضية، مسرحية، موسيقية ..) كما تنظم خرجات كثيرة لفائدة التلاميذ لها علاقة بالبرنامج التعليمي، وأفاد أن هناك شراكة بين الأساتذة، تسمح بالقيام بدروس جماعية لفائدة الأقسام من نفس المستوى، يؤذن للتلاميذ فيها بإحضار أكلهم، مشيرا إلى أن الهدف، هو القطع من الروتين والرتابة، وخلق أجواء تعليمية أخرى، الهدف منها تحفيز وتمكين التلميذ(ة) من فهم واستيعاب الدرس.
قبل الختم، نشير أن "تلاميذ السليسيون" كشفوا عن سوءة الحقيقة المرة التي تعيش بين ظهرانينا ولا أحد يحرك ساكنا، أطفال في عمر الزهور بعضهم يعيش على التشرد في الشوارع والساحات، وبعضهم الثاني يقاسي ألم الهشاشة والحرمان داخل أسر مفككة، وبعضهم الثالث غادر المدرسة قسرا، تحت ضغط الفقر والإقصاء، وبعضهم الرابع وقع في حضن الجريمة والانحراف (السليسيون، المخدرات، الدعارة، الشدود الجنسي ...إلخ)، تصرفات
وأخرى، أنتجها المجتمع بما يعتريه من مشكلات وتناقضات، وفي ظل فشل أو تراجع أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية (أسرة، مجتمع مدني، دور الشباب والرياضة، أحزاب سياسية، إعلام ..)، تتحمل "المدرسة" وزر الأعطاب المجتمعية، عبر سلوكات لا تربوية عاكسة للواقع الذي أنتجها، من قبيل العنف والغش المدرسيين والإدمان على المخدرات من قبيل الكيف، السليسيون، المعجون، الكالة والشيشة وغيرها.
استقراء لما تم استعراضه من وجهات نظر، يتبين أن الرؤى والمواقف المعبر عنها، وإن اختلفت اتجاهاتها ومرجعياتها، فقد تقاطعت جميعها في مساءلة مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها "الأسرة" و"المدرسة" و"الإعلام"، وفي توجيه البوصلة نحو "الأمن" والمجتمع والدولة، وكلها مؤسسات وأجهزة، تتحمل بدرجات ومستويات مختلفة، مسؤولية ارتماء تلاميذ في عمر الزهور في أحضان مخدر " السلسيون" بدل الارتماء في أحضان الدراسة والمثابرة والتحصيل، في وقت نعيش فيه زمن "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين" و"القانون الإطار" الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهــر.
وبما أن ما حدث، يسائل الدولة (الوزارة الوصية) فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي والنفسي وبنيات الاستقبال والحياة المدرسية (في إطار ما للمدرسة من مسؤوليات)، فقد كان من الضروري، اللجوء إلى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يعول عليه، من أجل تصحيح ما يعتري المنظومة التعليمية من مشكلات وإكراهات بادية للعيان، واستقراء لمواده ومقتضياته، أمكن الوقوف عند مجموعة من التدابير التي من شأنها الارتقاء ببنيات الاستقبال وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي والنفسي للتلاميذ وللأسر المعوزة، وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة 20 على سبيل المثال لا الحصر، على تعميم التعليم الإلزامي، بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، عبر اتخاذ تدابير متعددة المستويات منها :
- تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي.
- تعميم تمدرس الفتيات بالبوادي، وتعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.
- تفعيل دور جمعيات المجتمع المهتمة بالشأن التربوي، ولاسيما "جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ" في توثيق وتوسيع الصلات بين فضاءات التمدرس والأسر من أجل مواظبة المتعلمين على الدراسة.
- تعزيز وتعميم برامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط، للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم.
- سد الخصاص (خلال أجل 6 سنوات) الحاصل في عدد من المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالأطر التربوية والإدارية الكافية، وبالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة.
- العمل على إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، تشرف عليها أطر متخصصة، بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بشراكة مع مختلف الفاعلين وشركاء المنظومة، وتعميمها على الصعيد الوطني (خلال أجل لايتعدى 3 سنوات).
- تعزيز عروض التكوينات المقدمة وتنويعها وتحسين جودتها، وضع برامج للتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، قصد الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة، وضمان متابعة مسارهم الدراسي ...
أما المادة 21 ، فقد نصت على الدعم الاجتماعي على مستوى خدمات الإيواء والإطعام والتغطية الصحية للمتعلمين (غير المستفيدين من أي نظام آخر)، وإرساء نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين، الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة، فيما أكدت المادة 3 على توسيع نطاق تطبيق التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين، من ذوي الاحتياج، قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية، تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة.
وهي تدابير وإجراءات، لا يمكن إصدار أي حكم بشأنها، طالما أن "القانون الإطار" لايزال في طور التنزيل، وبالقدر ما يمكن تثمينها، بالقدر ما نأمل أن نتلمس آثارها ونتائجها على المدرسة العمومية، التي ضاقت ذرعا من سياسة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، لكننا، نؤكد مجددا، أن كسب رهانات الإصلاح المأمول، يقتضي النهوض بأوضاع "الشغيلة التعليمية" وإعادة الاعتبار إليها، بشكل يضمن التحفيز والانخراط الإيجابي في دينامية الإصـلاح.
وعليه، وفي ظل هذا الواقع التربوي المقلق، وقياسا لما أضحى يعرفه المجتمع من مظاهر العبث والتهور وعدم الإحساس بالمسؤولية ومن ضعف في منسوب المواطنة والقيم، لا يسعنا إلا أن ندق ناقوس الخطر، والتخوف من المستقبل، في ظل تواجد شرائح عريضة من الأطفال والشباب، خارج نسق التربية والتكوين، ونؤكد في خاتمة التحقيق، أن الحضن "أحضان" .. هناك من يرتمي في "حضن السليسيون"، وهناك من يرتمي في حضن "الإدمان"، وهناك من يفنى في "حضن التشرد والإقصاء والدعارة والشدود الجنسي"، وهناك من يقبل بكل هستيريا على "حضن قوارب الموت"، وهناك من يذوب في "حضن الإجرام".
وقبل وضع نقطة النهاية، نؤكد أن التربية ليست فقط حكرا على الأسرة والمدرسة، هي مسؤولية مجتمع ومسؤولية دولة، وأي إخلال أو تهاون أو تقصير، لن يكون إلا إسهاما جماعيا في صناعة أجيال معاقة معرفيا ومشلولة قيميا وأخلاقيا، ولأمهات وأباء وأولياء التلاميذ، نوجه رسالة واضحة المضامين مفادها : خذوا العبرة من "تلاميذ السليسيون" واحرصوا على مراقبة أبنائكم ومواكبتهم دراسيا، فالتربية ليست فقط مأكل ومشرب وملبس، هي مسؤولية وأمانة.
ونختم بالقول، بأن "المدرسة العمومية" مهما قيل ويقال في حقها، هي أيضــا فضاء لإنتاج التميز والتألق والإبداع، ويكفي استحضار مجموعة من التلاميذ المغاربة الذين تألقوا وتميزوا خارج الوطن في السنوات الأخيرة، في مسابقات دولية من قبيل "أولمبياد الرياضيات" و "الحساب الذهني" ومسابقة "تحدي القراءة العربي " مع التلميذة المتميزة "مريم أمجون" (بطلة نسخة 2018) و التلميذة "فاطمة الزهراء أخيار" التي عبرت بامتياز إلى الأطوار النهائية للمسابقة (نسخة 2019)، على أمل أن نكسب جماعيا رهان "مدرسة عمومية" جذابة، تتيح فرصا للتميز والخلق والإبداع والجمال، وتقطع بشكل لارجعة فيه مع مشاهد التهور والعنف والانحطاط ..