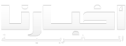في مآزق التعليم عن بعد

عبد الإله تنافعت
بدأت قضية التعليم عن بعد تشغل حيزا كبيرا في اهتمام الفاعلين التربويين منذ زمن ليس بالقصير، ولا سيما في ضوء تطور وسائل التواصل وما تتيحه من إمكانيات كبيرة على مستوى تقريب المسافات بين الناس، وتجاوز عقبات الحدود التي كانت تحول - فيما مضى- دون تحقيق التواصل ونقل المعارف والأفكار بين الناس، وقد ازداد الاهتمام بهذه المسألة وتسارع تطبيقها مع بروز جائحة كورونا التي فرضت على معظم سكان العالم حظرا تواصليا مباشرا وحجرا صحيا، مما استدعى تجنيد رجالات التعليم ونسائه من أجل تنزيل هذا النمط من التعليم في كل الأسلاك التعليمية.
وتجدر الإشارة الى أن إنتاج المضامين الرقمية في العالم ككل أصبح تجارة قائمة الذات من خلال ما يتم بيعه من معلومات في مختلف مجالات المعرفة، ولا يختلف الأمر كثيرا في المغرب، فمنذ مدة ظهرت العديد من المواقع التي تعنى بالشأن التعليمي من خلال تقديم الدروس والتمارين والحلول للتلاميذ باعتماد مختلف الوسائل التواصلية الحديثة، كما سارع عدد من الاساتذة الى إنشاء مواقع خاصة بهم يتم فيها تقديم الدروس المتعلقة بتخصصهم بمختلف الأشكال: المكتوبة أو المسجلة بالصوت والصورة أو بالصوت وحده، ولا ننسى كذلك ما قامت به الوزارة من تسجيل الدروس في أقسام تعليمية مصغرة وبثها على قناة الرابعة، رغم أن ظروف تلك المبادرة تختلف كثيرا عن الظروف الحالية.
وبالعودة الى الفترة الحالية التي توقفت فيها الدراسة، وما رافق ذلك من دعوات للأساتذة من قبل الوزارة الوصية بغية إنتاج مضامين رقمية، سواء بشكل فردي، أو تحت إشراف أطر المراقبة التربوية، تناسلت العديد من الإنتاجات التي تختلف جودة وعمقا، ما بين المكتوب والمنسوخ والمصور. وفي هذا الصدد ظهرت مجموعة من المآزق التي سأحاول قصرها على ما يتعلق بالرؤية والأهداف من التعليم، وسأحصر هذه المناقشة في المواد الأدبية دون غيرها. علما أن
مأزق التواصل عن بعد يأخذ اتجاهين أساسيين: اتجاه عمودي يتعلق بكل سلك على حدة: الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والجامعي، واتجاه أفقي يتعلق بالمواد داخل نفس السلك؛ اللغات والعلوم الانسانية، المواد العلمية، المواد القانونية والاقتصادية، فضلا عن مواد التفتح بالنسبة للتعليم الابتدائي، دون الخوض في التحديات والإشكالات التقنية المرتبط بمدى تغطية شبكات الاتصال لكل مناطق المغرب وسرعة الصبيب، وأيضا دون الخوض في الإكراهات المالية المتعلقة بقدرة كل أسرة على توفير ما تحتاجه هذه الخدمة من هواتف ذكية أو لوحات إلكترونية.
وبالعودة الى السلك التأهيلي وتحديدا ما يرتبط باللغات وما يقاربها من علوم إنسانية قد رأينا في خضم الاستجابة الفورية غير المتمحصة عددا من الإنتاجات التي كان يراد بها تعويض الساعات والأيام التي توقفت فيها الدراسة، وقد تراوحت هذه الإنتاجات بين وضع ملخصات الدروس والإجابة عن أسئلة الفروض والامتحانات الجهوية والوطنية، بل وصل الأمر ببعضهم في غمرة الاندفاع إلى تصوير نماذج من جذاذات تتضمن مراحل إنجاز الدرس ومضمونه. وهنا لابد من التمييز بين المضامين الرقمية التي تستثمر التقنيات المعلوماتية الحديثة على مستوى إنتاج المضامين وإرسالها للمتلقي، وبين المضامين غير الرقمية أو شبه الرقمية التي تستثمر وسائل الإنتاج الحديثة فقط في الإرسال، دون بقية الإمكانية الأخرى المتاحة، وهنا يمكن إدراج كل الإنتاجات التي تعتمد الكتابة فقط مثل الملخصات، وجدير بالذكر أن المضامين الرقمية تمتاز بإمكانيات هائلة، تتجاوز طاقتها التأثيرية ما تقدمه المضامين التقليدية، لكنهما يلتقيان في مخاطبة المتلقي عن بعد. وسأحاول تحديد مجموع المآزق المرتبطة بالتواصل عن بعد من خلال هذه الإنتاجات والمضامين المعرفية.
أولا: مأزق غياب الهدف: قبل إنتاج أي محتوى تعليمي يكون من اللازم تحديد الهدف المراد تحقيقه، ونقصد بالهدف ما هو مسطر في دليل الأستاذ والمذكرات الوزارية. والمتتبع لكثير من تلك الإنتاجات يكتشف دون عناء أنها غير محددة الأهداف، وأكثر الأمثلة إيلاما هي وضع ملخصات للدروس، وهو ما يشكل تناقضا صارخا يصادم ما تسعى المنظومة التربوية إلى
تحقيقه من أهداف تتعلق بتمكين التلميذ من آليات ومهارات التلخيص، وهناك مذكرات تنص صراحة على عدم إملاء الملخصات الجاهزة على التلاميذ، وهذا النمط من الإنجازات يرتبط أساسا بمواد التاريخ والجغرافيا ومادة التربية الإسلامية وأيضا بمكون المؤلفات في اللغة العربية واللغة الفرنسية. ومما يكشف أيضا غياب الهدف في هذه الملخصات أو تواريه خلف اعتبارات أخرى هو أنها تغتال لدى المتعلم مهارتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمهارة القراءة والفهم، والثانية تتعلق بالإبداع، حيث تعمل هذه الملخصات على تنميط المتعلم ضمن قوالب لغوية مسكوكة وجاهزة، ويتعقد الأمر في الدرس الفلسفي الذي يتم إفراغه من كل أهدافه القائمة بالأساس على تنمية الحس النقدي لدى المتعلم، وخلافا لهذا الهدف المقرر تكرس هذه الأعمال فكرة الحفظ التي تتناقض جملة وتفصيلا مع منطق الفلسفة ذات النزعة الدائمة نحو التساؤل والنقد.
وبالانتقال إلى مادة التاريخ والجغرافيا، وهي مادة تسعى جاهدة الى التخلص من تهمة الحفظ التي ارتبطت بها لسنوات طويلة، وحولتها الى معطيات إحصائية وأحداث تاريخية قارة تفتقد لروح القراءة التي لا تتحقق إلا من خلال مهارة المقارنة والاستنتاج والتحليل، فإن هذه الملخصات تكرس هذا النهج القائم على الحفظ والاسترجاع، لكنها حتما تجتث الأهداف المسطرة لهذه المادة ومنها ما سبق ذكره.
قد يكون للحفظ ما يبرره في مادة التربية الإسلامية وخاصة في النص القرآني والحديثي وهما نصان لا يحتملان التصرف في مضمونهما، مع إمكانية التصرف نسبيا في النص الحديثي. لكن الملخصات حتى في هذه المادة تناقض باقي الأهداف المحددة ومنها القدرة على الفهم والاستنتاج والمقارنة والتقويم.
وقريبا من الملخصات ما يقدم عليه بعض الأساتذة من إعادة إخراج للدروس في حلة جديدة لا تختلف كثيرا عما هو موجود أصلا في الكتب المدرسية ونضرب هنا مثالا بمكون الدرس اللغوي ومكون التعبير والإنشاء، هذا الأخير الذي يتم إفراغه تماما من كل أهدافه المتمثلة
بالأساس في تمكين المتعلم من مجموعة من المهارات التي لا تكتسب إلا من خلال التطبيق والإنتاج. وبالتالي فإن ما يقوم به البعض لا يخرج عن كونه مجرد محاكاة للكتاب المدرسي بإخراج آخر يكون أحيانا أقل جودة. ربما كان من باب الاقتصاد إحالة المتعلم مباشرة على الكتاب المدرسي.
ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يتعلق بمكون الدرس اللغوي الذي لا يكتمل ولا تحقق أهدافه ما لم يسند بالتطبيق المرحلي والكلي، ولا أرى أن تدوين أمثلة وتلوين الظاهرة بألوان مختلفة واستنتاج القاعدة أو الخلاصة، وأحيانا الإجابة عن أسئلة التطبيق يفي بالغرض ويحقق الهدف المطلوب في غياب التقويم المرحلي الذي يرافق عملية الشرح، وهو بمثابة المقياس الحقيقي الذي يقيس نسبة الفهم لدى المتعلم، ويوجه المعلم إلى مواطن النقص لدى المتعلم من أجل ترميمها. فلا وجود لدرس لغوي من غير تقويم، ولا تقويم في غياب تفاعل مباشر مع المتعلم. وما تم تقريره بالنسبة لمادة اللغة العربية ينسحب أيضا على اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وإن بنسب متفاوتة، ذلك أن مادة اللغة الفرنسية تتضمن هي الأخرى مكون المؤلفات، بينما مادة اللغة الإنجليزية تستثنى من هذا المكون. وفضلا عن أزمة التلخيص الذي تنتهجه جل إنجازات الأساتذة. نتحدث كذلك عن ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية، وهو إجراء يضرب اللغة في الصميم، لأن اللغة ليست مجرد ألفاظ بل هي قبل كل ذلك منطق في التفكير، وبصرف النظر عن مسألة الترجمة التي تبقى أقل الإجراءات انتشارا في أعمال الأساتذة، فإن تلخيص اللغة على شكل قواعد ثابتة تفتقد للمنطق التداولي الذي يكسبها دلالتها السياقية المناسبة، وتلك واحدة من أهم أهداف الدرس اللغوي، إجراء فيه انحراف عن الأهداف والغايات المسطرة.
ومن المكونات أيضا التي نالت حظها من التأزيم المعرفي الناتج عن غياب الرؤية والروية، نتحدث هنا عن مكون النصوص وهو من أهم المكونات التي تفرد لها أكثر من حصة في الأسبوع، الشيء الذي يؤكد على أهمية هذا المكون، وأهميته تتأتى ببساطة من كونه يشمل تلك المكونات، والحديث هنا بالخصوص عن الدرس اللغوي والتعبير والانشاء، فهدان المكونان
يتخذان من درس النصوص منطلقا لبناء بقية العمليات التعليمية، ويستثمران مضامينه، وبالرغم من أهمية هذا المكون فإن التعاطي معه وفق هذه الاستراتيجية الجديدة، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالبيداغوجيا الرقمية، مال به بعيدا عن أهدافه المسطرة، إذ تحول في خضم هذا النمط المستجد للتعليم إلى جزر مستقلة، أقصد النص المقروء، تفتقد إلى روح التماسك هاجسها الأوحد هو احترام مراحل القراءة المنهجية: ملاحظة وفرضية، ثم فهم وتحديد الأجزاء واستخلاص الخصائص، ثم تركيب، من غير إدراك أن تلك المراحل هي فرضية من بين فرضيات أخرى محتملة، وأن النص هو الذي يفرض نوع القراءة وليس العكس، وأن دور الأستاذ يقتصر على أسئلة موجهة مع تقويم التعلمات. بمعنى آخر ماذا نقدم التلميذ عندما نضع نصا محللا بين يديه؟ هل نقدم له معرفة جاهزة أي محتوى نص، وعلى أي أساس، أم طريقة منهجية؟ وما الفائدة منها؟ ونختم هذه النقطة بالقول إن المطلوب هو تمكين التلميذ من آليات التحليل وليس وضع نص محلل بين يديه، كما أن ما ينجزه الأساتذة من أعمال هو في واقع الأمر ما ينبغي للتلميذ القيام به، أعني صياغة الملخصات وتحليل النصوص والإجابة عن أسئلة التطبيق، وأن دور الأستاذ هو الإشراف على إنجاز هذه التعلمات وتوجيها وتقويمها.
ثانيا: مأزق الأحادية في بناء الدرس: منذ مدة كانت الدعوة إلى الابتعاد عن التعليم العمودي وتعويضه بالتعليم الأفقي، وتم التشهير بالنمط الأول باعتباره يحول التلميذ الى مجرد متلق أو بعبارة أخرى إلى منفعل بدل أن يكون فاعلا، وتمت الدعوة من خلال المذكرات واللقاءات التربوية إلى ضرورة إشراك المتعلم في بناء الدرس، والتأكيد على هذا الإجراء الذي شكل قطيعة مع بيداغوجيا الأهداف. ولا يجهل أحد أن التعليم عن بعد هو تعليم أحادي الجانب يتكفل فيه المعلم بإنجاز الدرس وبنائه من ألفه إلى يائه، لا دخل للمتعلم في ذلك. فهل نحن إذن أمام نكوص بيداغوجي.
على أنه في هذه النقطة تحديدا يمكن أن نميز بين صنفين من الإنجازات:
الأولى هي الإنتاجات الرقمية التي تعتمد الكتابة فقط، وفي هذه الحالة يغيب طرفي العملية
التواصلية، أي المعلم والمتعلم ولا تحضر إلا الرسالة، فتكون النتيجة في النهاية هي وضع التلميذ أمام الكتاب من جديد بدون وسيط أو ناقل ديداكتيكي. وبالتالي تعود الوضعية التعليمية إلى نقطة الصفر.
الثانية وهي الإنتاجات الرقمية المصورة، وهذه تحقق تواصلا من طرف واحد يفتقد الى رجع الصدى الفوري الذي لا يعبر عنه فقط بالكلام كما قد يتوهم البعض، بل إنه يتخذ أشكالا متعددة، منها: النظرة، السكون، إماءة الرأس، الحركات المعبرة عن الضجر أو الاستغراب… ورغم تطور وسائل التواصل فإنه من الصعب التقاط تلك الإشارات التي تقوم بدور محوري في بناء الدرس ولو بشكل غير مباشر.
ثالثا: مأزق التقويم: فلو أنا سلمنا بجدوى التعليم عن بعد وفق الإمكانات المتاحة في الوقت الحالي فهل سيواكب ذلك تقويم عن بعد أم أن الأمر سيقتصر على المدخلات دون المخرجات؟ وهنا يظهر سؤال آخر وهو: وفق أية آليات أو طرق سيتم تقويم تعلمات المتعلم في حال متابعته الدروس عن بعد؟ هل وفق الطرق التقليدية المستندة في حيز كبير منها الى الحفظ، أم وفق الطرق الحديثة التي تراعي القدرات الأخرى: التحليل والتركيب والتقويم؟ وهي قدرات لا تتحقق من خلال الملخصات الجاهزة والدروس الأحادية الجانب. إن التحدي الأكبر هو في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه. كيف سيتم التعامل مع التقويم هل سنشاهد تقويما عن بعد وبأي طرق؟ وما مدى مصداقيته في ظل واقع الغش والتدليس.
قد يكون لكل هذه المزالق والمآزق ما يفسرها في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم حاليا، ومحاوله كل القطاعات استدراك ما يمكن استدراكه بما فيها قطاع التعليم، وهو قطع حساس، وحساسيته تتأتى من عدة اعتبارات، أهمها أنه مرهون بمدى زمني محدد، وهو ما يطرح صعوبة على مستوى تعويض الزمن المهدور منه، على عكس بعض القطاعات الأخرى التي تشتغل على مدد زمنية مفتوحة، فكل هذه الاعتبارات والضغوطات تشكل إذا عاملا مفسرا لهذه
الإجراءات المتسارعة والمتسرعة. وعليه فلا لوم على الوزارة الوصية على قطاع التعليم، ولا لوم كذلك على كل الأطر التربوية التي انخرطت بقوة في هذه البيداغوجيا الرقمية الجديدة من غير إعداد مسبق.
وحتى لا يتهم هذا العمل بالسلبية أو يدرج ضمن خانة النقد من أجل النقد، فإنني سأضع مجموعة من المقترحات التي ستعمل على الرقي بهذه الإنتاجات المعرفية، باستحضار أهداف وغايات المنظومة التربوية.
أولا: لابد من التخلص من هاجس الكم، والتركيز على المعارف الأساسية في كل مادة، ولا يخفى على كل ممارس لمهنة التعليم أن المعارف والمهارات منها ما هو أساسي ومنها ما هو ثانوي، وعليه وجب في هذه الفترة بالخصوص التركيز على ما هو أساسي، ويمكن أن استدل على ذلك بالمجزوءة الرابعة في كتاب اللغة العربية لمستوى الأولى باكالوريا علوم بمختلف مسالكه، فهذه المجزوءة تعد بامتياز مجزوءة أدبية صرفة، لأنها تنفتح على قضايا شعرية وما يتعلق بها من آليات بلاغية، وقضايا ذوقية وجمالية، فهي إذا مثال للمعارف الثانوية بالنسبة للتخصص العلمي.
ثانيا: لابد من التركيز على التوجيهات أكثر من تقديم المعلومات، وذلك باستحضار مواطن التعثر التي تعيق استيعاب عملية الفهم لدى المتعلم، فمثلا عوض تحديد الفكرة العامة للنص يمكن توجيه المتعلم الى وضع عنوان لكل فقرة ثم دمج العناوين في جملة أو جملتين تراعي سلامة الأسلوب واللغة، وبدل تحديد وحدات نص شعري، يمكن توجيه المتعلم إلى تحديد الموضوعات التي يتحدث عنها الشاعر، أو تحديد مواطن تحول الضمير في القصيدة، أو تغير زمن الأفعال، ثم بناء على ذلك يطلب منه تقسيم النص إلى وحداته الدلالية.
هذه نماذج لبعض التوجيهات، وكل أستاذ أدرى بمواطن الضعف لدى تلاميذه وبالتوجيهات المناسبة لتجاوزها. لأن المتعلم في أغلب الحالات لا يتم تقويمه في ما يقدم له من نماذج، بل في وضعيات تعليمية مشابهة، حتى يتم قياس مدى قدرته على تطبيق ما اكتسبه، ويبقى المعول عليه في النهاية هو مدى امتلاك المتعلم لآليات الاشتغال. يمكن أن يستثنى من ذلك بعض الأسئلة التي
تراهن على الحفظ والاسترجاع.
ثالثا: لابد أن تتوجه الجهود أكثر إلى إنتاج المضامين الرقمية التفاعلية التي توظف الصورة والصوت، لأنها أقرب الى محاكاة الوضعيات التعليمية العادية، ونقول أقرب لأنه حتى في حال الدروس المصورة فإن التواصل يفقد حميميته وما تفرزه من معطيات نفسيه وتفاعلات بينية تسهم في بناء التعلمات والمعارف، أما من يعتقد بإمكانية إحلال التواصل الافتراضي مكان التواصل المباشر فهو بعيد عن الصواب، لأننا سنكون أمام محاولة أشبه باستبدال المسرح بالسينما دون مراعاة الفوارق التي تحدد خصوصية كل واحد منهما، ومتطلباته وأهدافه. فالتواصل المباشر تواصل حميمي، مرتبط ببنية نفسية وذهنية ومجتمعية معينة، إنه نسق متكامل محدد الأهداف والغايات، وقد تم وضع المقررات باستحضار هذه الخصوصيات، ومن غير الممكن تعويضه بنظام آخر ما لم يتم تغيير تلك البنية، أو بعبارة أخرى، خلق نسق آخر مواز للنسق القائم.
رابعا: ضرورة التفكير مستقبلا في إنشاء الكتب المدرسية الإلكترونية، حتى يسهل استثمارها في إنجاز ما يتطلبه التعليم عن بعد، ومواكبة ذلك بتغيير على مستوى المضامين والأهداف والقدرات وطرائق التقويم. إذ لا يعقل الآن في عصر الذكاء الصناعي أن يبقى المتعلم رهين قدرات تشتغل بمنطق الندرة، في حين أن وفرة المعلومات وسهولة الوصول إليها تدعو للتفكير في قدرات جديدة مثل القدرة على معالجة المعلومات المتدفقة، أو القدرة على الانتقاء، وأن يكون الهدف في النهاية خلق إنسان مواكب للتطور الذي يعرفه العالم في شتى مجالات المعرفة.
وبدل تقسيم النصوص الى أنماط تراعي الخصوصية اللغوية والأسلوبية يجب اعتماد معيار جديد، محدده الأساس هو التقنيات المعتمدة في إنتاجه، لأن هذه التقنيات هي التي تحل محل الخصائص اللغوية للنصوص الورقية، كما ينبغي التفكير في تصنيف جديد للإنتاجات الأدبية يراعي طريقة إنتاجها، هل هي إنتاج رقمي، أم غير رقمي.
كما أن هذا النمط الجديد من التعليم يحتم الانفتاح على الأنماط التواصلية الجديدة التي أفرزتها التقنية الحديثة مثل الرسائل القصيرة، ودمج الكتابة بالصورة الثابتة أو المتحركة، أو أشكال
الصور التي بدأت تقصي الحرف من عالم التداول، أو على الأقل تزاحمه بقوة .
ويظل التقويم من أهم الإشكالات التي تتطلب تفكيرا جديا وجديدا في طريقة تقديمها، لأنها هي التي تتوج عملية التلقي المعرفي، وتحدد ثغرات التعلم لدى المتعلم التي تحتاج الى دعم، كما أنه يؤدي وظيفة معيارية تقييمية تمنح المتعلم حق الانتقال الى المستوى الأعلى، أو البقاء في نفس المستوى، و لأن فلسفة التقويم كانت مرتبطة بطبيعة التعليم التقليدي، وبمجتمع يقوم على التراتبية في كل شيء، الرئيس في مقابل المرؤوس، السيد في مقابل الخادم...، و كان محوره هو التمكن من المعلومات المكتسبة وتوظيفها في وضعيات شبيهة بها، أو بينهما صلة. فإن التقويم الحديث ينبغي أن يتجه الى قياس القدرات الإبداعية لدى المتعلم، وأن يتخلى المجتمع عن فكرة ترتيب المتعلمين، وتعويضها بفكرة أن لكل متعلم مجال إبداعه وتفوقه، و من ثم يصبح دور المعلم وهو دعم المتعلم ومساعدته على تقوية قدراته الإبداعية التي تضيع غالبا تحت تأثير معايير التقويم الحالية.
كما ينبغي إلغاء نظام النقط العددية ويستبدل بملاحظات مثل مبدع أو مبدع، أو في طريق الإبداع...إذ لا مناص من التفكير الإبداعي.
كما يجب أيضا إعادة النظر في التخصصات ومسالكها، حتى نتجاوز ما تخلفه وراءها من ضحايا وكوارث، فهل من الضروري أن يفرض في كل مسلك مواد بعينها؟ وعلى المتعلم أن يقبلها جميعا أو يتركها كاملة، لم لا تكون هناك فسحة تمكن المتعلم من اختيار المواد التي يرغب فيها داخل نفس التخصص وخاصة في المواد الثانوية، أو تحدد له في مجالات عدة يمكن أن يختار فيها ما يتماشى مع ميولاته.