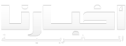تحت مسمى ...الهاتف النقال

خالد ليلي
يسمى بأسماء عدة منها الهاتف النقال ، المحمول ، الخلوي أو المتحرك (الموبايل أو البورتابل ) وقد أصبح مع سيرورة التحديث أداة اتصالاتية و اتصالية بامتياز ، ليكتسب مع تعاقب أجياله صفة الذكاء و لتتعدد استعمالاته و وسائطه و تتطور أشكاله التقنية التي تتحفنا بها التكنولوجيا كل يوم ، حتى بات كل منا و في جيبه جهاز حاسوب صغيرو مدمج يسمح بتشغيل مختلف البرامج من مثل تصفح الويب و البريد الالكتروني و الموسيقى و تحميل الصور و الفيديوهات ، إضافة للعديد من التطبيقات الترفيهية و الثقافية و العملية التي تساعد الانسان في تدبير حياته اليومية من مثل إدارة المعلومات الشخصية للفرد عبر تنظيم و تقويم المهام اليومية و تخزين المعلومات ، و استعمالات بطاقات الائتمان و تسديد الفواتير ، و كذا صرف الشيكات و إجراء التعاملات البنكية ... وغيره كثير من العمليات التي جعلت هذا الكائن التكنولوجي ضروري في حضوره اليومي و مباشرة أشكال التفاوض مع الواقع المعاصر ، لكنه ومع هذه الأدوار المتعددة والمزايا الكثيرة و البراقة فإنه مع ذلك لا يبقى فقط كألة عجيبة طيعة تستلهم دورها من فانوس علاء الدين ومارده القادر على تحقيق الأمنيات ، أو شكلا تقنيا محايدا يستكين فقط لإرادة مستعمليه و نزواتهم في تدبير علاقاتهم بالواقع اليومي ، بل إنه و كأي منتوج مستورد يحمل معه إرثا أيديولوجيا واستلابا ثقافيا غير بريء يعكس ثقافة مصنعيه و حمولتهم القيمية ، من دون الحديث عن كل أشكال التأثير الثقافي و الهوياتي و الرمزي التي تتسرب ببطء الى مخيال مستعمليه ،فكان لابد من دراسة تأثير حضور هذه التكنولوجيا الحاضرة بلغة مبالغ فيها في حياتنا الاجتماعية و كيفية إعادة انتاجها ، ومن تم النبش في القيم و الرموز التي يحملها معه فتؤثر على سيرورة المجتمع في ظل وجوده مادام التركيز على التكنولوجيا كتقنية محايدة وحدها يؤدي لإعاقة فهم السياق الاجتماعي ومختلف التأثيرات التي تحكم مساراته ، و ما دام أيضا " أن أي رؤية و إدراك لاستعمال امتدادات الانسان في شكل تكنولوجي معين هي بالضرورة خضوع لها " كما قال ماكلوهان ، فكان لابد لنا إذا عند دراسة الهاتف النقال كمنتوج تقني متطور أن نستحضر مسألتين أساسيتين : أولا درجات انعكاسات حضوره على جوانب من الحياة الاجتماعية و الثقافية و الأخلاقية ، و كيف تغير هذه التقنية الحديثة من نسق التفاعلات المجتمعية اليومية ثانيا ؟
إن أي تكنولوجيا لابد وأن تقابل في البداية بالرفض و الصد و تصيد الهفوات و الزلات وهي طبيعة بشرية سارت عليها مند القدم ، فكان لابد من إيجاد برهة من الوقت بغية الاستئناس و التأقلم مع هذه الضيف الجديد بمعنى ممارسة فعل المساومة و الاختبار خصوصا في ظل النمو الهائل لهذه التقنية في مجتمعاتنا الكونية قبل أن يحظى بأي قبول و إقبال عليه في نهاية الأمر ، مع الإيمان المسبق بأن تكنولوجيا الاتصالات اليوم قد صارت ديدنا روتينيا و فعلا لازما بعدما لعبت دورا في عملية الانتقال الكبير للإنسانية نحو التحديث والتقدم وما صاحبها من إنجاز لحتمية التغيير على الصعيد الاجتماعي الذي يتجه نحو التشبيك كما يقر بذلك مانويل كاستلز، خصوصا و أن التفاعل مع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في جوهره هو محاولة ناجحة لتجاوز معيقات التواصل و تملك القدرة على تجاوز إشكالات مفهومي الزمان و المكان التي أبطأت و لقرون عديدة عمليات الاتصال و التخاطب ، لدى فقد صاحب بروز الهاتف النقال نمو سريع سواء على مستوى ديناميكية الانتشار و التطور والتجديد بحيث لا يخلو كل يوم من ظهور وظائف و تطبيقات تبغي تحسين الأداء وتيسير الاستعمال و استجلاب الزبون ، و من حيث شعبية الإقبال اليومي عليه ليمارس من خلاله تغييرا على مستوى وقائع حياتنا الاجتماعية مع بروز قيم جديدة تتماهى مع اشكال تطوره و تعدد وظائفه .
إن فرضية الاستعمالات اليومية للهاتف النقال لأكثر من نصف معمري الكرة الأرضية صارت واقعا بديهيا لا يحتاج لأن نحاجج عنه ، فقد نقل اشكال التفاعل بسرعة قياسية نحو عالم هلامي غير ملموس و غير تقليدي لدرجة تحول معه الكائن الإنساني الى كائن الكتروني بامتياز في اشكال تخاطبه و علاقاته و تدبيره اليومي لأجندة تفاعلاته ، هذا التطور حتم على كل ملاحظ و دارس قراءة مضمونه الواقعي الاجتماعي منذ بداياته كرأسمال اجتماعي يتكئ على الرأسمال المادي في إبراز أوجه الوجاهة الاجتماعية للفرد عبر حيازته لأشكال جديدة من الهواتف الفاخرة و المتطورة ، فيزيد في نفس الحين من منسوب الرأسمال الرمزي مع ما يصاحبه من شتى أنواع المظهرية و التفاخر و تكريس التراتبية الاجتماعية و الاستمتاع بالدلالات و الرموز القيمية ، فعبره تتحدد المكانة و تقاس المسافة الاجتماعية ، وهو في نفس الان يرسخ التوجه الاستهلاكي الذي صار عليه مجتمعنا كسوق مفتوحة للبضائع المستوردة في عصر العولمة و هي تمارس لعبة الغواية الرأسمالية و التحرش الرمزي ، فأصبح معه الكل في غياب ثقافة الكتاب و الفن الرفيع يبحث عن اخر ما نزل الى الأسواق من الهواتف النقالة وأحدث البرمجيات التي تحتويها في ظل ثقافة اللذة و الاستمتاع و الإيقاع السريع و الترفيه، مع البحث المتعطش و الدائم عن كل ما يدخل السرور و ملذات الحس المادي و إثارة الغرائز في نفي لكل تدبير عقلاني عن ملامسة طرق اشتغال برمجياته والاستفادة من خواصه الإيجابية المتعددة ، مما يدل على الاختراق الثقافي الفظيع الذي اصبحنا نسبح فيه و الذي يستهدف تعطيل العقل كأداة لقياس وتدبير مجموع سلوكنا فيتجه مباشرة لاستهداف هوى النفوس عبر إثارة أشكال اللذة و الإثارة وكل ما يستهويها ، و هذا كله يدخل في إطار منظومة فكرية و ثقافية كونية تهدف الى استبدال مفهوم "الوعي" لحمولته الفكرية و الأيديولوجية كما يقول المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري بمفهوم جديد هو "الإدراك " الذي يعني "تسطيح الوعي " بالسيطرة علي الفرد عبر كل أشكال الصور السمعية البصرية ، و جعله فقط يرتبط بما يجري على السطح من صور و مشاهد ذات طابع اعلامي اشهاري مثير للإدراك و مستفز للانفعال ومن ثم حاجب للعقل ، فيتم بالتالي "اخضاع النفوس" كمرتع للهوى بشكل كامل عبر الية تعطيل" فاعلية العقل" ، والهدف تكريس نوع معين من الاستهلاك و تنميط الذوق و خلق الحاجيات و قولبة الاشكال السلوكية من دون أي فعل ارادي تمنعي مقاوم .
إن الهاتف النقال تحول عند شبابنا الى ملاذ للإشباع النفسي و البيولوجي ، فيتم استخدامه من طرف الذكور كرمز للرجولة و الحداثة التي تنهل من حب الظهور و التباهي لتجاوز عقدة النقص الاجتماعي المعاش خصوصا لدى الفئة التي تنحدر من القاع الاجتماعي ، و التي تصل الى درجة الهستيريا و الهوس بكل ابداع تكنولوجي ينهل من أخر الصيحات حتى يشرعن تفوقه على أقرانه ، و في نفس الان أداة تعويضية يقاطع بها واقعه المعطوب عبر الانغماس لدرجة الإدمان في تصفح عالمه الافتراضي الذي لا يبخل به عليه باستعمال تطبيقات لا حصر لها ، فتجعله منفصلا انفصالا يكاد يكون كليا عن تضاريس الواقع اليومي مع الشعور بدرجات من الانشراح و الانتشاء و الطرب يكاد يصل الى ما يفعله المخدر في الذات الإنسانية كصيغة مستقطعة من رفضه لأشكال العلاقات السائدة ، و هو ما يترجم غالبا في فعل الهروب الى ممارسة الخلوة و الفردانية بغية تجاوز حدود الرقابة و الضبط الاجتماعي الذي يمارسه عليه المجتمع و علاقات القوة التي تطبعه ، الأمر الذي يفسر ظهور جماعات افتراضية على مستوى الوسائط الاجتماعية تنهل من المعايير التي يضعونها و أساليب الحياة التي تؤطر مسار حياتهم فتجعلهم يميلون الى ابتكار ثقافات فرعية خاصة بهم يتم التفاعل معها بلغة تداولية و إشارات تواصلية تنهل من الرموز و الأبجديات اللغوية التي يضعونها ، مع ابتكار الشفرات السرية التي يبغون بها تحصين خطابات تواصلهم و التي تعتمد في غالب الأحيان الاختصار و الاستعارة بشكل خاص .
لقد أصبح الهاتف اليوم تأشيرة المرور الى العالم المتحضر و عنوان الوجود ، فأنا اهاتف فأنا موجود حتى بات الخوف من فقدانه يدخل في أمراض العصر الجديدة تحت مسمى la nomophobie
، بمعنى أنه صار من الامتدادات الجسدية التي نشتغل بها مع ما يحمله من طبيعة وظائفية دائمة كفيلة بتيسير برامج العمل اليومي و النسق الحياتي المفروض علينا ، لكن هذا الامتداد يدخلنا مع ذلك في مفارقة عجيبة تجمع بين الشيء و ضده ، فهو ينعم علينا من جهة بما يسمى ديموقراطية تملكه واستعماله و قد توحد العالم في فعل استهلاكه والانتفاع من مزاياه بعدما تم إقحامنا في سياق الحداثة برغم أنوفنا ، فبات الكل يجيد محاورة هذا الكائن الإلكتروني من صغير وكبير، ذكر و أنثى ،غني و فقير ،مواطني العالم الأول و الثالث و الرابع ... و من كل أجناس الأرض أصفر كان أو أبيض أو أسود ....، و من جهة أخرى فهو يخضعنا لديكتاتورية الكترونية رقمية تجعل فضاءنا الزماني و المكاني متحكم فيه ، ولا يترك أي مجال لممارسة أي تمرد أو انتفاضة ضد سلطته في فعل الانجذاب و الإثارة بفعل اليات الغواية و الإغراء التي ما فتئ يوظفها كل حين ، فينساق معه الكل في برامجه ومطبقاته المغرية والجذابة لدرجة السحر ، و هذا كله في سياق الهروب من الواقع و عبر المراهنة على تسويق الخيال وتشكيل الأحلام التي تنتج على المستوى الافتراضي في قطيعة تامة مع الواقع المعاش ، فأصبحت الهواتف النقالة كأحد "سبل التحرر و الانفتاح و التحول نحو التجوالية mobilisation " كما يقول مانويل كاستلز، مع الانفصال المؤقت عن المعيش اليومي و من متلازمة السؤال و النقد ، كما تريح الجسد والعقل من ضنك التدبر والتدبير اليومين في تفاصيل الحياة التي صارت عنوانا لألم و تعب مستمرين ، لكنها مع الأسف تكرس الأنانية و الفردية التي تجعل المرء يعتقد في أن حقيقة وجوده محصورة في فردانيته ، فتعمل على طمس الروح الجماعية و العمل الجماعي والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف الأول و الأخير للعولمة و لنظامنا العالمي ، حتى أصبحنا أفرادا مفرغين من هوياتهم و ثقافاتهم و منسلخين عن انتمائهم الحضاري و التاريخي و العقائدي .
هذا ولابد من الإشارة في الأخير الى تقمص هذا الكائن لدور إخباري استعلامي وفضائحي بامتياز عبر تقنيات الفيديو و أشكال الوسائط الاجتماعية التي باتت مقترنة به كجزء من تركيبته الفيزيولوجية والتكنولوجية التي تتطور يوما عن يوم ، حتى صار مرادفا لفعل الاحتجاج والتجسس و تصفية الحساب و الانتقام من الواقع المعاش ، فلقد تم استغلال ثقافة الصورة أيما استغلال عبر حضورها الدائم و المستمر في كل تجاويف الحياة اليومية ،بل صار وسيلة لمحاسبة رمزية لكل المسؤولين عبر النبش في كل علاقاتهم الاجتماعية و تسييرهم الإداري من خلال عرض للاختلالات التي تشوب تدبيرهم اليومي عبر صور يومية و حية تثبت إهمالا من هنا و تقصيرا هناك و سلوكا غير لائق بين هذا و ذاك ،ليصير أداة إعلامية من دون غرفة تحرير و من دون حضور لمقص الرقيب أو السلطة الوصية ، وبات بعدما دخل من دون استئذان في سجل الأدوات الإعلامية الأساسية العلامة الأكثر حضورا التي تنخرط في احدى الوظائف الجديدة للإعلام اليوم الذي حصر دوره كما يقول السينمائي كازانوفا في " وظيفة الإعلام هي الاستعراض " بمعنى إزاحة الستار عن كل ما هو مكتوب و مسموع الى كل ما هو عيني يتحرك ويتفاعل من دون أية رتوش أو حجب ، مع أن استعمالاته أصبحت تطرح أكثر من سؤال بعدما تجاوز استعماله المحظور الاجتماعي و القيمي ليغوص في كل أشكال تصفية الحسابات و التنابز السياسي و الصراع الأيديولوجي في لغة سادية غرضها تحطيم الأخر و التشهير به و إقصائه ، و ليصبح أداة تختزل الباتولوجيا الاجتماعية كعنوان لانحدار القيم و غياب المعايير الأخلاقية التي بتنا أحوج لها أكثر من أي وقت مضى .