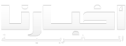السعادة المرقمنة

إكيضيض عبدالغني
استهل هذا المقال بنصيحة مقتضبة وجهها لنا أستاذ جليل ذات يوم مفادها؛ "عودوا إلى الحياة".
تجلى سياق النصيحة آنذاك في حوار متبادل جرى بيننا –نحن الطلبة- وبين الأستاذ، حيث تجلى موضوع الحوار في الإشكالات التي تطرحها الصورة، وارتباطها بالسعادة باعتبارها مفهوما جدليا وغاية سامية يسعى كل إنسان إلى ملامسة تفاصيلها التي لا تمل، حيث تضمنت النصيحة أعلاه كلمتين أساسيتين، الحياة؛ وهي كلمة مقترنة بثنائية السعادة والتعاسة، والعودة؛ وتفيد سلوكا مناقضا للمغادرة أوالهجرة، وبين الكلمتين سيرورة من الانفعالات والردود التي تصدر عنا من حين لآخر، وهي انفعالات تهيمن على سلوكاتنا اليومية، سواء تعلق الأمر بما ننتجه من تفاعلات داخل التواصل الافتراضي، أو حتى ما يصدر عنا واقعيا من ردود.
هجرنا الحياة، واغتربنا عن منطقها السليم، وانتقلنا من تجربة واقعية صارمة إلى أخرى يشكل الخيال مبدأ لها، وصرنا كائنات افتراضية تحكمها الأرقام والألوان والأشكال، وأصبحت تقودنا قيم وهمية متعالية عن الواقع المعيش، لتتحول السعادة داخل هذا النسق من الإشكالات إلى استكانة مؤقتة تخضع لتخدير التكنولوجيا .
لم يعد مهما في أبجديات الرأي الانطلاق من تعريف مقتضب لمفهوم السعادة، ولا حتى الارتكاز على تصور مبدئي له، فذاك إشكال واكبه أكثر البشر معرفة، وقاربه أشد الباحثين ذكاء، فلم يتبق لنا نحن البسطاء سوى ملاحظة التمثلات الثقافية التي تحكم مجمل ظواهرنا السلوكية، حيث السيلفي وارتداد المطاعم وحضور الأعراس والتفاعل الافتراضي وغيرها من التحققات تشكل الواجهة الثقافية لمجتمعنا، بل تحرك حاضرنا بكل ما يحمله من تناقضات نحو مستقبل مجهول .
يفرض علينا هذا التقديم البسيط ربط الظواهر المذكورة آنفا بمفهوم السعادة الذي أتحاشى تعريفه، أو حتى الخوض في تفاصيله كونه مفهوما جدليا، و يعود السبب في تقديري إلى الخلفية المعرفية الرحبة التي بنيت عليها مجمل التعريفات، فضلا عن طبيعة المقال، حيث سأكتفي بالتدقيق في سيرورة قد تبدو لنا محدودة مبدئيا، ولكنها في الواقع منفتحة على تأويلات لا تحد، يتعلق الأمر إذن بما نستنزفه من طاقات داخل العالم الافتراضي مقابل الحصول على سعادة تبدو في أغلب الأحايين مزيفة، مصطنعة، مغشوشة، نخدع بها أنفسنا أولا، ثم نحتال بها على متابعين بسطاء لا حول لهم ولا قوة يؤولون بها ما وراء الصور الرقمية، حيث يشكل الانفعال والتأثر والتألم والاستياء نقط الانطلاق، أما المنتهى، فلا يغدو أن يكون مجرد نقرة تعبر عما يختلجنا من نقائص وانفعالات .
إن التأمل في المحتويات الرقمية التي تهيمن على مواقع التواصل الاجتماعي، الخطي منها و الأيقوني، يقودنا إلى تصور مفاده؛ إن الانفعال محرك أساسي ينتج مجمل الردود المضطربة، ويخصب داخل أذهاننا تمثلات تثنينا عن السعادة باعتبارها تحققا شعوريا واقعيا، ويرسخ لنا شروطا نمطية عما تقتضيه السعادة نفسها، ويوجهنا بخورزميات تتفتق عنها - تقنيا -
الألوان والأشكال والمقولات التي ترسم لنا أبعادا ذهنية محدودة عن السعادة أيضا، فالتقاط الصور وتعديلها ونشرها على هذه المواقع ليس إلا تحققا لسعادة مشوهة تتحدد معاييرها في تعديل الألوان والتباين والإضاءة والمسافات، وهي تعديلات لا تخرج عن نطاق التقنية، وهو الأمر الذي يسهم في بلورة تمثل جديد عما تشتهيه أنفسنا من ملذات، أو على الأقل ما تبتغيه من أهواء، فالصورة باعتبارها أيقونا رقميا يهيمن على الخطي في مجمل الوضعيات الافتراضية تشكل الرائز المركزي الذي نقتحم به عالم الآخر، نهدد به وجوده، ونسعى إلى استقطابه بما نملك من تقنيات، لنخدع أنفسنا في نهاية المطاف بالتقنية ولا شيء آخر .
لن ننكر أن مجمل انفعالاتنا تختزل رحلة بطولية للبحث عن سعادة مفقودة، موزعة على لحظات زمنية متفرقة، وممتدة إلى غايات نطاردها كل يوم، نسعى إلى اكتسابها باندفاعاتنا الطفولية، المقبولة والمرفوضة، فنحن نتصنع الابتسامة ونوقف لحظة الجلوس في المقهى بالصورة ونجتمع مع الغرباء ونداعب النساء لنقول لعالمنا الخارجي إننا نستحق أن نكون سعداء، أو بالأحرى نقدم أنفسنا في حلة بهية تجذب الغرباء، أما الأقربون فلا نفكر في استقطابهم لأننا ضمنا ملكيتهم، وأحكمنا قبضتنا على اهتمامهم بنا، فلا يبقى لنا داخل سيرورة التأثير هذه سوى ذوات نجهل ما تكتنزه من قيم ومبادئ ومعتقدات، إن هذه الرحلة إذن وإن كانت سريعة تستحوذ على سلوكنا اليومي، وتربط أذهاننا بالتقنية باعتبارها الوسيلة المركزية التي نضمن بها خروجنا من عالمنا الداخلي واقتحام عالم الآخر المبهم، إنها إذن (الرحلة) حرق للجسد، وهدر للزمن، وتوقيف للحظات، واستهلاك للمشاعر، وتضييع للأفكار، واغتيال للحميمية، واقتلاع لوعي طبعي مكتسب، وتشويه للسعادة كما تتحقق بالأكل والشرب والجنس والتعبير، إنها رحلة من لا سعادة له، نلامس بها وهم الفرح، ونقنع بها أنفسنا أن الكماليات أساسيات، والأساسيات التزامات متعبة تقتضي منا تأجيلها في كل لحظة ضعف، إنها إذن رحلة التفاعل مع أبعاد الأيقون في عالم افتراضي منهار، إن هذه الرحلة أشبه بالكرنفال، أو بمسرحية هزلية يطفو فيها الجد من حين لحين.
وبعد الاحتفال ينزع كل منا لكآبته، ويركن لهمومه، ويتكبد وحدته بعيدا عن الأيقون، فالصورة فرحتنا التي لا تدوم، والواقع الموحش عزلتنا التي لا تنتهي، أما كتاباتنا على الفيسبوك فهي أشبه بمذكرات منتحر دَونَهَا لحظات قبل الموت، نضمن فيها حِكَمَنَا الملفقة، ونعبر بها عن رقي لا نملك منه سوى التمني .
يقول أرسطو : السعادة سد للنقائص .
والسعادة داخل إطار موضوعنا بديل عن تعاسة تلاحقنا أنى رحلنا وارتحلنا، إنها نَفَسٌ سرابي يكسو فراغنا الدائم ونستبدل به لحظات الضعف، نصنع بها أملا مؤقتا، لحظيا، قابلا للتجديد، إنها مستمدة من واقع خيالي لا يخرج عن دائرة احتمالات التقنية، نحارب بها قسوة الواقع، ونتجنب بها الوقوع في مطباته التي لا تنتهي، فقد أصبحت –السعادة- صورة ملتقطة تقصي أزمنة الفرح المتعددة، تتفتق عنها مجمل العواطف، وتتولد عنها التمثلات التي نهاجم بها بعضنا البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن إذن نخوض حربا باردة، لكن حرارتها النفسية مرتفعة بالقياس إلى ما ينعكس في الواقع المعيش، إنها حرب الأحاسيس، النوعيات، حرب الجَمَال، السلطة، المال، حرب قوامها البروز بأبهى حلة وأجمل هيئة، حرب ضد التعاسة ولأجلها، إنها حرب نحترق فيها لنحيا كما لا نريد، أو كما يريد الآخرون .
يصعب أن نعدد ما تزخر به أرواحنا من نقائص، أو حتى ما تتمتع به من نعم، لكن جحودنا يقودنا غالبا إلى نكران النعم واستقطاب المزيد، فخارج التقنية، أو بعبارة أكثر وضوحا، بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لا حياة نحياها كما ينبغي، ولا سعادة تدب إلى أرواحنا المنهكة، مجمل المعايير، والشروط؛ نربطها نفسيا بما ننشره من محتويات على هذه المواقع، ليترسخ هذا الرباط الذي يتقوى كل يوم، وتتجدد أسسه باستمرار .
نقدم أنفسنا بالصور عرسانا، نتزين بما نملك من ألوان، ونحن نعلم أن قاعدة التزيين مفتعلة اتفقنا عليها مجبرين، لتصير الصورة نموذجا مرتبطا بالسعادة المأمولة، ملغية بذلك ممارسة الرياضة والاحتكاك بالطبيعة والأسرة الطيبة وتناول الأغذية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، كل هذا يصبح مجرد تحقق تقليدي متجاوز بالصورة التي تقدم نموذجا حداثيا لما ينبغي أن نقوم به لنكون سعداء، إن الأمر إذن يتعلق بحدين دلاليين متناقضين، الأول يشكل النموذج الأصلي الذي تقاوم فئة قليلة لتجديده، وهو المتمثل في أصول السعادة، بما في ذلك البعد الروحاني، أما الحد الدلالي الثاني، وهو الأكثر تسربا إلى
أذهاننا، لا يقتضي منا جهدا فكريا لنحصله، بل يكفي أن نلتقط صورة لنا ونحن نتناول وجبة خفيفة في مطعم من المطاعم الفاخرة ونحصل على بعض الجيمات أو التعليقات لنجدد فينا روحا آنية تزول بزوال النشوة، إن الحدين الدلاليين هذين يمثلان السيرورة المحدودة التي نتخبط داخلها، والبطولة الإشكالية التي نعيشها بمرارة، إنها سيرورة تنبني على خواء أخلاقي مألوف، لا القيم الإنسانية الأصلية توجهها، ولا المبادئ الدينية تؤطرها، إنه فراغ يستجد وتتكرر تعاليمه باستمرار.
إن مجمل التمثلات التي أصبحت تهيمن على قراراتنا لا يمكن فصلها عن توجه اقتصادي عالمي ينبني على المصلحة، ومكننة الإنسان، ونهش الإنسانية، وهو الأمر الذي انعكس على ثقافة الأفراد والشعوب، والإسهاب في هذا الإشكال يقتضي تفاصيل لا يسع لها المقام، فقد تحولت القيم إلى معايير جمالية قابلة للمساومة والتعديل، وأصبحت الأخلاق بمفهومها العام مؤطرة بشروط المنفعة والربح، الأمر الذي أجبرنا على مغادرة الحياة الطبعية الصارمة واستبدالها بالحياة الافتراضية، لتضيع السعادة وسط تفاصيل النشر والتفاعل في عالم بلا أخلاق .