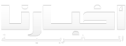لقطات انتخابية

سعيد المودني
نصل إلى "المقال" الأخير في هذا الملف الذي تضمن مقالات حول الانتخابات.. وفيه نقدم لقطات مختلفة تتعلق بالعملية ككل..
المشهد الأول يتمحور حول أولوية، أو "أولية"، الإصلاح بين السياسة والاقتصاد.. ذلك أن الهدف المفترض للانتخابات هو إفراز قيادة تتولى تدبير الشأن العام للمجتمع، وطبعا المأمول هو السؤدد والرفاه..
وفي ظل التخلف الذي نتخبط فيه، وفي خضم السجالات بين التيارات السياسية المتعلقة بالتنافس أو التنظير للتغيير نحو الأفضل، يطفو على السطح جدال قار واتهام متبادل حول امتلاك أو عدم امتلاك برنامج اقتصادي لدى هذا الفصيل أو ذاك.. ويكاد ينزل النقاش حتى لـ"العوام".. والحال أن الطرح لا يبدو سليما من الأصل، من جهة لأن المخزن والأحزاب السياسية(بعضها على الأقل) لا تفتقد "البرنامج الاقتصادي"، وإنما يفتقدون بالدرجة الأولى غياب بيئة التنزيل(بالنسبة لكل "الأحزاب" على الإطلاق)، ثم الإرادة الشريفة النزيهة للتنفيذ(بالنسبة للمخزن وغالبية "الأحزاب").. ومن جهة أخرى، وهو الموضوع، لأن الأمر يتعلق بجزئية، وإن كانت كبيرة ومهمة، إلا أنها تبقى جزئية في النظم السياسية، من منطلق التضمن بين السياسي والاقتصادي،، وإلا ما هو الأولى والأولي: التغيير السياسي أم الاقتصادي؟ بل كيف يمكن تنزيل "برنامج اقتصادي" حال وجوده؟ ثم من يدخل البلدان في الأزمات الدائمة القارة الثابتة البنيوية(وليس العرضية الطارئة المؤقتة): السياسة أم الاقتصاد؟ وعند حدوث تلك الأزمات، مَن المخول بالبحث عن "التقني" الذي يمتلك الحل؟ وكيف يحصل هذا المخول على تفويض الشعب؟ هل ينتخب الشعب رئيس الدولة أو وزير الاقتصاد...؟؟!!!..
الناتج أنه بغض النظر عن مدى صحة عدم توفر التيارات والأحزاب السياسية على برنامج اقتصادي، وبغض النظر عن إمكانية تقديم البرنامج -حال وجوده- لناقد عرضي في الشارع العام من حيث أهلية التقييم، فإن أسطوانة البرنامج هذه قد شُرخت بداية تسعينيات القرن الماضي في مدرجات وممرات وأروقة الكليات، حين كانت هي كلمة السر السحرية العيارية في اضطهاد والتضييق ونسف حلقيات طلبة التيارات المنافسة، غير المرغوب في ظهورها في الساحة..
إن السياسة حتى بمفهومها اللغوي هي رأس الأمر. ولا يقوم قائم إلى بها. وأقصى ما يمكن أن يحصله أي قطاع هو إضافة نعت مميًّز للمنعوت الثابت، كأن نقول مثلا: "السياسة الاقتصادية".. بل السياسي يجاوز حتى القانوني المفترض فيه الأعلى والأكثر ثباتا وإطلاقية في المجتمع، لأن القانوني هو نتاج تصميم السياسي وانعكاس له، بل هو من يصوغه ويفعّله ويعطله متى شاء وأينما شاء وكيفما شاء، ويتعامل معه بحربائية وانتقائية وظرفية وانتهازية.. فهو مرتبط به ومؤسس عليه.. وعليه فأي تغيير سياسي جذري يتبعه بالضرورة تغيير قانوني قد يطال حتى جذور وهياكل وأركان المنظومة القانونية السابقة. وفي المراحل الانتقالية يعطله بالقوة،، وبالفعل، بحيث يصبح لـ"القانوني الجديد" سند سياسي مستجد يعطيه مشروعية نقض "القانوني القديم": محاكمة من كانوا "يسهرون على تطبيق القانون"(الحكام) من طرف من كانوا "يخرقون القانون"(الثوار)،،، وكل هذا بالقانون..
...
دائما في ارتباط الانتخابات بالتغيير المرجو، هناك مكون آخر غالبا ما يثير الكثير من اللغط، وهو الموارد التي يتذرع بها المثبطون لتبرير تخلف البلدان التي استحوذوا على خيراتها، فيدعون أن "شحها" هو المانع من التقدم والازدهار، مع أنه لا توجد دولة بنظام سياسي فاشل تعيش الاستقرار والرفاهية والكرامة بما فيها تلك التي تمتلك الثروات الهائلة.. في المقابل هناك بلدان شحيحة الموارد، وتعيش الرخاء والاستقرار والكرامة الإنسانية، فقط لأن نظمها السياسية راشدة.. بل عبر التاريخ تغير وضع بلدان في الاتجاهين بوجود نفس الموارد ونفس التقنيين، ولم يتغير غير نظمها السياسية أو حكامها!!!..
...
في وجه آخر، ومن جانب التأطير القانوني هذه المرة، وباستعراض الطموحات الموغلة في العنصرية لبعض المتكلمين، نقف على النجاح الباهر الذي حققه المحتل قبل قبل المغادرة الظاهرة..
فقد "خرج" الاحتلال بعدما فعل فعلته في تأمين الولاء له، والتخلف والانحطاط والتشرذم لنا، ومن ضمن الآليات التي اعتمدها وورّثها للأنظمة الخديمة تطبيقات مقولة "فرق تسد" وما نتج عنها من تمظهرات عنصرية بغيضة،، وهذا في كل الربوع..
وتكثر إثارة هذه النعرات العصبية والعنصرية وتتناسل بما لا يدع مجالا لتجاهلها.. ومن بركاتها أن يحاول بعض "المنظرين" الأشاوس إقحامها حتى في اللعبة الانتخابية والمطالبة بدسترتها قانونيا، حين طالب أن يضاف في القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بند يمنع "الغريب" من الترشح، بداعي فتح الباب أمام الكفاءات المحلية "الغيورة على منطقتها"!!!..
وتسليما بجد العملية وجدواها لنكون في نفس المستوى الذي يتحدث فيه هذا المنظّر(ودون شك له أشباه)، فإنا نقول أن الكفاءات المحلية موجودة بلا شك، غير أنه لم يمنعها أحد من "التنافس".. أما بالنسبة لـ"الغيرة" فإن المدنية تجاوزت هذه القيم "الأخلاقية" الفضفاضة غير الملزمة، لتؤسس لتعاقد قانوني ملزم محاسب عليه وبمقتضاه، تاركة الالتزام الأخلاقي الفرداني للذمة الشخصية..
من الممكن المطالبة بإضافة معايير ترتبط بالترشح، تتعلق بالمستوى الدراسي مثلا، لنتجاوز الجهل والأمية في المجالس، ما دام العلم هو أسمى المطالب التي يجب أن لا يتحفظ على المطالبة باستحضاره أحد. كما تمكن المطالبة بإضافة معايير تتعلق بالوظيفة التي قد تقتضي التفرغ، أو استقلال الدخل تجنبا للارتزاق، أو الإقامة توخيا لـ"الإتاحة"... لكن،، "ابن البلد"؟؟!!!..
إن فتح هذا الباب، ناهيك عن جانبه العنصري، لا يمكن إيجاد حل عملي منطقي مقبول له، لأن كل المناطق المغربية تعج بـ"الأفاقيين".. بل لا تشكل الأسر النووية فيها إلا النزر القليل، وعليه يفتح باب التساؤل عن التاريخ المرجعي الواجب اعتماده لـ"إعطاء الجنسية"، وعن حدود الدائرة الجغرافية التي يمكن أن تشملها هذه "الجنسية"!!!..
وللإنصاف، فإن هذه العنصرية موجودة ومتواجدة، جديدها هنا أنها موثقة بالتدوين المكتوب، وصادرة عمن لا يُعذر، نظرا لمستواه التعليمي(حامل "دكتوراه في القانون")،، ثم إنها صريحة لدرجة أنه لا يمكن نفيها إلا بإعادة تعريف مفهوم العنصرية..