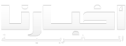ظاهرة العنف المدرسي : الأسباب والدواعي

عبد الحفيظ زياني
تتضمن كرامة الأشخاص، حياتهم، وحقوقهم، أهمية بالغة، وقيمة ثمينة لا سبيل لإنكارها، أو تجاهلها، فتقوم المسؤولية مقام المساس أو الاعتداء على الأفراد، كلما ثبت ركن الأذى الناتج عن هذا الاعتداء، الذي تنجم عنه مخلفات: نفسية واجتماعية واقتصادية، فحسب مكانة الضحية يكون حجم الأثر وانعكاسه، فإذا كان المربي يتصل اتصالا مباشرا بالطفل، في علاقة يلعب فيها دور النموذج الساهر على وظيفتين أساسيتين: تربوية وتعليمية، فإن عمله الجوهري يقوم على أساس التأسيس لميثاق قيمي، وضمان الالتزام به، كما يقوم بتوجيه السلوك وتقويمه في الاتجاه الأصلح والأنجع .
في ظل تعدد آليات العمل وتباينها، وانعدام التنوع في الأساليب التربوية، وكذا تداخل أدوار و مهام المربي، وانفصام في العلاقة بين مؤسسة التربية والمجتمع والأسرة، على اعتبار كونها علاقة تداخل وتأثير، من اللازم أن تكون مزدوجة المنحى والمسار، ذهابا وإيابا في اتجاه التقويم والتعديل، على النقيض من الوضعية الراهنة، المقتصرة على الوقوف موقف الحكم، وإصدار الأحكام ذات الطبيعة النمطية، كل هذه الملابسات، وما يتفرع عنها، يقابلها فراغ تنظيمي كفيل بخلق شلل مرجعي قانوني، فيما يتعلق بالمسايرة والانسجام والتقويم والتتبع، الأمر الذي يفرض فتح باب الاجتهاد على مصرعيه، إذ من الضروري حسن استثمار وتكييف ذلك الزخم التعددي في النصوص التنظيمية المتضاربة، ومواكبتها وتحيينها باستمرار، بهدف تحصين العلاقة ( طفل / راشد )، خلق النموذج، العمل على تجاوز اختلالات السلوك، ثم تحديد الدواعي المباشرة للانحراف المؤدي إلى إنتاج وإعادة إنتاج العنف .
إن مكونات الجسم التربوي، رغم تعددها وتنوعها، إلا أنها مازالت تعاني قصورا بينا، منهجيا وعمليا، انطلاقا من غياب تحديد المهام بدقة، وتفعيل الأدوار، مرورا عبر تعديل السلوك وتقويمه، وصولا إلى تنزيل الجزاء والعقاب، لتظل احتمالات وقوع الانحراف قائمة، مادام السلوك خلاصة مؤثرات داخلية وخارجية متشابكة، الأمر الذي يستدعي من القائمين على هذا الشأن اعتماد منهج تربوي فعال.
لعل ما يرتبط بسلامة الكائن الإنساني، مهما اختلف موقعه، يحتم من زاوية المقاربات البيداغوجية الناجعة، دراسة أبعاد الظاهرة السلوكية، دراسة مجهرية، تأخذ على عاتقها، عنصرين بارزين: الضرر، من خلال توفر أركانه المعنوية والمادية، وامتداداته النفسية والاجتماعية، فالردع: انسجامه مع الفعل المرتكب، ثم ملاءمة الاجتهادات القانونية مع الوضعية النشاز .
بدون ريب، فاختلال العلاقة الصفية الناتجة عن انهيار النموذج القيمي، وفقدانه لبوصلته ومكانته، رغم اختلاط الأسباب والدواعي، يظل نتاج الوضع المجتمعي السائد، وتداعيا من تداعيات فشل المقاربة الأسرية، مما تولد عنه شرخا على مستوى منظومة الأخلاق في شموليتها، الأمر الذي يضع الفعل البيداغوجي، في جل مناحيه، موضعا مقلقا وحرجا، يتمخض عنه إشكالية تتطلب وقفة مطولة بهدف إيجاد الحلول.
إن ما أنتج ظاهرة العنف الصفي، هو، بالكاد، نتيجة مباشرة من نتائج فشل التنشئة الاجتماعية، الناتج، بدوره، عن هوة سحيقة بين ثلاثي العلاقة: أسرة/ مجتمع/ مدرسة، والحد منه رهين بعقد مصالحة بين هذه الأطراف، وإعادة بناء العلاقة من جديد، على أسس متراصة وسليمة، أما الفصل في المقام بين أجزائها المترابطة، بنيويا ووظيفيا، فلن يحسم في علاجها مطلقا، بل قد يؤدي فقط إلى تقليم فروعها، لتبقى جذورها ضاربة في الأعماق.
لا يختلف اثنان، حول ضرورة إحاطة المدرس بالحماية اللازمة، يقابلها في الاتجاه الموازي، وجوب تحديد الإطار القانوني القادر على ضبط العلاقات، الصفية وغير الصفية، فالضامن الوحيد لعلاج ظاهرة العنف، باعتبارها نتيجة حتمية لانحراف السلوك، هو تدقيق الأدوار والمهام، وتحديد المسؤوليات التربوية والإدارية بدقة، ثم تفعيل المساطر التأديبية، وإحياء اللجان الانضباطية، ولن تستطيع المدرسة استرجاع وقارها وهيبتها، مادام النموذج الاخلاقي قد أعدم، نتيجة مجموعة أسباب تداخلت وتناسلت، حتى بات من الصعب تبيانها، لكن التساؤل المحرج والمقلق، و الذي يفرضه السياق العام، هو: من أي السبل نبدأ؟ إعادة الحياة للنموذج الأخلاقي؟ أم البحث عن مخرجات العلاج؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة