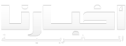إشكالات اللغات الأجنبيّة وشكليّاتها في المناهج التعليميّة العربيّة
_1664790493.webp)
أجدور عبد اللطيف
تتعدّد قنوات التعبير التي طوّرها الإنسان منذ فجر التاريخ، من نقوش ورسومات وإيماءات ولغات. هذه الأخيرة، اللغات، تتّفق العلوم والأدبيّات الإنسانيّة على كونها أهمّ مورد طوّره للتواصل وطوّعه للتعبير، نظرًا إلى تنوّعها وزخمها الهائل، وإلى كون اللغة كائنًا حيًّا ينبعث ويخبو، ويتجدّد ويتفاعل داخل كيانه، ومع الكيانات المحيطة به. لذا، لا يعترِيَنَّنا عجبٌ إذا علمنا أنّه في العالم حوالي ستة آلاف لغة ولهجة، غير أن 4% منها فقط هي المستعملة من طرف أغلب سكان الأرض.
لا يتمّ تلقين الأطفال اللغات عادةً، خلال سنيهم الأولى، بل يتعلّمونها ضمنيًّا في سياق احتكاكهم بالأسرة مع توقّد أذهانهم في تلك الفترة وتيقّظها. فلا نعجب من تمكّن بعضهم من لغتين مختلفتين، إذا تعلّم الأولى من الوالدين، والثانية من المحيط، أو ثلاثًا إذا أخذ الثالثة من المدرسة مثلًا، أو استقى من كلٍّ من الوادين لغةً في حال الزواج المختلط. وهذا كذلك ما يفسر تمكّن الأبكم، والذي استرجع قدرته على الكلام متأخّرًا، من إتقان اللغات المحيطة به، مع أنّه لم يمارسها قطّ.
تدخل اللغات الأجنبيّة في تكوين أنظمتنا التعليميّة العربّية بشكل أساسيّ، ولا سيّما اللغات اللاتينيّة، وبشكل أخصّ اللغتان الفرنسيّة والإنجليزيّة، مع حظوظ أقلّ للغة الإسبانيّة، وذلك تبعًا لمخلّفات الاستعمار طبعًا. ففي شمال إفريقيا، مثلًا، تُدرّس اللغة الفرنسيّة في المغرب وتونس والجزائر منذ السلك الابتدائيّ، وفي المدارس الخاصّة منذ مرحلة التعليم الأوليّ. ومؤخّرًا، اتّجهت بعض الوزارات الوصيّة هناك، إلى اعتماد الفرنسيّة في تدريس الموادّ العلميّة، كالرياضيّات وعلوم الأحياء والفيزياء. وكان المسوّغ حسبها هو أنّ المراجع والبحوث المعاصرة في هذه العلوم كلّها موجودة بهذا اللسان. لذا، فمن الضروريّ اللجوء إلى هذا الإجراء. وأخذت عليها هيئات تربويّة وحقوقيّة ذلك أيّما مأخذ، لكون المشيرات تؤكّد تعثّر التلامذة في المستويات الدنيا في اللغة الفرنسيّة بشكل كبير، ثمّ لكونها تتراجع يومًا بعد آخر، لصالح زحف اللغة الإنجليزيّة في ميادين الأدب والعلوم على حدٍّ سواء. واعتبروا خطوات كهذه مجرد تنزيل يائس لأجندات أيديولوجيّة فرنسيّة في مستعمراتها السابقة.
أمّا في المشرق الذي كان مستعمرًا من التاج البريطانيّ، فتعتبر اللغة الإنجليزيّة عنصرًا مركزيًّا في التعليم وفي الإدارة وفي كل ميادين الحياة. غير أنّ ذلك له ما يبرّره، لأنّ اللغة الإنجليزيّة هي الأوسع انتشارًا اليوم في الواقع وعلى شبكة الإنترنت، حتّى إنّ كلّ التظاهرات السياسيّة والثقافيّة والرياضيّة العالميّة تتّخذ اللغة الإنجليزيّة قناةً تتواصل بها مع العالم. ومع كلّ ما قيل، فإنّ هذه اللغات تعاني الأمرّين في بلادنا، لكون الأساتذة الذين يدرّسونها غير أكفاء أحيانًا، ومنعدمي التكوين فيها أحيانًا أخرى، ما يكرّس تعثّرات جمّة في نقلها إلى المتعلّمين، أو بسبب عدم ملائمة المحتوى مع السياق الثقافيّ للطفل المغربيّ أو المصريّ أو السوريّ. فلا يعقل تدريس بوشعيب أو ممدوح، ما يدرسه جاك وميشال من وضعيّات تدور في باريس أو لندن، وفي "السوبر ماركت"، وعن "الكريسماس" وهو لم يتجاوز قريته أبدًا، بل ولا يملك تلفازًا حتّى... مع ما ينطوي عليه ذلك من أهداف ثقافيّة مقصودة. لكن، تمّ الالتفات إلى هذا الأمر، وبدأنا نرى نصوصًا ودروسًا تتناول تقاليدنا ومحيطنا، وتتشبّع بخصوصيّاتنا وقيمنا، وذلك بلغات أجنبيّة.
كما يمكن لفت الانتباه إلى عقبة أخرى تعترض اضطلاع هذه اللغات بأدوارها الحيويّة في أنظمتنا التعليميّة. وتتجلّى في غياب ما يسمّى بالإغماس اللغويّ؛ أي ممارسة اللغة المتعلّمة في ميادين الحياة المختلفة، من جدّ وهزل، قصد تطويعها واعتيادها. فاكتفاء الأطفال بسويعات مدرسيّة من اللغة الأجنبيّة، وانهماكهم طيلة الوقت في اللغة الأم فقط، يجعلهم "ينزحون" في كلّ مرّة يودّون التعبير بالأجنبيّة. وخير برهان على نجاعة الممارسة اليوميّة، تحدّث النساء الأمّيّات اللاتي هاجرن إلى بلدان أخرى بلسان تلك البلدان، وإن كنّ لم يقتحمن مدرسة، ولا رأين أستاذًا أبدًا، وذلك نتيجة الضرورة اليوميّة وإلحاح السياق الاجتماعيّ. وكذا تعلّم الأجانب الذين قضوا سنين لدينا، للغاتنا الأمّ من أمازيغيّة وعربيّة وإبداعهم بها.
لا يمكننا بحال التخلّي نهائيًّا عن اللغات الأجنبيّة، وغلق هذه النافذة التي نرى منها العالم ويرانا من خلالها؛ فهي قناة تأتينا بروائع العلوم والآداب العالميّة ونفائس الفكر والفلسفات الكونيّة. لكن، ينبغي أن نراعي ظروفًا معقولة وكفاءة مشهودة في تلقينها، لا أن ندرجها فقط من أجل الإدراج وكفى. وكذا ينبغي الحرص على تنويع انفتاحنا على هذه اللغات إلى اللغة الألمانيّة واللغة الروسيّة، واللتين تزخران ببدائع الفلسفة والفكر والأدب، وكذا اللغات الشرقيّة القديمة، كالصينيّة والهنديّة اللتين تعتبران لغتين حافلتين تاريخيًّا، وواعدتين من أجل المستقبل ثقافيًّا واقتصاديًّا.