درس تركيا الذي لم نستوعبه

فهمي هويدي
من مفارقات هذا الزمان وغرائبه أنه في حين تتقدم تركيا بخطى حثيثة وحاسمة باتجاه إخراج العسكر من السياسة، فإن بعض المثقفين المصريين يتحمسون لإدخالهم فيها.
أحدث خطى الحسم في تركيا وقعت حين أعلن فجأة أن قادة الجيش قدموا استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من جانب الحكومة في شؤون القوات المسلحة، الأمر الذي أحدث دويا تردد صداه في العديد من عواصم الدنيا.
أحد أسباب الدوي أن قادة الجيش التركي كانت لهم لغة أخرى في مخاطبة حكومة أنقرة، فقد كانوا يقيلون ولا يستقيلون، ويوجهون الإنذارات ويطلقون المدرعات في الشوارع ولا يتخلون عن مناصبهم وينسحبون إلى بيوتهم.
هذا المعنى عبر عنه المعلق التركي المعروف جنكيز شاندار بقوله إن الأيام التي كان الجيش يصدر فيها الأوامر ولت، وإن كل من راهن على أن الجيش يمكن أن يسجل نقطة في الشأن السياسي عليه أن ينسى ذلك، لأن المعادلة اختلفت عما قبل.
لأن المفاجأة كانت كبيرة، فقد راقب الجميع تداعياتها، وقرأتها الأطراف المعنية كل من زاوية حساباته ومصالحه.
ورغم أن الحدث يظل شأنا داخليا من وجهة النظر المصرية، فإنني وجدت أنه ينبغي أن يقرأ في القاهرة بعناية شديدة من جانب المعنيين بوضع النظام الجديد للبلاد، لسبب مختلف تماما.
ذلك أن ثمة أصواتا ارتفعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة داعية إلى عسكرة ذلك النظام. وطالبت بالنص في الدستور على توسيع اختصاصات القوات المسلحة، بحيث تقوم بدور في حراسة النظام الديمقراطي والدولة المدنية. ومن ثم تحويلها من درع الوطن إلى وصي غير مباشر عليه. ومن حارس لأمنه وحدوده إلى حكم في السياسة وصانع لها.
“زلزال أربع نجوم”، كان ذلك عنوانا رئيسيا لصحيفة “الصباح” الموالية للحكومة الصادرة يوم السبت 30/7 التي وصفت به الحدث الاستثنائي وغير المسبوق في التاريخ التركي المعاصر. وبمقتضاه تمت استقالة رئيس الأركان الجنرال آسيك كوشانير، وقادة الأسلحة الأخرى البرية والجوية والبحرية إضافة إلى رئيس الأكاديمية العسكرية من مناصبهم.
ولأن رائحة الخلافات بين الحكومة والجيش قد تسربت منذ أكثر من عام بسبب اتهام بعض كبار الضباط في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، فقد سارع المحللون إلى القول بأن تطورات ملف أولئك الضباط هو الذي فجر الأزمة وأوصلها إلى تلك النهاية.
ذكرت التقارير الصحفية أن ثمة 43 جنرالا محبوسين على ذمة قضية المؤامرة، إضافة إلى 165 ضابطا وجنديا.
و حبس الجنرالات وتحقيق النيابة العمومية معهم أمر ليس مألوفا في تركيا، لأن خصوصية وضعهم والهالة التي أحاطت بهم جعلت من الإقدام على خطوة من ذلك القبيل مغامرة تحرص أي حكومة على تجنب الدخول فيها.
لذلك فالاتفاق منعقد على أن التوتر في علاقة الجيش بالحكومة ازداد خلال السنوات الأخيرة، وإن كان له وجود منذ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002.
فقد بدأ في تقليص نفوذ العسكر الذين كانوا يباشرون وصايتهم على الحكومة من خلال مجلس الأمن القومي بأغلبية العسكريين من أعضائه. ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان استصدر قرارا جعل الأغلبية فيه للمدنيين.
الشاهد أن غضب العسكر ظل كامنا وحذرا، حتى بعد احتجاز الجنرالات وتولى السلطات المدنية استجوابهم، ولكن العلاقة انفجرت مؤخرا حين حل موعد ترقيات ضباط الجيش، وطلبت رئاسة الأركان ترقية بعض الجنرالات المحتجزين بحجة أنه لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الذي وجد أن ترقية ضباط متهمين بتدبير انقلاب والإطاحة بالسلطة أمر غير مستساغ خصوصا أن التهمة جسيمة.
ومنظمة “أرغنكون” التي اتهم الجنرالات بالتواطؤ معها أو الضلوع فيها تمثل أخطبوطا خطرا ظل يعبث بالساحة السياسية التركية طوال العقود التي خلت، دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من وقف أنشطتها أو إجهاض عملياتها.
بعد يومين من إعلان الاستقالة الجماعية في 31/7 نشرت صحيفة “حريت” التركية القصة العجيبة التالية، في عام 2000 اشترت رئاسة الأركان عددا من المواقع الإخبارية الإلكترونية التي استخدمتها في وقت لاحق في نشر الأخبار الكاذبة وشن حملات التضليل التي استهدفت الإساءة إلى سمعة حكومة العدالة والتنمية التي تشكلت سنة 2002.
واستنادا إلى تلك الأخبار بادر المدعي العام في المحكمة الدستورية عام 2007 إلى رفع دعوى لحظر الحزب الحاكم بحجة عدائه للعلمانية. واعتبرت المحكمة أن ما بثته المواقع أدلة لا يرقى إليها الشك. فأدانت حزب العدالة في تهمة معاداة العلمانية، لكنها لم تحظر الحزب.
وبعد عامين أميط اللثام عن الفضيحة وانكشف أمر تلك المواقع وعلاقتها بقيادة الأركان، لكن العسكر سارعوا إلى احتواء الموضوع والتستر عليه.
محاولة الانقلاب التي حملت اسم “المطرقة” كان مقدرا لها أن تتم عام 2003، أي بعد عام واحد من تولى العدالة والتنمية، كانت الأسوأ والأخطر. إذ أثبتت التحقيقات أنها كانت تستهدف إشاعة الفوضى على نحو مفاجئ، بما يؤدى إلى استدعاء الجيش للتدخل بسرعة ومن بين ما كان مدبرا في هذا الصدد، تفجير بعض المساجد التاريخية في إسطنبول وإشعال حرب مع اليونان، واستنفار قوى التطرف العلماني للخروج في مظاهرات تدعو إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.
وهذه المخططات لم ينكرها الضباط المحتجزون، وإن كانوا قد برروها باعتبارها مجرد ترتيبات ومناورة عسكرية لمواجهة الطوارئ، ولم تكن تستهدف القيام بانقلاب في البلاد.
من المقولات الشائعة في أوساط الطبقة السياسية أنه إذا كانت القاعدة أن لكل بلد جيشا فثمة استثناء في منطقة الشرق الأوسط، ففي تركيا والجزائر هناك جيشان لكل منهما دولة.
فالجيش التركي أنقذ البلد من الانهيار حين أعلن السلطان وحيد الدين الاستسلام للدول الحليفة في نهاية الحرب العالمية الأولى، وأصبحت البلاد مستباحة للفرنسيين والإنجليز والإيطاليين واليونانيين، ولكن الجنرال مصطفى علي رضا قاد حركة للمقاومة السرية نجحت في التصدي للقوات الأجنبية، حتى أجبرتها على التراجع، مما أدى إلى انسحابها عام 1923، فعلا نجم الرجل وتولى رئاسة البلاد منذ ذلك الحين. وحتى وفاته في سنة 1938.
وخلال تلك الفترة ألغى الخلافة العثمانية وحول قبلة البلد من الشرق إلى الغرب مستلهما في ذلك مختلف قيم المنظومة الغربية وعلى رأسها العلمانية.
كما أنه وجه عناية خاصة للجيش الذي دافع عن شرف وكرامة الأمة التركية. ومنذ ذلك الحين تحولت العلمانية إلى عقيدة أقرب إلى الدين، وأصبح الجيش هو القابض على زمام الدنيا.
لأن الدولة العثمانية عرفت نظام “الملل” الذي سمح بتقنين التعددية الدينية واستفادت منه التجربة الغربية في إفساح المجال للتعددية السياسية، فإن المجتمع التركي لم يستسلم لهيمنة العسكر رغم هالة القداسة التي أحاطت بهم طوال الوقت، وظل يقاوم تلك الهيمنة منذ أجريت أول انتخابات نيابية سنة 1950 وخسر فيها حزب الشعب الذي أسسه الجنرال مصطفى بعدما أصبح أتاتورك (أبو الأتراك) وكان الفوز من نصيب الحزب الديمقراطي.
هذا التطور لم تعرفه الجزائر لأسباب يطول شرحها، حيث لا يزال الجيش مختطفا السياسة وقابضا على زمام البلد، متكئا في ذلك على شرعية وإنجاز جبهة التحرير، منذ أن حصلت الجزائر على الاستقلال سنة 1962 وحتى هذه اللحظة.
ما يهمنا في تتبع مسار التجربة التركية أن النص في الدستور على أن الجيش هو المؤتمن على سلامة البلاد في الخارج والداخل، حوله إلى سلطة أعلى من الحكومة تمارس الوصاية على المجتمع، وصاية مورست باسم حراسة العلمانية والذود عن حياضها.
وبهذه الذريعة قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية في السنوات 60 و70 و80، كما قام بانقلاب سلمي عام 1997، أجبر فيه حكومة نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي على الاستقالة.
حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في سنة 2002، وفتح ملف منظمة أرغنكون التي كانت بمثابة الحكومة السرية التي تدير البلاد بالتواطؤ مع غلاة العلمانيين، وفى المقدمة منهم بعض القيادات العسكرية، انكشف أمر محاولة الانقلاب التي كان مقررا لها أن تتم في سنة 2003.
إزاء تعدد الانقلابات، وحين تكشف دور بعض القادة العسكريين في عملية “المطرقة” فإن ذلك أدى إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، التي أصبح الدور السياسي الذي تمارسه عقبة في طريق مسيرة الديمقراطية. إذ حين صوتت الأغلبية لصالح حزب العدالة والتنمية تبين أن بعض العسكر خططوا للانقلاب على الحكومة المنتخبة وحل الحزب الفائز.
فمعنى ذلك أن القوات المسلحة لم تصبح طرفا في الصراع السياسي الداخلي فحسب، وإنما صارت تتحدى الاختيار الشعبي وتسعى إلى مصادرته.
أكثر من ذلك فإن انخراط العسكر في اللعبة السياسية واستغراقهم في معارك الداخل، جعلهم يقصرون في بذل الجهد الواجب للتصدي لهجمات المتمردين الأكراد، الذين كثفوا هجومهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما ذكره تقرير خدمة “نيويورك تايمز” الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” في 1/8 منسوبا إلى أحد المسؤولين الأتراك.
هذه الخلفية عززت من مركز رئيس الوزراء أردوغان في سعيه لاستصدار دستور جديد يعيد هيكلة الجيش ويخضعه للسلطة المدنية، بحيث يتحول إلى قوة من المحترفين المعنيين بالشأن العسكري والبعيدين عن القيام بأي دور سياسي، حتى إن الحكومة تعد الآن تشريعا جديدا يمنع القوات المسلحة من إصدار أية بيانات سياسية.
ما يثير الانتباه في هذا السياق أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت في 31/8 أن المسؤولين الإسرائيليين تابعوا بقلق مسألة استقالة قادة الجيش التركي. ونقلت عن أحد المسؤولين قوله إن تلك الخطوة تعنى “سقوط آخر حصن ضد الإسلام في تركيا”.
خبرة التجربة التركية ينبغي استيعابها من أكثر من وجه. فإقحام الجيش في السياسة الداخلية الذي دعت أصوات بعض مثقفينا في مصر إلى تضمينه في الدستور ورطة احتاجت تركيا إلى أربعين سنة للخروج منها.
والعلمانية التي فرضها أتاتورك ويظن أولئك البعض أنها طوق النجاة وسبيل إلى إقامة المجتمع المدني المنشود لم تجلب معها الديمقراطية ولم تنقذ المجتمع من هيمنة العسكر، وإنما تحققت آمال الشعب في ذلك من خلال النضال الديمقراطي بعد مضى نحو ثمانين عاما من فرض العلمانية على تركيا (أتاتورك مات سنة 1938).
وبعد استقالة قادة الجيش وتقليم أظفاره قرأنا مقالا في “الشروق” لزميلنا الأستاذ جميل مطر كان عنوانه “تحقق الحلم وأصبحت تركيا دولة مدنية”، في إشارة إلى أن الديمقراطية نجحت فيما فشلت فيه العلمانية.
ويسمح لي سياق الاستفادة من التجربة التركية أن أكرر معنى سبقت الإشارة إليه، يهم الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، خلاصته أن النجاحات التي حققها العدالة والتنمية في تركيا لم تتوفر له لأنه كان يعظ الناس، وإنما لأنه كان يخدمهم وأنه لم يتوقف عند العناية بعمارة الآخرة، ولكنه اعتبر عمارة الدنيا سبيلا إلى عمارة الآخرة.
إن العبر كثيرة، لكن قليلين هم الذين يستوعبون الدروس ويعتبرون.
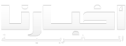






_1735248802.webp)







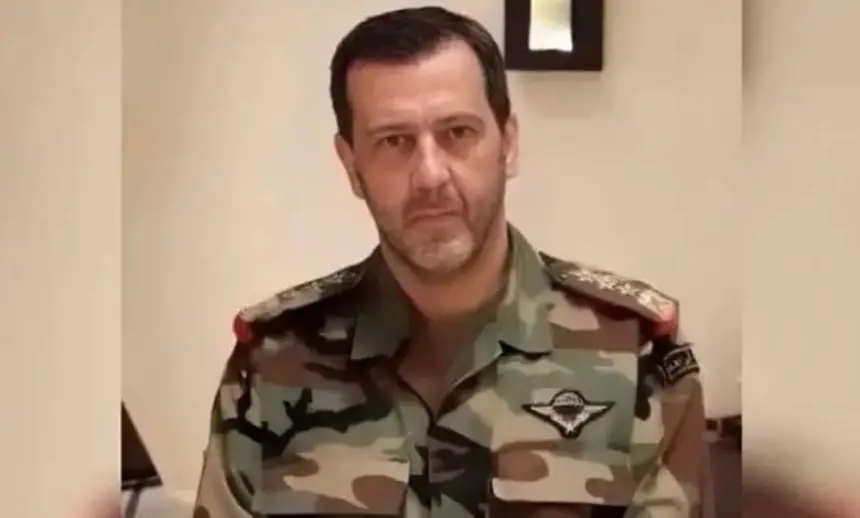
adil
شكرا جزيلا على هذا المقال الرائع !